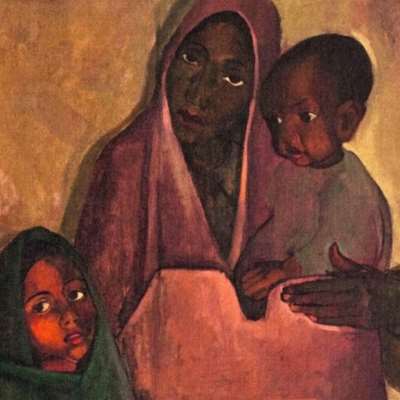كان من دواعي فخر إريك هازان دوماً أنَّه منذ أيَّام دراسته الثانويَة، عاشرَ أصدقاء من الشباب والكهول تشبَّع معهم بالفكر الشيوعي. سينضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، ثم سيعيدُ بطاقةَ انتسابهِ إلى قيادتِه، محبَطاً من التحريفية الستالينية؛ لكن كلمة «شيوعيَّة» ستظل «مثالية، ناصعةً» على حد تعبيره؛ فقد صرَّح في عام 2021: «إن الرأسمالية في حالة سيئة، وتكاد تكون في حالة احتضار. إنها السبب الأساسي في ظاهرة الاحتباس الحراري والوباء، وسوفَ يقضيانِ عليها».
مهنيّاً، بدأ هازان في 1973، حياتَه طبيباً جراحاً ملتزماً بقضايا الدفاعِ عن الحقِّ في الإجهاض عندما كان ممنوعاً في فرنسا وجلّ أوروبا بترسانة من القوانين التي تصل إلى تجريمِ الأطباء الممارسين له حدّ السَّجن. كما كان ضمنَ ما اصطلح عليه بـ «حَمَلَةِ حقائب جبهة التحرير الوطني»، أي ضمن المكلَّفين بنقل الأموال والسلاح لخلايا الجناح المسلَّح للثورة الجزائريَّة الناشط بين الضفتين، بين فرنسا والجزائر. مثلما كان دوماً نصيراً للقضية الفلسطينية، وداعماً لها فكرياً وجهداً مهنيّاً، حتى الساعة الأخيرة؛ ففي عام 1975، بصفته عضواً مؤسساً في الجمعية الطبية الفرنسية - الفلسطينية، ذهب إلى لبنان، في خضم الحرب، ليكون طبيباً «لهذا الجيش الذي كان يُطلق عليه في ذلك الوقت تحالُف الحركة التقدمية اللبنانية والكفاح الفلسطيني المسلَّح». كما كان عضواً مؤسِّساً للّجنة الراعية لمحكمة راسل الخاصة بفلسطين، التي بدأت عملها في 4 آذار (مارس) 2009.
في خضم كل هذا الغليان السياسي-الاجتماعي، وجد هازان نفسَه مؤرخاً عصاميّاً متحمّساً للنبش في ماضي الثورة الفرنسية وظِلالها، عاشقاً للتسكّع في باريس، وكاتباً محترِفاً مغرماً بالأدب، ثمَّ شخصيةً رائدة في النشر المستقلّ عن المؤسسات الرأسماليَّة، فاعلةً في الفكر اليساري الراديكالي.
في عام 1983، ترك مهنة الجراحة، ليتولى إدارة منشورات هازان الفنية، التي أسسها والده، وأعطاها الابن دفعةً ثانية عبر إصدار كتب فنيَّة تؤرِّخ لباريس الثورية في القرن التاسع عشر، وللحركات الفنيَّة والأدبيَّة الطليعيَّة في القرن الـعشرين. سرعان ما ستمرّ هذه الدار بضائقة ماليَّة، لتبتلعَها مجموعة «هاشيتْ»، ما اضطرَّ هازان إلى مغادرة إدارتِها، موثِراً الحفاظ على استقلاله الفكري والمهني.
في عام 1998، أسَّس دار La fabrique (الورشة)، المختصَّة في الكتب التأريخية و الفلسفية، التي تهدف إلى «الارتكاز سياسياً إلى يسار اليسار، لكن من دون الاستسلام لأي روح حزبية، ولا الخضوع لأي جماعة أو حزب». للإشارة، فاصطلاح «يسار اليسار» من إبداع عالم الاجتماع بيار بورديو، من أجل تمييزه عن فكرة اليسار الديمقراطي-الاجتماعي التي شوَّهها الحزب الاشتراكي الفرنسي بسياسته اليمينية (والصهيونية، المتورِّطة مع الولايات المتحدة الأميركية في حصار العراق والحرب عليه).
بوفاته في 6 حزيران (يونيو) 2024 في باريس، نعتهُ الدَّارُ في بيان رسمي نقتطف منه هذه الفقرة الشديدة التركيز والموجِزة لمشروعه في شموليَّتِه: «كانت الورشةُ المغامرةَ الأخيرة في حياته المهنية، ومنزلَه حيث رحّب بعدد من الأصدقاء وأرسى الدعامات لتحمّل العواصف. منزل تمكّن على مرّ السنين من فرضه على المشهد الثقافي، من دون التخلي عن استقلاليته أو جرأته، قبل أن يتركه بهدوء. «إسرائيل-فلسطين، المساواة أو لا شيء» (إدوارد سعيد)، و«النشر من دون ناشرين» (أندري شيفرين)، و«على حَوافِّ السياسة» (جاك رانسيير)، و«وضع حد للسجن» (آلان بروسّا)، و«من أجل السعادة والحرية» (روبسبيير)... هذه العناوين التي كانت من أولى العناوين التي نشرها، يجب أن تُقرأ بعناية لأنها تقول في الأساس جوهر التزاماته وأسلوبه وتفاؤله الذي جعلهُ لا يُوْلِي أهمية كبيرة لعدوِّه. أراد أن ينشر كتباً تكون بمنزلة أسلحة، تزحزح الخطوط، وكان دائماً إلى جانب النضالات: نضالات المحجّبات، ونضالات الشعب الفلسطيني، ونضالات الرفاق الذين تطاردهم أجهزة مكافحة الإرهاب أو تضربهم الشرطة، ونضال مؤلِّفي الدار في مواجهة افتراءات تنطلق من الرجعية. إذا كان نادراً ما يسهب في الحديث عن أنشطته النضالية التي أخذته في شبابه إلى الجزائر ثم إلى لبنان مع جبهة التحرير الوطني والنضالات ضد الاستعمار، وإذا كان قد هالَه ما رأى من مآسٍ، فإنّ معسكره كان معسكر الشيوعية المتفرِّدة، بلا زعيم أو حزب. شيوعية الصداقة، والنُّبل المبدئي والسخاء؛ التي جمعت تحت رايتها آلاف الرفاق، من فالتر بنيامين إلى روبسبير والمتمرِّدين المجهولين في ثورة حزيران (يونيو) 1848. سواء في كتاباته، حيث شارك، عند منعطف كل شارع باريسي، في التأريخ لذكرى معارك الثورة الفرنسية أو كومونة عام 1871، والتأريخ لذكرى الاحتجاج اليهودي الثوري الذي لا يمكن لدولة إبادة جماعية استرجاعه إلى الأبد؛ كان لهذه الدار الصغيرة دور كبيرٌ، بالعمل على تفكيك الأكاذيب. جميع كتبنا، سواء أكانت تتناول الديمقراطية أم الهجرة أم فلسطين أم الانتفاضة المقبِلة، لها الهدف نفسه: إظهار المكان حيثُ يقع خطُّ المواجهة الحقيقي».
كان ضمن المكلَّفين بنقل الأموال والسلاح لخلايا الجناح المسلَّح للثورة الجزائرية
لننظر الآن بتفصيل إلى الكتب التي ألفها هازان، فعناوينها وحدها كافية وموحية بأفكار الرجل والقضايا التي تبنَّاها: «اختراع باريس، لا توجد خطوات ضائعة» (2002)؛ و«وقائع الحرب الأهلية» (2004)؛ و«تنشيطُ حِراك، مجموعة مقابلات» (2005)؛ و«الدعاية اليومية» (2006)؛ و«ملاحظات عن الاحتلال: نابلس، قلقيلية، الخليل» (2006)؛ و«تغييرُ المِلكية: استمرار الحرب الأهلية» (2007)؛ و«معاداة السامية في كل مكان. اليوم في فرنسا» (بالاشتراك مع آلان باديو، 2011)؛ و«دولة واحدة: من النهر إلى البحر» (بالاشتراك مع إيال سيفان، 2012)؛ و«المِتراس: قصة شأن ثوري» (2013) وغيرها. كما نقل ترجم عن الإنكليزيَّة أعمالاً لمصطفى البرغوثي (البقاء على الجبل ــ 2005) وطارق علي (بوش في بابل: إعادة استعمار العراق ـ 2004) وأندري شيفرين (السيطرة على الكلام: النشر من دون ناشر ـ 2005)؛ وتانيا راينهارت (إرث شارون: تدمير فلسطين ــ 2006)....
هذه كلُّها علامات شجاعة ونزاهة فكريَّين، لم يقتصر سِجِلُّهما على التأليف والترجمة، بل انسحب أيضاً على النشر لأسماء يعاديها الرأسمال المتوحش لدور النشر الكبيرة التي تجد جذورَها في الأوساط النيوليبراليَّة والصهيونية، لم (ولن) يكن آخرُها المؤرخ إيلان بابيه، الذي أعادَ هازان أخيراً نشر كتابه «التطهير العرقي في فلسطين»، بعدما سُحب من رفوف المكتبات من قبل «دار فايار» المملوكة للملياردير فنسان بولّوري المحسوب على بين دهاقنة اليمين المتطرف المتنامي في فرنسا الأنوار (الأخبار 15/12/2023)...
في عام 1975، ذهب إلى لبنان، في خضم الحرب، ليكون طبيباً «لهذا الجيش الذي كان يُطلق عليه في ذلك الوقت تحالُف الحركة التقدمية اللبنانية والكفاح الفلسطيني المسلَّح»
كأنَّ إريك هازان اتَّخذ من مقولة رينيه شار «ما يأتي إلى العالم لكي لا يزعج شيئاً، لا يستحق اعتباراً ولا صبراً» شعاراً للدار؛ فكلَّما صدرَ عنها كتابٌ، أثارَ سخطَ اليمين الفرنسي وغضبَه، من جناحه التقليدي المتصهين حتى جناحه المتطرِّف المتلبرل والفاشي. لقد جاء هازان بمشروعه الثقافي بِنِيَّة واضحة تتمثل في إثارة المشكلات في أوساط الرجعيَّة. وإذا كانت للدار ورشة دائمة، فهي ورشة إثارة المشكلات لائتلافِ اليمين بجميع تلاوينه. وهكذا تلقَّى هذا التحالف الرجعي الضربات تلو الضربات مع صدور عناوين ذات حمولة سجاليَّة كبيرة لم تستطع الماكينة الإعلامية الجهنمية للرأسمال إسكاتها ولا حتى مُسَاجَلَتَها بنِدِّيَّة؛ من بينها تمثيلاً لا حصراً: «صناعة المحرقة» لنورمان فينكلستين؛ و«التمرد القادم» الذي نُشر عام 2007 واعتبرته وزيرة الداخلية آنذاك ميشيل أليو ماري «دليلاً إلى التمرد اليساري المتطرف»، ما تسبب للناشر في الاستماع إليه كشاهد من قبل شرطة مناهضة الإرهاب، ليخرج من إغلاق قاضي التحقيق للملف منتصراً هو وكُتَّابُ المؤلَّف على اليمينية الزاحفة على المجتمع الفرنسي في عهد ساركوزي. كما أصدرت الدار كتابي المراسلة الصحافية أميرة هاس «شُرْبُ البحر في غزة، وقائع 1993-1996» و«مراسلات في رام الله، 1997-2003»؛ إلى جانب «مقاطعة، عقوبات، سحب استثمارات: حركة المقاطعة ضد الفصل العنصري واحتلال فلسطين» لعمر البرغوثي؛ وأحدثُها لغادة الكرمي «إسرائيل-فلسطين، الحل دولة واحدة».
وإن شئنا تلخيص كلِّ هذه العناوين في عبارتين متكاملتين كثيراً ما ردَّدهما إريك هازان، فهما: «نحنُ في حرب أهليَّة دائمة» و«معاداةُ السامية صنيعةٌ أوروبية».
ختاماً، أسوةً بالكاتب والناشر فرُنسوا ماسبيرو الذي يتقاسم معه كثيراً من الأواصر، كان إريك هازان ملتزماً بخدمة فكرٍ يسبح ضد التيار السائد، بروح تصفية آثار الاستعمار خلالَ حرب الجزائر وأحداث أيار (مايو) 1968 وبعدها. وكان موقفه من فلسطين يتطابق مع مواقف اليسار الحقيقي المناهض للكولونيالية: معاداة الصهيونية وعواقبها الكارثية على الشعب الفلسطيني الذي دعم كفاحه من البداية. كان مندِّداً بعنف الشرطة، واستهداف الإسلاموفوبيا للنساء المحجبات، وظل يعمل مؤرِّخاً للذاكرة الجماعية الضرورية لتغيير العالم. وعلى هذا النحو، يمكننا اعتباره أحد أفضل مؤرخي الثورة الفرنسية، كما كان محِبّاً لأصحاب الفكر الرؤيويِّ مثل بلزاك وفالتر بنيامين، وجعلته ثقافته الموسوعية رجلاً نادراً، كما أن بساطته ونباهَته جعلا منه دائماً منصِتاً نبيلاً لقضايا العصر.
جاك رانسيير: تغيير العالم وظيفته اليومية *
هناك طريقة مختصرة لإحياء ذكرى إريك هازان عبر تحيته ببساطة باعتباره الناشر الشجاع والمدافع عن أقصى اليسار، والمؤيد الذي لا يتزعزع للحقوق الفلسطينية، والرجل الذي آمن بالثورة ضد التيار السائد في عصره، إذ خصَّص كتاباً للتدابير الأولى التي يجب اتخاذها بعد نجاحِها.
لقد كان بكل تأكيد كل ذلك، ولكن علينا أولاً أن نتذكر ما هو أساسي: في الوقت الذي تستحضر فيه كلمة «ناشر» إمبراطوريات رجال الأعمال الذين يكسبون المال من كل شيء، بما في ذلك الأفكار الأكثر إثارة للاشمئزاز، كان في البداية ناشراً عظيماً. هذه ليست مسألة كفاءة فحسبُ. إنها مسألة شخصية أكثر.
كان إريك شخصية استثنائية: عقل مترعٌ بالفضولِ تجاهَ كل شيء، وقادمٌ من ميدان العلوم وجرَّاح أعصاب سابق، ولكنه أيضاً متذوق كبير للفنون وشغوف بالأدب؛ سكان المدن حساسون تجاهَ حقيقة أنّ كل حجر في منعطفِ شارع يحمل تاريخاً حياً؛ رجل منفتح ومرحب بابتسامة مشرقة ومصافحة حارَّة، حريص على إيصال عواطفه وكذلك الإعلان عما اكتشفه وإقناع الآخرين به، بعيداً عن أي وعظ، في ما اعتبَره من أسسِ العدالة الخالصة ومتطلباتها.
لقد علمت أنه لم يكن ناشراً عادياً من اتصالاتي الأولى معه في الوقت نفسه الذي بدأت فيه La Fabrique. لقد حضر بضع حصص من ندوتي عن الجمالية وأراد أن يفهم بشكل أفضل ما كنت أفعله وإلى أين يقودني. ثم ناولتُه مقابلة قصيرة أجريتها مع مجلة ذات طبعة محدودة ينشرها الأصدقاء. وبعد أيام، أخبرني أن هذا صُلْبُ كتاب وأنه سينشره. وهو ما فعله بكفاءة كافية لهذا العمل الصغير، الذي بالكاد يمكن رؤيته على طاولة مكتبة، وقد صار يَجول العالم. ثم تعلمت هذا الشيء المدهش: الناشر العظيم هو الشخص القادر على إخبارك أنك كتبت كتاباً عندما تكون بنفسك جاهلاً لذلك.
وهكذا بدأ بالنسبة إليّ تعاون طويل جداً تخللته عناوين ستثبت قائمتها وحدها بأنّ إريك هازان لم يكن ناشرَ بيانات ثورية فحسب. ما الذي كان عليه أن يفعله، في هذه الحالة، مع الكتب التي استكشفت مناطق تبدو بعيدة كل البعد عن أي فعالية سياسية فورية مثل الجدل حول المناظر الطبيعية في إنكلترا في القرن الثامن عشر، وتفكيك الخيوط التقليدية للسرد الرومانسي عند فلوبير وكونراد؟ أو فيرجينيا وولف، أو تشابك الأزمنة في أفلام دزيغا فيرتوف، أو جون فورد أو بيدرو كوستا، أو مفهوم المُشاهد الذي يتضمنه هذا التجهيز الفني أو ذاك من الفن المعاصر؟ ما هي الحاجة إلى نشر طبعة كاملة من أكثر من ألف صفحة لـ«بودلير» فالتر بنيامين؟ وما جدوى انغماسه في باريسِ بلزاكَ؟ لم يقتصر الأمر على أنه كان مهتماً بكل شيء، وأن ثقافته الإنسانية كانت أوسع وأعمق بكثير من ثقافة عدد من رجال الدين الذين يبتسمون لالتزاماتهِ شبه العسكرية بِمُثُلِ ثقافته. ذلك لأنّ العالم الذي ناضل من أجله كان عالم التجربة الأوسع والأغنى، ولم يفصل العمل المعرفي وعواطف الفن عن الشغف بالعدالة(...) لم يكن تغيير العالم بالنسبة إليه برنامجاً للمستقبل، بل عملاً يومياً يتَّجه نحو الأفق المنظور للعثور على الكلمات المناسبة. وكان يعلم أن الثورة هي بحدّ ذاتها طريقة للمعرفة. في المؤلفات الأكثر تطرفاً التي نشر نصوصها، سواء عن النسوية أو تصفية الاستعمار أو تخريب خطوط الأنابيب، لم يرَ فقط صرخة غضب ضد حكم الظلم، بل رأى أيضاً عملاً بحثياً، وتجربة فريدة من نوعها في العالم الذي نعيش فيه، وفكرة جديدة. طريقة إلقاء الضوء عليه. ولهذا أيضاً، كان حريصاً على ضمان ظهور العناوين الأكثر استفزازاً في منافذ بيع الكتب باللون المناسب لجعلها أشياء ثمينة.
هل هذا سبب اختياره أن يطلق على داره اسم La Fabrique؟ يُذكِّر هذا الاسم خبراءَ التاريخ العُمَّالِيّ بِـ «صدى الورشة» التي كانت، بعد عام 1830، صحيفة الثورة في ليون. ولا شك في أنّه كان من المهم بالنسبة إليه إطالة ذكرى أيام الثورة العظيمة عام 1848 والكومونة. لكن كلمة «ورشة» ارتبطت بهذا التقليد الكفاحي لمفهومٍ كاملٍ عن عمل الناشر: خروج جذري عن منطق الربح، مرتبط بصرامة الإدارة التي لا تشوبها شائبة؛ الحب الحِرَفِي للعمل المنجز بدقة، الذي لا يهمل أي جانب من جوانب إنتاج الكتاب؛ ولكن أيضاً فكرة ورشة عمل أخوية حيث يمكن للجميع جلبُ منتَج عملٍ، سيتحول عبر التشابك إلى شيء آخر: ثروة مشترَكة من الخبرات والمعرفة ووجهات النظر، والشعور بـ «القدرة المشترَكة على بناء مجتمعِ عالَم مختلف عن ذلك الذي يقدمه لنا أسيادنا وأتباعهم من المفكرين باعتباره الحقيقة الوحيدة التي لا مفر منها».
إن تقديم خرائط أخرى لما هو مرئي، وما يحدث ويهمّ في عالمنا، هو الاهتمام الذي جمع عدداً من المؤلفين الذين تقاسموا مثل هذه الاهتمامات والأفكار والحساسيات المختلفة التي احترمَها جميعاً على قدم المساواة من دون أن يسعى إلى توحيدها في خط مشترك، لأن هذا الناشر العظيم كان قبل أي شيء رجلاً حراً لا يمكنه التنفس إلا في جو الحرية.
أهي خلخلة هذا الجو هو ما أَظْلَمَ أيامه الأخيرة، إلى جانب المرض؟ لم يسبق قطّ أن تعرضت القضايا التي ناضل من أجلها لهذا القدر من الاستهزاء من الناحية النظرية، أو الدوس عليها من دون اكتراث في الممارسة، كما هو الحال في حاضرنا. ولمدة طويلة، رأى في خزي القوى التي تحكمنا سبباً للأمل في ثورة قريبة. كان يعتقد أن هذا العالم متهالك لدرجة أن أدنى ضربة يتلقاها، هنا أو هناك، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى انهياره. هذا هو منطق الحرفيين الجيدين وأبناء التنوير، قصيري النَّفَسِ. وهم يعتقدون أن التعفن يؤدي إلى انهيار المباني. ولسوء الحظ، إن هذا هو الغِرَاءُ الذي يجمع العالم ببعضِه. وهو عمل تنظيف طويل جداً وصبور يفرضه هذا الغراء على أولئك الذين يحتاجون أولاً إلى خلق هواء أكثر قابلية للتنفس وأكثر ملاءمة للاستعداد لغد آخر. إنها، على أي حال، مهمة ستكون مقاومتها الصارمة لكل أنواع الدناءة بمنزلة مثال يُحْتَذَى لمدة طويلة.
(*) نصّ مترجم للفيلسوف الفرنسي نُشر في تأبين إريك هازان في صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في الثامن من حزيران (يونيو) 2024