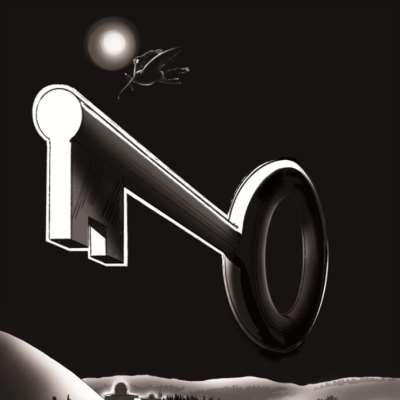أمامنا أمثلةٌ كثيرة لعددٍ مِن الدول استطاعت أنْ تنشل بلدها مِن العوز والفاقة والاستجداء إلى مصافي دولٍ منتجة ومصدّرة لإنتاجها بسبب تطوير النظام التعليمي، ومنها اليابان حيث الراتب الأعلى يُعطى للأستاذ، وهو أعلى مِن راتب الوزير أو النائب. والسبب في ذلك أنّ اليابانيين يعتبرون، عن حقّ، أنّ دور المعلّم أهمّ لأنه هو الذي يقدّم المعرفة لِمَن سيتبوّأ السلطة لاحقاً، وبالتالي، إذا كان أداء المعلّم سيئاً فإنّ البلد كلّه سيعاني مِن هيئاتٍ تشريعية أو تنفيذية فاشلة. ويتكلّم مهاتير محمد عن تجربة أندونيسيا وكيف انتقلت مِن الفقر إلى الرخاء والإنتاج الصناعي عبْر تحديث وإلزامية النظام التعليمي المموّل مِن الدولة لأنّ مصير هذه الأخيرة يتوقّف على أداء هؤلاء الطلّاب والطالبات.
ولقد وعت الولايات المتحدة الأميركية، منذ البداية، دور وأهمّية المدرسة الحكومية الإلزامية في ترسيخ مفهوم الانتماء القومي/الوطني. فالمهَمّة الأولى للمدرسة الحكومية هي تنشئة جيلٍ وطني يحبّ بلاده ومستعدّ للدفاع عنها. لذلك تُمنع المدارس الخاصّة إلا لأبناء الجاليات الأجنبية والأثرياء الذين يستطيعون دفع الأقساط الباهظة الثمن، ذلك أنّ الولايات المتحدة تعرف تماماً أنّ المدرسة الخاصّة الأجنبية ستحرف الطالب/ة عن الولاء لوطنه. كما يحصل عندنا في لبنان؛ حيث تلعب المدارس الأجنبية الخاصّة دوراً هدّاماً لأنها تعلم تاريخ وجغرافيا الدولة التي تنتمي إليها هذه المدرسة في حال كانت فرنسية أو ألمانية أو إيطالية أو أميركية، وتبخّس مِن قيمة دول العالم الثالث حيث تعمل. وتنشئ جيلاً لا همّ له إلّا مغادرة بلاده لأنه يتحوّل إلى مغترب منذ أن تطأ قدماه المدرسة الأجنبية التي تواكبه حتى سنّ الثامنة عشرة، فيتعلّم أن يكره لغته الأمّ، وأن يكره ثقافة وطنه، ومناه أنْ يحصل على عملٍ في وطنه الثاني الذي تعلّم أن يجلّه ويحترمه عبر دراسته.
لم يشذّ فكرُ أنطون سعادة عن أهمّية المدرسة في بناء الشعور القومي/الوطني، فشعاره الذي كان يضعه على رأس رسائله كان: «المجتمع معرفة والمعرفة قوّة». وبناءً عليه، انبرى القوميون الاجتماعيون إلى بناء مدارس قومية في سوريا ولبنان، ومنها: مدرسة جورج مصروعة، ويوسف الأشقر في المتن، ومدرسة أنيس أبي رافع في عاليه. كما عمل عشرات القوميين في مدارس أُخرى منها مدرسة برمانا ذات المستوى العلمي العالي، والإنترناشيونال كوليدج (I.C) الملاصقة للجامعة الأميركية في بيروت، وتخرّج فيها العديد مِن الطلبة القوميين الوطنيين. ولسوء الحظ أغلقت هذه المدارس أبوابها بعد التنكيل بالقوميين إثر محاولة الانقلاب في نهاية عام 1961. فالمدارس تلعب دوراً جوهرياً في ترسيخ القيم الاجتماعية وتستطيع أن تحوّل مسار مجتمعاتٍ مِن وجهةٍ إلى وجهةٍ مناقضة، لذلك لا مجال لإقامة نهضةٍ في المشرق العربي مِن دون وجود مدارس وطنية تهدف إلى توحيد المجتمع وإزالة التشنّجات الطائفية والعرقية.
الوعي القومي
حين نتكّلم عن الدولة الحديثة، فهذا يعني الدولة-الأمّة، أو الدولة القومية/الوطنية التي لم تكن موجودةً قبْل القرن السادس عشر. فقبْل ذلك التاريخ انتظمت المجتمعات على شكل أنظمةٍ ملكيّة يتوارث فيها الأولاد آباءهم، أو على شكل إمبراطورياتٍ اتّخذت في القرون الوسطى طابعاً دينيّاً، فنجد إمبراطوريةً إسلامية في المشرق العربي، وأُخرى مسيحية في أوروبا، وضمن هذه الإمبراطوريات وُجدت تجمّعاتٌ توحّدت على أساسٍ عرقي. وفي الحالتين، العِرقية والدينية، تمثّل الاتّحاد بشكلٍ شخصي، أي إنّ العلاقة الأساسية هي إمّا بين أشخاصٍ مؤمنين، أو بين أشخاصٍ تربطهم علاقات دمٍ وقربى، وكل مَن هو خارج هاتين المنظومتين، الإيمانية أو العِرقية، يكون خارج الاتحاد.
الاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو المقاومة، لأنها تعمل على الدفاع عن الأرض، وعن الشعب الذي يسكن هذه الأرض بمعزل عن دينه أو عرقه
لكن، مع نهاية القرون الوسطى الأوروبية، بدأ شكلٌ جديد مِن التنظيم، يعيّن الوحدة على أساس الحيّز الجغرافي، أي الانتماء إلى الأرض. ولقد عمّ هذا النموذج العالم اليوم، والهوية التي نحصل عليها هي هويةٌ تحدّد البقعة الجغرافية التي ننتمي إليها، أي الهوية القومية/الوطنية، وبالتالي إذا خسرنا الأرض نخسر هويتنا الجمعية الوطنية لأننا نصبح بلا وطن، ويتمّ إلحاقنا بهويات وطنية أخرى. هذا يعني أنّ بقاء شعبٍ ما على أرضه هو الذي يحدّد وجوده، وفقدانه للأرض يعني خسارة هويته، وهذا لا يحصل في الاتّحاد الشخصي الديني أو العرقي، إذ إنّ هويته الشخصية غير مرتبطةٍ بالأرض، فهو يظلّ مسلماً مثلاً حتى لو ذهب إلى الغرب أو أقصى الشرق. والأمر نفسه ينطبق على هويته الإثنية، لكنه لا يستطيع أنْ يحتفظ بهويته السورية أو العراقية حين ينتقل نهائياً إلى بلدٍ آخر غير بلده الأمّ، وسيضطر إلى تبنّي هوية الدولة-الأمّة التي يعيش في كنفها، والالتزام بقواعدها وقوانينها، بما فيها الالتحاق بجيشها ودفع ضرائبها. لذلك إذا أردنا أن نتمسّك بهويتنا وحضارتنا وتاريخنا وقيمنا، فلا مناصّ مِن التمسّك بأرضنا والدفاع عنها. في هذه الحال، الأولوية يجب أن تكون دائماً للانتماء القومي/الوطني، وثانياً لانتماءاتنا الأُخرى مِن دينية واثنية، وخلاف ذلك يعني انهيار الدولة-الأمّة وتلاشيها في حروبٍ أهلية لا تتوقّف.
إذا أخذنا إيران كمثلٍ لوجدنا أنها دولة-أمّة، فهي تعرّف نفسها على أساس أنها جمهورية أوّلاً، وقبْل كلّ شيء، وإسلامية ثانياً، والصراعات الفكرية والسياسية في داخلها تدور حول شكل حكمها ونظامها، ولكنها لا تتناول وجود إيران كدولة-أمّة، فهذه مسلّمٌ بها مِن جميع الإيرانيين، المعارضين والموالين. بينما نجد أنّ المشرق العربي لم يبدأ ببلورة صيغة الدولة-الأمّة بالرغم مِن مرور أكثر مِن قرنٍ على انهيار السلطنة العثمانية لأنّ الغرب الذي استولى عليها قسّمها إلى مناطق طائفية منعاً لوحدتها، وإمعاناً في نهب خيراتها وإحكام السيطرة عليها.
نتائج بناء الدولة-الأمّة
تترتّب نتائج هائلة حين يتغيّر التنظيم المجتمعي مِن نخبةٍ صغيرة تسيطر على السلطة باسم الدين أو العرق إلى إقرار مبدأ أنّ «الشعب هو مصدر السلطات كلّها». هذا يعني أنه يحقّ لكلّ فردٍ في المجتمع أنْ يقرّر مصيره بنفسه وألا يكون ثمّة جهة تقرّر عنه وتضحّي به حفاظاً على مصالحها الخاصّة. مِن هنا الانتقال مِن حكم «الخاصّة» إلى حكم «العامّة»، فنحن نتكلّم اليوم عن مدارس عامّة، أي لعموم أفراد الشعب مِن دون أي استثناءات، بينما المعرفة كانت محصورةً ضمن الخاصّة فقط فيما الجهل مسيطرٌ على العامّة. وقد لعب اختراع الطباعة دوراً أساسياً في نشر المعرفة العلمية، إذ بدونها لا أمل في تقدّم المجتمع، كما نتكلّم عن فضاءٍ عامّ حيث يحقّ للجميع التنقّل، وإدارات عامّة، وشوارع عامّة، وأساليب نقلٍ عامّة، وقوانين عامّة وانتخابات عامّة، أي إنها تصبّ كلّها في مصلحة «العامّة».
حكم الخاصّة كان قائماً على مبدأ «النسب»، فقضت الثورة الشعبية على هذا المبدأ المبنيّ على العامل الوراثي، واستبدلته بمبدأ «الكفاءة». فالطامح إلى منصبٍ ما في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع، عليه أن يكون ملمّاً بالعلوم التي تؤهّله لتبوّؤ هذا المركز لأنّ كفاءته ستعود بالفائدة على عامّة الشعب. اعتماد المعرفة كأساسٍ للسلطة هو الذي سمح بالتطوّر السريع في دول أوروبا ثمّ التوسّع شرقاً وغرباً خلال القرن التاسع عشر وما بعد، والسيطرة على دولٍ كانت لا تزال تتحكّم بها أقلّياتٌ تعتمد النسب لا الكفاءة.
إنّ نجاح التنظيم الاجتماعي القائم على مفهوم الدولة-الأمّة، وشعب على أرض، هو نتيجة ركيزتين أساسيتين: ترسيخ مفهوم الانتماء القومي/الوطني، وحيازة المعرفة العلمية، فلا مناصّ مِن العمل على بناء الوعي القومي وأهمّية الانتماء إلى الأرض منذ الطفولة. ولقد مثّلت التربية الوطنية ركناً بالغ الأهمّية في توجيه جيلنا في العالم العربي في الستينيات والسبعينيات مِن القرن الماضي، لكنه تمّ التخلّي عن مادّة «التربية الوطنية» منذ عقود، ما يعني أنّ العلم الذي يختزنه أولادنا سيذهب هباء، كونهم يدرسون في مدارس خاصّة أغلبها أجنبي فلا يهتمون بإصلاح بلدهم، بل الانتقال حالما يحصلون على شهادتهم إلى أي مكانٍ في العالم يوفّر لهم وظيفة، فيصبح الوطن الذي يلتحقون به هو المستفيد مِن كفاءتهم دون أن يدفع هذا الأخير أي قرش في تعليمهم، ويصاب الوطن الأمّ بنزيفٍ لا شفاء منْه على صعيد هجرة المثقّفين، وعلى صعيد النزف المادّي الذي لا مردود له.
الاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو المقاومة، لأنها تعمل على الدفاع عن الأرض، وعن الشعب الذي يسكن هذه الأرض بمعزل عن دينه أو عرقه؛ وهي الوحيدة التي تفعّل المنحى القومي/الوطني في العالم العربي بعد استسلام غالبية الدول العربية لمشيئة المستعمر الغربي، وهي المتكلم باسم الشعب الذي يتوق إلى الانعتاق من العبودية، وهي الوحيدة المتمكّنة في المعرفة التكنولوجية وتصنيعها بشكلٍ ينافس أعتى القوى العسكرية العالمية. فنحن نرى كيف أنّ مُسيّرات المقاومة استطاعت أن تهزم القبة الحديدية التي تُعتبر درّة الصناعة الغربية، فلا يهدأ بال «إسرائيل» لأنّ المقاومة تشكّل التهديد الأكبر لوجودها.
في العالم الحديث، يتمّ تحديد تراتبية الدول نسبةً إلى التطوّر التكنولوجي لا نسبةً إلى الشعر والموسيقى والمسرح، فهذه الأخيرة لا تستطيع أن تبقى وتتقدّم إلّا إذا كانت دولتها تختزن أسرار التكنولوجيا، والبرهان على ذلك أنّ غالبية النشاطات التجسّسية تدور منذ الحرب العالمية الثانية حول سرقة الاختراعات التكنولوجية. لقد تقاعست دول العالم العربي كثيراً في المضمار العلمي والتكنولوجي والتصنيعي، فتلجأ دولها الفاحشة الثراء إلى شراء ما يصنّعه الأجنبي وتغدو رهينةً ضعيفة بين يديه، بدلاً مِن أنْ تبادر إلى الإنتاج الذي يقدّم لها النموّ والاستقلالية.
لا مقاومة مِن دون علمٍ ومعرفة، ولا مقاومةَ مِن دون انتماءٍ قومي/وطني؛ هذا ما تقوم به المقاومة اليوم نيابةً عن العالم العربي، نيابةً عنّا جميعاً.
[محاضرة ألقيت في مؤتمر «المدرّسين والطلبة: التربية المقاومة»، في 15 حزيران 2024]
* أستاذة جامعية