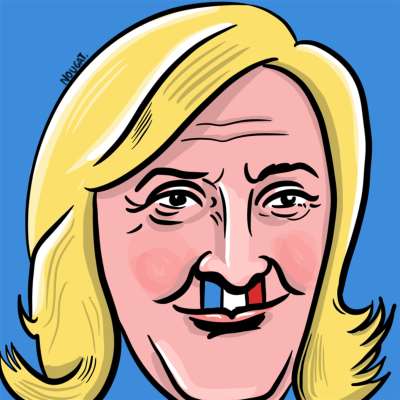يمكن تقسيم العلاقة بين الخليج والمشرق إلى أربع مراحل: في البداية، كانت المرحلة الكويتية، عندما استضافت الكويت الحركات الوطنية الفلسطينية والعروبية. بعدها جاءت المرحلة السعودية، عندما دعمت المملكة تحويل الطبقات العاملة والإدارية الوافدة والأصيلة إلى جماعات سلفية وجهادية اختبرت فاعليتها السياسية الأولى في أفغانستان. بعدها جاءت الحقبة القطرية، التي قامت على استضافة شريحة عريضة من المعارضين السياسيين الإسلاميين والعلمانيين. أمّا اليوم، فنحن نعيش المرحلة الإماراتية، وهذه بالمختصر قائمة على النفور التامّ من الحركات الاجتماعية المذكورة أعلاه. وأمّا الحركة الاجتماعية التي تستضيفها الإمارات وترعاها، فهذه بحاجة إلى شرح طويل يعود بنا إلى التسعينيات من القرن الماضي.
المال والجسد في مواجهة العقل والسلاح
في عام 1995، كتب الأكاديميان ريتشارد باربروك وأندي كاميرون مقالاً بعنوان «الأيديولوجية الكاليفورنية»، والتي ظهرت خلال طفرة اقتصاد وادي السليكون، حيث صهرت أفكار اليسار الجديد المتحدّر من الستينيات وأفكار اليمين الجديد المتحدّر من الثمانينيات، لتكوين الإنسان «الهيبي الريادي» المتحرّر من الناحية الاجتماعية، والمحافظ من الناحية الاقتصادية - السياسية، والذي يرى في الفردانية الاقتصادية اليمينية (على حساب الحقوق الجماعية) عنصراً ضرورياً في خلق يوتوبيا رقمية - تقنية تساعد في الوصول إلى أعلى مراحل تحقيق الذات الفردانية.
في العالم العربي، في نهايات العقد الأوّل من الألفيّة، ظهر فكرٌ مشابه أسمّيه يوتوبيا «صنع المحتوى». في البداية، تمّ توظيف هذا الحيّز في تغطية مشاريع جماعية كبيرة خلال الثورات والانتفاضات العربية بعد عام 2011. وبعد مرور عقد كامل من النكسات والهزائم التي أخرجت السياسة من صنع المحتوى - كما حدث مع باسم يوسف - باتت يوتوبيا صنع المحتوى هدفاً بحدّ ذاته.
هكذا تكوّن الإنسان العربي الفرداني المعادي للسياسة. وهكذا ولدت الأيديولوجية الإبراهيمية التي تجمع ثلاثة عناصر:
(1) الحرّية الاجتماعية - الجسدية والرقمية من المجتمع.
(2) الحرية الاقتصادية من الدولة، أي نسخ نموذج تحقيق الذات الاقتصادية في دول الخليج الغنيّة.
(3) المحافظة السياسية، أي معاداة الحرّية السياسية والفكرية، وخاصّة السياسة الجماعية العربية على المستوى الإقليمي، وتبنّي الأيديولوجية السلفية بشأن عدم جواز الخروج عن الحاكم.
هذا التحريم ينطبق طبعاً في العلاقة مع الحاكم الخليجي وليس الحاكم المشرقي. هنا لا تمارس السياسة بتاتاً في الخليج، بينما تمارس في المشرق فقط على صعيد المكافحة النيوليبرالية للفساد التي لا تقوم على أسس اقتصادية أو علمية بل على أساس «لماذا دولنا ليست مثل دبي؟».
من أجل فهم مبسّط للأيديولوجية الإبراهيمية، يكفي النظر للحاضرين في «محاكمة» جبران باسيل في «منتدى دافوس» (2020): الصحافية الأميركية الشابة الشجاعة، مبعوثة الاتحاد الأوروبي ورجل الأعمال النبيل الآتي من الإمارات، كلّهم يقرّعون السياسي المشرقي الفاسد. هنا يتمّ نسخ نموذج الفساد الأوروبي الذي تحدّث عنه اليساري اليوناني يانس فاروفاكيس: الفساد التافه والقديم يحدث في جنوب أوروبا (والمشرق العربي) والفساد المتطوّر عالي التقانة يحدث في شمال أوروبا (والخليج العربي).
أبعد من «الدحلانية»
بالنسبة إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، فقد بنت المرحلة الحالية، على الأقل ما قبل السابع من تشرين، الأسسَ للمرحلة الإبراهيمية القادمة تماماً كما وضعت المرحلةُ العرفاتية في التسعينيات - بالرغم من محطة انتفاضة الأقصى - الأسسَ للمرحلة العباسية أي مرحلة فلسطين ضمن برنامج «الشرق الأوسط الكبير».
لا تكمن المشكلة فقط في محمد دحلان، أو في الدحلانيين كمنشقّين غاضبين، بل تكمن في الأيديولوجية الإبراهيمية التي لم تلد وقت توقيع اتفاقياتها، بل استشرت قبل ذلك بكثير، في طبقة وسطى ترفض التطبيع العربي في المبدأ وتدينه، لكنها تنشط في الحيّز الاجتماعي والسياسي الذي يعيد معسكر التطبيع العربي إنتاجه. هنا ظهرت في المجتمع الفلسطيني طبقة مهنية إدارية مهمتها محاربة ثنائي المجتمع والدولة من أجل الحرّيتين الجسدية والاقتصادية، على نسق ليبراليّي الحزب الديموقراطي في أميركا. تماماً كما يضحك هؤلاء الأميركيون على نكات جون ستيوارت، وتماماً كما ضحك المصريون الليبراليون على نكات باسم يوسف عن محمد مرسي، يضحك فلسطينيو الطبقة الوسطى (ضحكة الأرستقراطيين) على نكات علاء أبو دياب عن السلطة (ذلك كلّه قبْل أن يذهب أبو دياب من أجل تقديم عرض كوميدي في الإمارات).
هذا الصنف من وطنية الطبقة الوسطى استفاد لسنوات من نقد الوضع القائم ذاته الذي بنى هذه الطبقة وطوّرها، وذلك حتّى تأتي أحداثٌ مفصلية مِثل هبّة أيار 2021 التي وجّهت صفعةً للفكر الإبراهيمي و«طوفان الأقصى» الذي أجبر المحتلّ الإبادي على استخدام العصا بدل الجزرة من أجْل إعادة تكريس الفكر الإبراهيمي.
هكذا، يتناسى سؤالُ «أين الضفة؟» أنّ الطبقة الفلسطينية الوسطى اليوم هي نتاجٌ لتغيّرات جذرية في الطبقة الوسطى العربية. في السابق، كنتَ تحتار بين العمل في الكويت أو ليبيا، دراسة القانون في دمشق أو الهندسة في بغداد. رفاقك كانوا ينصحونك بتوفير المال من أجْل زيارة المخيّمات والتنظيمات الفلسطينية في لبنان وتناول الشاورما في الضاحية الجنوبية. باستثناء الضاحية، هذا العالم العربي اختفى منذ وقت بعيد، الآن تذهب إلى القاهرة فينصحك أصدقاؤك هناك - تحسّباً وتجنّباً للمشاكل - بأن تعرّف عن نفسك كأردني وليس كفلسطيني.
خاتمة
من البديهي، إذاً، أنّ الأيديولوجية الإبراهيمية لا تصلح أيّام الحروب الاستعمارية الإبادية بل هي مناسِبة أكثر لدفع الفلسطيني إلى التصرّف كالثائر الأوكراني والبولندي عام 1989 ضدّ البيروقراطية السوفياتية التي تشبه في أخطائها البيروقراطيةَ الفلسطينية. كان يكفي أن ترى منشورات الماركسيين التروتسكيين المتصهينين في الغرب كيف وقفوا إلى جانب إسرائيل منذ السابع من تشرين، وذلك حتّى منتصف الشهر عندما دعموا خروج تظاهرات ضدّ مقرّ المقاطعة في رام الله، حينها فسّر هؤلاء التروتسكيون على هواهم أنّ الشباب الفلسطيني أراد التخلّص من البيروقراطية الفلسطينية للمطالبة بالانضمام إلى الغرب المتحضّر، لا للمطالبة بالانتفاضة الشاملة في الضفّة.
إنّ النقد الشعبوي لأوسلو، أو الطائف، والسلطة الفلسطينية أو الحكومة اللبنانية، أو الانقسام أو الطائفية، من دون نقد الهيمنة الخليجية والأميركية في بلادنا، ليس إلا رياضة للتنفيس عن الذات. لقد جرى تعويم مِثل تلك الأدوات النقدية وأُفرغت من محتواها، وخاصّة بعدما وجدْنا أنفسنا في الخندق ذاته مع محمد دحلان وعبد الله بن زايد الذي ينتقد الفساد في السلطة ويصفها بعصابة «علي بابا والأربعين حرامي»، بينما يتواطأ مع المستوطن بتسلئيل سموتريتش على تطبيق نسخته من عقوبات قيصر من أجل تجويع صغار الموظّفين والمدرّسين وأقلام المحاكم ليس فقط في الضفّة بل في غزة. هذا بينما ينعم بالأمان المادّي الحقوقيون ناقدو التخلّف والمؤثّرون الرياديون ناقدو الفساد.
* كاتب فلسطيني
الأيديولوجيا الإبراهيميّة في الطبقة الوسطى الفلسطينية
- رأي
- صدقي عاصور
- الخميس 4 تموز 2024