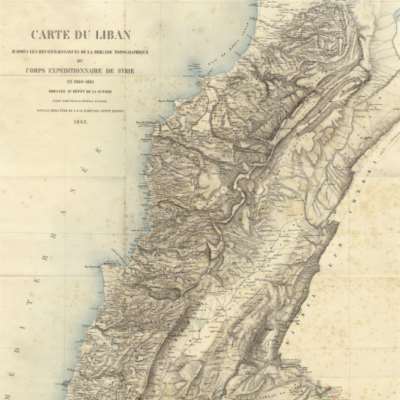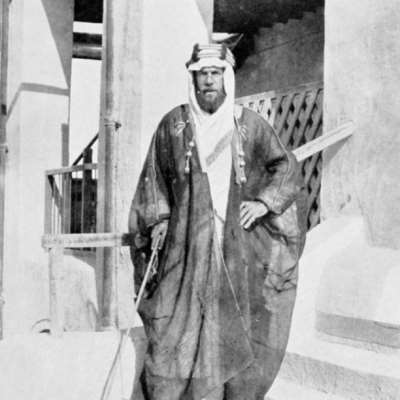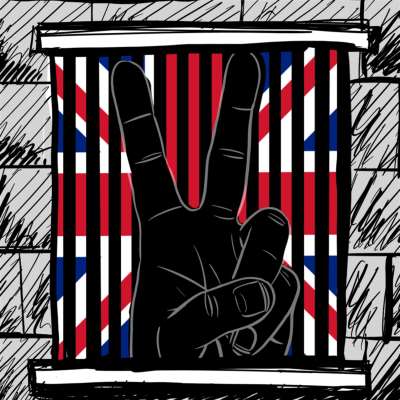لا نعرفُ كيف يكثّفُ التاريخُ التجارب ودروسَها في بعض الأحيان، لكنّنا ندركُ أنّه يفعلُ ويسهّل علينا الفهمَ والاستنتاج.من دروس الفاصل التاريخي الذي يبدأ في عبور السابع مِن أكتوبر 2023 ولا ينتهي في الشهر السابع مِن الحرب الإسرائيليّة على غزّة، أن لا إستراتيجيّة يعتدّ بها في مواجهة العدوان الصهيوني المدعوم مِن الغرب سوى خِطّة «طوفان الأقصى» التي أطاحت العقيدةَ الأمنيّة للدولة اليهودية، وأعادت إلى بساط البحث مسألةَ وجود الكيان الصهيوني القائم على الاحتلال والاستيطان الكولونيالي، كما عطّلت ديناميكيةَ التوجّهات الأميركية العربية في شأن التطبيع مع إسرائيل ولا سيما منه الحلقة السعودية.
وإنّ قيادة حركة «حماس» في قطاع غزّة لم تفعل سوى ترجمة الإرادة الشعبية الفلسطينية والعربية بأنه لا يمكن تجاوز الحقّ الفلسطيني في السياسات الإقليمية، الأمر الذي جعلها تتبوّأ مكانةَ مَن يصحّح مسار المشروع الوطني الفلسطيني، ويعيده إلى جدول الأعمال الدولي. ولم يكن هذا التحوّل ممكناً مِن دون رؤية متقدّمة للكفاح المسلّح لدى يحيى السنوار وربط القوّة القتالية في غزة بالضفة الغربيّة والكفاح المركزي الفلسطيني.
ومع تأكّد عجز جيش الاحتلال عن تحقيق هدف القضاء على «حماس» وإجبار الفلسطينيين على إخلاء القطاع، فإنّ البرودة الموضوعية في الموقف العربي الرسمي إزاء إنجازات المقاومة الفلسطينية والصلابة الأسطورية للمجتمع الفلسطيني بوجه محاولات الإبادة، تقودنا إلى طرح الإشكالية التالية:
هل أسهمت الديناميكية الجيو-إستراتيجية التي أطلقتها «طوفان الأقصى» في إعادة وصل ما انقطع بين القضية الفلسطينية والسياسات العربية؟
هل مِن دورٍ عربي يعوّل عليه في تحرير فلسطين استناداً إلى مراجعةٍ نقديّة للتجارب الماضية؟
إنّ محاولة الخوض في أوجه هذه الإشكالية، بُغية تفعيل الموقف العربي الرسمي أو إصلاحه، تستدعي علاقة التقاطع بين الرسمي والشعبي كما تَظهرُ في الميدان اللبناني واليمني والعراقي، مثلما تدعونا إلى الاهتمام بالأداء السياسي للمقاومة في غزّة وكيف أنه لا يخترق الحصار إلى اللعبة الديبلوماسية الدولية مِن دون المواكبة الرسمية لدولة قطر وجمهوريّة مصر العربية، فضلاً عن المتابعة السعودية. وعندما نتحدّث عن خيار الاعتماد على الطاقة الشعبية كما تتجلّى في جبهة المساندة (لبنان، اليمن، العراق، الأردن) علينا تجنّب التبسيط لتلمّس نبض الشارع المصري الذي قد تُنبّهه الفطرةُ إلى عدم التسامح، وإن بعد حين، إزاء التفريط بقضية وجودية صارت هي قضية العالم اليوم.
وإذ نأتي إلى أهمية الرؤية الإستراتيجية التي يجب أن تُوفِّر لخطّة «طوفان الأقصى» بُعداً جيوسياسياً إقليمياً، نفترض أنّ تحوُّل جبهة المساندة إلى نوعٍ مِن حرب الاستنزاف، تؤمَّنُ خطوط إمدادها الضرورية مِن المحور الفلسطيني/العربي/الإيراني، يمكنُ أن يكون الإستراتيجية الكبرى لتحرير فلسطين وإنهاء المشروع الصهيوني.
ونفترض، إلى ذلك، أنّ الثلاثي الإقليمي، الفلسطيني العربي الإيراني، قد توصّل إلى إطارٍ مفهومي جديد للعلاقات يتجاوز الأطر التقليدية إلى «الاعتماد المتبادل» الذي يشير إلى مجموعةٍ مِن العمليات الترابطية تتّسم بكثافة المعاملات وتوازنها.
واقع الحال أنه في الوقت الذي يُتوقّع عودة العلاقات المصرية الإيرانية إلى مجراها الطبيعي قريباً، فإنّ النظرة العربية الرسمية حيال إيران قد تبدّلت تحت تأثير الرأي العام العربي الذي ينظر إيجابياً إلى المواجهة التي تخوضها طهران مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
وفي سياق الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، والذي قوّض ما تبقّى مِن هيبة الردع الإسرائيلي عقب اختراق أكتوبر الفلسطيني، انتهت حِقبةٌ كانت تسمح بازدواجية في السلوك العربي مِن نوع «نحن مع أميركا تحت الطاولة ضد إيران ولكن نلتزم الحياد فوق الطاولة». ولم يعد يُسمع في الأوساط الديبلوماسية العربية ذلك الكلام الذي يقارب أزمة البرنامج النووي الإيراني بالقول إنّ «على الأميركيين أن يتدبّروا الأمر لوحدهم مع الإيرانيين» بحجّة أن لا أحدَ في العالم العربي، على مستوى الحكّام، لديه مقاربة لإيران أو لدورها الإقليمي.
* كاتب وصحافي لبناني
هل مِن دورٍ عربي يعوّل عليه؟
- رأي
- ميشال نوفل
- الأربعاء 12 حزيران 2024