انطلاقاً من حرب عربيَّة عربيَّة تدور رحاها في القرن الخامس عشر بين إمارتَي «ماليندي» و«منبسي» الواقعتين في أفريقيا (تحديداً في «كينيا» اليوم)، تحكي الرواية سيرةَ «سيف» نجل الشيخ يوسف الماليندي حاكم الإمارة الأولى، الذي يوافق في غمرة حقده على أعدائه في منبسي ورغبته الجارفة بالانتقام منهم لقتلهم بكره مروان، على طلبٍ برتغاليّ نقله إليه فاسكو داغاما بإقناع صديقه البحار العربي أحمد ابن ماجد بمرافقتهم إلى الهند ليكون دليلاً لهم، مشترطين اصطحاب سيف لضمان عدم خيانة ابن ماجد لهم، مقابل منح الشيخ عشر بنادق تضمن له الانتصار على أعدائه.
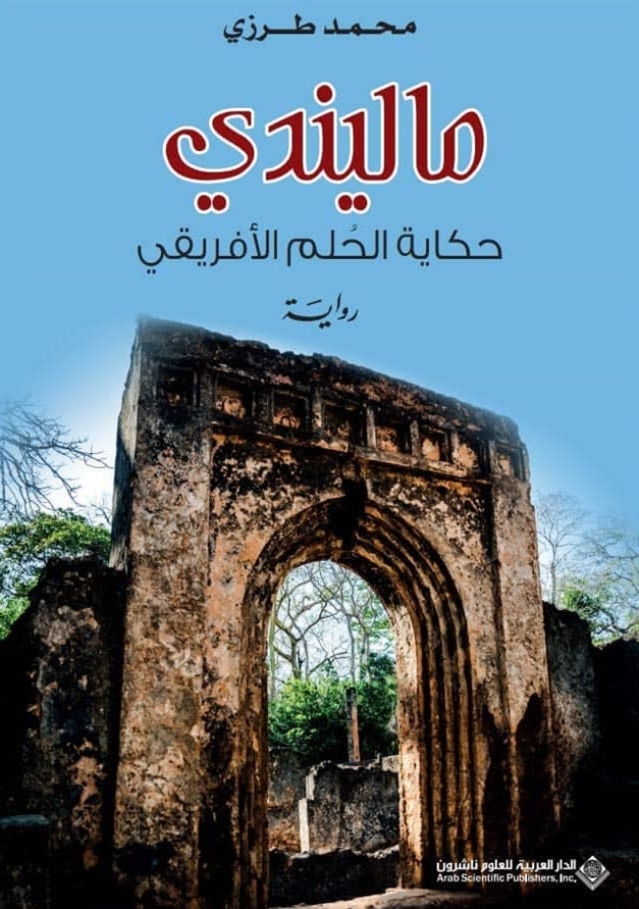
يواجه الفتى الذي لم يستشِرْهُ أحدٌ قبل إبعادِهِ عن محبوبته «رفقة» ابنة الوزير الحبشيّ اليهوديّ مطيع، كمّاً كبيراً من المصاعب والأهوال ليس أعظمها وفاة ابن ماجد بين يديه مشيَّعاً باتهامات أبناء جلدته بالخيانة لمساعدته البرتغاليين في الوصول إلى الهند وقضائه نهائيّاً على طريق الحرير وأرزاق التجّار العرب.
تحاول الرواية إنصاف ابن ماجد الذي بذل أقصى ما بوسعه لإقناع أمراء العرب بتمويل رحلته إلى جزر عظيمة مفقودة تتجاوز مساحتها أرض أفريقيا لينشر فيها الإسلام ويضمّها إلى أمّة العرب، إلا أنَّ هؤلاء رفضوا لانهماك مقاتليهم في حروب العرب الكثيرة فوق أرض الزنوج، بحيث لم يتعاون مع البرتغاليين إلا كارهاً، نزولاً عند رغبة الشيخ الذي صار - بعد رؤيته الماسورة الطويلة الملساء وتخيّله مفعولها السحري في الانتقام لبكرِهِ مروان - يرى العالم بطريقة مختلفة، فلم يجد ضيراً في التخلي عن صديقه البحّار، وهو الذي أرسل معه في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر فلذةَ كبده الذي لم يبلغ الحلم «سيف».
ولا يحتاجُ القارئ إلى أكثر من صفحات معدودة كي يكتشف أنَّ محمد طرزي في هذه الرواية ليس متأثراً بأمين معلوف، كما اكتشف من قبل أنَّه ليس متأثراً بجرجي زيدان في كتابة «رسالة النور»، إذ يتقن الكاتبُ لعبةَ الرواية التاريخيّة ويهواها، ولا يقتفي أثر أحد فيها. يحافظ على إخلاصه للفنّ الروائيّ مدركاً في الوقت نفسه الوقت المناسب لإفساح المجال أمام مخيَّلته الخصبة في خلق شخوص جاذبة وحبكات مشوّقة وخطوط رديفة، دون أن يسمح لنفسه بليّ عنق التاريخ أو تحريف وقائعه وتزييف حقائقه. وهو لهذه الغاية يدرس المادّة التاريخيّة جيّداً مستعيناً بأكبر عدد من المراجع والوثائق والمخطوطات النادرة، وينطلق من النقطة التي يختلف بشأنها المؤرخون ليبني عليها حبكته، ولعلَّ أصدق ما قيل عنه هو ما جاء في شهادة الناقد المصري أحمد درويش ضمن ندوة عُقِدَتْ مؤخّراً في القاهرة لمناقشة «رسالة النور» عن كونه «يكتبُ من وحي وثائق ومكتبات وفلسفة، وليس في مقهى أو في ظلال حديقة» (وليس في هذا – بطبيعة الحال – افتئاتٌ على الحقّ بالكتابة في كلّ مكان، أو انتقاصٌ من جودة النصّ بحسب مكان كتابته، بقدر ما فيه من إشارة إلى حساسيَّة ودقة كتابة الرواية التاريخيّة تحديداً).
فأحداثُ «ماليندي» مستقاة من وقائع وردت في ثلاث مخطوطات مفقودة ونادرة هي «خزينة الأسرار في قواعد علم البحار» لأحمد بن ماجد، والتي ظَهَرَت لأوَّل مرَّة في مزاد علنيّ نظمته دار كريستيز في لندن عام 1998، و«الحروب الصليبيَّة كما لم يرها العرب» لقاضي القضاة العلامة أبي منصور الصقريّ المولود في ماليندي عام 1436 م، ومذكرات موسى بن عطار المولود في غرناطة العرب عام 1475 م.
وموسى بن عطار هذا ليس سوى «الأمرد» في الرواية، الذي يرافق فاسكو داغاما في زيارته الأولى إلى ماليندي ويتولى بكثير من الحنكة دورَ المترجم بينه وبين الشيخ، وهو الذي يقدّم سيف لنخّاس هنديّ قبل العودة إلى ماليندي زاعماً وفاته بعدوى انتقلت إليه من ابن ماجد قبل وفاته، طمعاً في الفوز بمحبوبته رفقة. وقد أجاد الكاتبُ استخدامَ الألقاب في تسهيل مهمَّة القارئ في حفظ الشخصيّات والتمييز بينها، فهناك أيضاً «الأشوَل» وهو «وحيد» ابن زعيم قبيلة الجيبانا الأفريقيّة وصديق سيف الحميم، وهناك «الأحدب» عازف الناي الخلاسيّ الغارق في حبّ غانيةٍ والذي يرافق سيفاً في رحلته البحريَّة إلى الهند.
ويبدو محمد طرزي مولعاً بتناول أكثر المحطات حساسيَّة ودقة في التاريخ البشري، فهو في «رسالة النور» يلتقط من خلال شخصيّتَي ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب، اللحظةَ التي شهدت أفول الحكم الأمويّ والانطلاقة القويَّة لبني العبّاس الذين بدا سريعاً أنهم لم يتعلموا شيئاً من عِبَرِ التاريخ ودروسه. وفي «ماليندي»، يعاين اندثار طريق الحرير - بعد وصول البرتغاليين إلى كاليكوت (كالكوتا) الهنديّة دون الحاجة إلى المرور ببحر العرب - حاملاً معه أفول نجم حضارة عربيَّة رائدة لتنبثق حضارة أخرى يحمل فيها الأوروبيّون المشعل.
وهو لا يكفّ عن تحميل سرده الممتع برسائل وإسقاطات تزخمه ولا تثقله، فها هم العرب يتنازعون ويقتتلون فتذهب ريحهم ويضيع ملكهم، وها هم يقفلون مكتباتهم خوفاً على ما فيها من الغبار، ولا يحاذرون الوقوع في المسلَّمات حذرهم من الوقوع في الكفر، وها هو الغرب يأخذ أغلى ما لديهم لقاء بضعة بنادق يوهمهم أنَّ في فوهاتها النصر المؤزَّر فيكتشفون متأخرين أنَّه باعَ مثلها لعدوّهم، وها هم الفرس أمة قويّة يجمعها الدين بالعرب، فيتردّدون في التحالف معها انطلاقاً من أنَّ ضعفهم إزاء قوتها كفيل بجعلهم أتباعاً لا حلفاء.
ولعلَّ أبرز ما أورده الكاتب على لسان أبطاله من حكم وعبارات بليغة تستحق تخليدها، هي تلك المستوحاة من لعبة الشطرنج التي تكاد تكون أحد أبطال الرواية الرئيسيين. تحضر الشطرنج مراراً في صفحات الرواية ابتداءً بإهدائها إلى الشيخ يوسف الماليندي من قبل ابن ماجد طمعاً في نيل موافقته على تمويل حملته، ثمَّ حين ينبّه الوزير الحبشيّ مطيع سيفاً إلى أنَّ أخطر شرك يواجهه الإنسان - في الحياة كما في الشطرنج - هو خوفه من شرك لا وجود له، ثمَّ مع الشيخ إذ يخلص في حديثٍ مع ابن ماجد إلى أنَّ حركة خاطئة واحدة كفيلة بإهدار ثلاثين حركة صحيحة، وأنَّ القائد الفذّ يحرص على حياة الجند حرصه على حياة الملك، فيجيبه الأخير بأنَّ الجميع، جنوداً وملوكاً، وبغضّ النظر عن هويَّة المنتصر وموقعه، سيوضعون في النهاية في صندوق أسود صغير.


