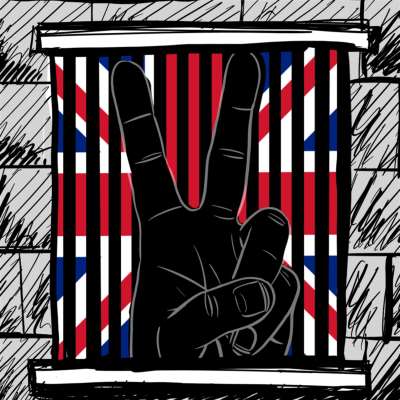المحزن في الحالة السعودية هو أنّ الإجابة عن «السؤال التنموي» لا يفترض بها أن تكون إشكاليّة لديهم، بل هي سهلة وواضحة، كلّ عناصرها حاضرة، ولا يحتاج تحقيقها إلى عمارات غرائبية مثل «نيوم» ونُسَخ عن دبي ومدن ملاهي عملاقة. نحن لم نعد في أيّام غرشنكرون، وقد أصبحت أمامنا تجارب تاريخيّة كافية في القرن الماضي وأدبيات وفيرة شرحت لنا وحسمت، أقلّه في الخطوط العريضة، الطريق إلى تحديث اقتصادك وبناء قاعدة صناعية وكيف تعمل هذه الأمور.
في العمق والجوهر، فإن المعنى الحقيقي للتنمية، أو الخروج من وضعية التخلّف الاقتصادي والتقني، يتمثّل في أن تجد لكلّ أهل بلادك «عملاً شريفاً» منتجاً. أي أن يجدوا وظائف لها قيمة مضافة في اقتصادٍ حديث، ثمّ ترفع تدريجياً - بالتعليم والاستثمار والأبحاث - من قيمة عملهم وإنتاجيتهم. والهدف هو أن تنتج، عبر هذه العملية، طبقة عاملة مدرّبة وتنافسية، لديها مهارات حقيقية وخبرة وثقافة إنتاج.
المفارقة هي أنّ لديك في السعودية، أصلاً، سوقاً كبيراً وثريّاً، موارد وفيرة، وأنت «غنيٌّ» برأس المال ولا تحتاج إليه من الخارج. وفوق ذلك، فأنت تعقد علاقات ممتازة مع السوق الدولي وتقدر على استحضار التكنولوجيا والشراكات التي تريدها، فما الذي ينقصك هنا؟ تاريخياً، تعمل شعوب الدول النامية وتكدّ لجيلٍ أو اثنين، في مصانع النسيج أو على خطوط التجميع، لكي توصل بلادها إلى شيءٍ يقترب من «نقطة الانطلاق» التي حباك الله بها. لديك السوق الداخلي ولديك رأس المال اللازم للاستثمار. بتبسيطٍ شديد: السّعودية تستورد، أصلاً، سلعاً وخدمات بمئات مليارات الدولارات سنوياً؛ لو أنك قمت، بدايةً، بإنتاج نصفها داخل البلد فسوف تخلق اقتصاداً بنصف تريليون دولار وتوظّف كلّ الشعب السعودي بالاعتماد كلياً على سوقك الداخلي (وتطلق عملية تنموية صناعيّة على مستوى البلد بأكمله). ولا يجب، في مثل هذه الحالة، أن تستحضر عمّالاً أجانب إلّا حين تحتاج إلى أن تفرّغ مواطنيك لأعمالٍ ذات قيمةٍ أعلى.
لم يأتِ ربط التنمية بـ«التصنيع»، والبناء التدريجي لقاعدة صناعية وعلمية، عن عبثٍ أو عن افتتانٍ بالآلات والعصر الذهبي للماكينات. لا يزيد عدد العاملين في قطاع التصنيع في الصين على 18 في المئة من القوة العاملة، ولكن الاقتصاد الصيني لن يكون شيئاً من غير صناعته. المغزى، كما يقول الألمان، هي أنّ كلّ وظيفةٍ في صناعة السيارات عندهم تستولد خمس وظائف في باقي أرجاء الاقتصاد. القيمة هنا ليست في عدد الذين يوظّفون مباشرةً على خطوط الإنتاج، بل هي أيضاً في ذاك الذي سيعمل معهم في الإدارة والمبيع، ومَن سيصمّم الموقع الإلكتروني، ومدير السوشيال ميديا، والذي سيفتتح مطعماً لخدمة كلّ هؤلاء...
والسوق السعودي ثريّ وكبير، هو مثاليّ لتوليد المنافسة، بمعنى أنه لو تبيّن مثلاً أن البوظة التي تباع في البلد سيئة، فستجد تلقائياً عشر شركاتٍ تخرج لاستبدالها وجذب زبائنها. وحجم الاقتصاد يسمح للبلد بأن يفاوض مثل الصين حين يستحضر شراكات أجنبية، أي يفاوض بشروطه إلى حدّ ما (بغية نقل الخبرة والتكنولوجيا). ستتسابق شركات السيارات العالمية، كمثال، على بناء مصانعها في السعودية لأن مَن يدخل سيحظى بالسوق الكبير، ومَن يظلّ خارجاً سيحرم منه (وعندها قد تصبح السعودية مركز تصنيعٍ للمنطقة المحيطة بأكملها، وليس للسوق المحلي وحده).
في وسع بعض الدّول الصغيرة، مثل إيرلندا أو تايوان أو فنلندا، أن «تتخصّص» في وظيفةٍ محددة ضمن الاقتصاد الدولي وتعتمد عليها (سياحة ولوجستيات مثلاً، أو مصارف وتمويل، أو شركة «نوكيا»)، ولكن هذا الخيار غير متاحٍ لدولٍ كثيرة السكان مثل السعودية أو العراق أو الجزائر. هنا لا بديل من خلق اقتصادٍ منتجٍ ومتنوّع، يشغّل كل هؤلاء الناس ويستثمر في قدراتهم، وخريطة الطريق ليست معقّدة. أمّا أن تكون لديك كلّ هذه المقوّمات للتنمية الحقيقية، معطاة سلفاً، ثم تذهب في اتجاه الفنادق ومدن الملاهي و«نيوم»، فهذا يشبه قصة. والقصة هي عن أن تكون شاباً محظوظاً في بداية حياته، درّسه أهله في جامعةٍ خاصّة، وأمّنوا له بعدها عملاً مقبولاً، واشتروا له شقّة حتى يتزوّج فيها. الناس يعملون لعشرين عاماً حتى يصلوا إلى هذه النقطة. وفي الوقت نفسه، هناك فتاة لطيفة وجميلة قرّرت لسببٍ ما لا نفهمه أن تحبّه وترتبط به. بمعنى آخر، كلّ ما عليك فعله هنا هو «الحدّ الأدنى»: أن تنتظم في عملك المريح، وتتزوج في بيتك، وتبدأ حياتك في ظروفٍ أكثر من مؤاتية. ولكنك، بدلاً من ذلك، تقرّر ترك الوظيفة، والانفصال عن خطيبتك، وتسعى إلى تأجير الشقّة كـ«ديسكو» (هذه، في المناسبة، ليست خيالاً، بل قصة واقعية عن شخصٍ أعرفه - واسمه مازن).
دول الفوائض
علينا أن نتذكّر أنّه، في المبدأ الاقتصادي، لا يوجد أيّ امتيازٍ للتصدير في ذاته، للّه باللّه. بمعنى أنّه، بين أن تقوم ببيع ما تنتجه في السوق الدولي أو في سوقك الداخلي، فالقيمة المتحققة يفترض أن تكون متساوية في الحالتين. وبالمعنى نفسه، لا سبب لأن تسعى إلى فوائض كبيرة في تجارتك مع العالم كغايةٍ في ذاتها. السعي إلى التصدير الكثيف يحصل أساساً في مرحلة النموّ «الابتدائية»، حين يكون سوقك الداخلي لا يزال صغيراً وفقيراً ولا يقدر على استهلاك كلّ ما تصنعه، وينقصك رأس المال للاستثمار. أمّا في المنطق الاقتصادي العام، فأنت لا «تحتاج» إلى التصدير إلّا بمقدارٍ ما يغطّي استيرادك وحاجاتك من القطع الأجنبي (والفوائض المستمرّة لدولٍ صناعيّة، كما في حالة ألمانيا واليابان، هي نتيجة اختلالاتٍ معينة في السوق الدولي قد نتكلّم عنها في مقالٍ قادم). أمّا تصدير النفط و«الفوائض النفطية» في بلادنا، فهي الدليل الأوضح على كونها دولاً دمجت في السوق العالمي لوظيفة تصدير الموارد الطبيعية والرساميل، بمعنى أن إنتاجها للنفط، تاريخياً، يصمّم بحسب حاجة السوق الخارجي وليس بحسب حاجاتها هي. من هنا نجد هذه الدول وهي تجبر على «تسييل ثروتها» الكامنة إمّا بوتيرة أقلّ من حاجتها (كحال العراق في الخمسينيات) أو أكثر من حاجتها بكثير (كالإمارات وقطر والكويت). وكامل النظام الاقتصادي للبلد، بما في ذلك نظام العملة وربطه بالدولار وتراكم «الفوائض» في الخارج واقتصاد الاستهلاك، كله ينبع من هنا.
سمّت الأكاديمية كيرن شودري كتابها عن السعودية واليمن «ثمن الثّروة»، وهو يشرح كيف أدى ظهور النفط إلى تدمير وإعادة إنتاج البنى المؤسسية في البلد. ولكن المفهوم الذي يعنينا هنا هو «ثمن التبعيّة»، أي إن المشكلة ليست في النفط في ذاته، أو في المال الذي ينتج عنه، بل هي في الطريقة التي تم استخدام النفط فيها ودمج السعودية عبره في النظام الدولي. وهذا الموقع الوظيفي للسعودية، كمصدّرٍ للنفط الخام، هو ما يجعل التنمية الذاتيّة احتمالاً مستحيلاً (في الحقيقة قام بعض الباحثين، مثل بوب فيتاليس وتيموثي ميتشل، بنقد كتاب شودري من زاوية أنه لم يعطِ الأهمية الكافية للدور الأجنبي ولمؤسسات، مثل «أرامكو» وغيرها، كان لها باع طويل في بناء الدولة السعودية الحديثة). وغنيّ عن القول إنّ الدور الوظيفي لدول النفط ينعكس مباشرةً على فعلها السياسي في الإقليم، والمسألة هنا لا تقتصر على خدمتها الدائمة - والمتوقعة - للسياسة الغربية: لو أنّ هذه الدول الثرية كانت نامية ومتقدّمة ومنتجة حقّاً، فهي سيكون لها مصلحة في دمج المنطقة عبر المشاريع والاستثمار والمواصلات، وربط سوقها بسوقهم والسعي إلى الاستفادة المتبادلة. سيكون لها «مشروع» ذو طابعٍ جماعي تعرضه على من حولها. ولكن في شكلها الحالي، فإنّ تدخّل هذه الدول في المنطقة ينحصر في تمويل الصراعات والحروب، ورشوة السياسيين والأنظمة، وشراء الثقافة والنّخب. سيكون من المذهل أن نحصي كمّ الحروب والنزاعات التي موّلتها دولٌ في حجم قطر أو الإمارات على طول الإقليم، وعدد الناس الذين تأثروا بها، من العراق وسوريا إلى السودان واليمن والصحراء الكبرى.
ما يحصل في السعودية اليوم هو في جانبٍ منه فشلٌ لعلم الاقتصاد. فكرة أنه من بين آلاف الاقتصاديين المدرّبين في مختلف المؤسسات السعودية، والمصرف المركزي ومراكز الدراسات، لا يخرج من ينظّر للاقتصاد السياسي في بلاده بشكلٍ شمولي وجذري
يجب أن نوضح أن «خريطة الطريق» التنموية التي نتكلّم عنها أعلاه لا ترتبط بأيديولوجيا محدّدة أو بموقفٍ من السوق والرأسمالية. في وسعك أن تنفذها في سياق اقتصادٍ مخطّط، أو بالاعتماد بالكامل على القطاع الخاص، أو على خليط من الاثنين؛ يمكنك أن تعتمد نموذج «الشركات الرائدة» التي تقود الاستثمار في قطاعاتها، كما في كوريا وتايوان، أو نموذج السوق التنافسي الشرس. هذا لا يهمّ. ولكن هناك عناصر مشتركة بين كلّ النماذج التي نجحت في التحديث والتصنيع، هي التي لا يمكن تجاهلها، ومنها أن التنمية لا تتحقّق بشكلٍ «عضوي» لوحدها، وأنّ الصناعات الوطنية تحتاج إلى حمايةٍ وتدرّج، وأنّ عليك التحكم في العلاقة مع السوق الخارجي، وفي عملتك واستهلاكك، لكي تخدم مهمتك التنموية.
التحديث والتصنيع، في المناسبة، لا يحصل عبر الإعلان، فجأةً، عن معملٍ للهيدروجين أو أشباه الموصلات في السعودية، بل هذه من علامات الدول التي تستبدل التنمية الحقيقية بمشاريع رمزيةٍ تنفع للعرض والدعاية. هناك كتابات اقتصادية وافرة عن ضرورة «التدرّج» في عملية التصنيع، وأن تكون محاولاتك جزءاً ضمن خطةٍ متكاملة، تسند عناصرها بعضها بعضاً، وليست عبارةً عن مشروعٍ مكلفٍ هنا وآخر هناك. في مجال التنمية، تُعقد على الدوام مقارنةٌ شهيرة بين نموذج التعاون الكوري مع اليابانيين في إنتاج الفولاذ في الستينيات، وبين تعاون الماليزيين معهم بعدها بعقود. الفكرة هي أنّ الكوريين استخدموا اليابانيين لكي يبدأوا «من الصفر» ويتعلّموا أساسيات الصناعة، ثم قاموا بالاستقلال والبناء على ما اكتسبوه والترقي تدريجياً حتى أصبحت صناعة الصلب لديهم أكبر منها في اليابان. أما في ماليزيا، فقد دخلوا مع اليابانيين في مشروعٍ مكلفٍ وطموح: إنتاج الصلب عبر تقنية عالية ومتخصصة. ولكن النتيجة كانت أن ماليزيا لم تطوّر صناعةً مستقلّة إلى اليوم، وظلت في حالة اعتمادية على اليابانيين في مجالٍ تكنولوجي دقيق من الصعب أن يلاحقوهم فيه. يشبّه اقتصادي أميركي هذا النمط من المشاريع «الطموحة» بأنها تشبه أن ترسل ولداً إلى الجامعة لكي ترى ماذا سوف يتعلّم.
وهذا ينطبق على الكيان الصناعي الأكبر في السعودية، «سابك» وصناعة البتروكيمياويات التي هي، في الحقيقة، أكبر هدرٍ تاريخي للثروة الوطنية، ومثالٌ على ما نقصده بكلفة التبعيّة وهو يستحقّ بعض الشرح. تقوم «سابك»، منذ أكثر من أربعين عاماً، بتحويل أكثر الغاز السعودي إلى منتجات بتروكيمياوية تذهب إلى السوق الخارجي (ولدى السعودية ثروة غازية معتبرة، أكثرها يأتي مصاحباً لإنتاج النفط). أيّ خبيرٍ في الطاقة سيشرح لك أنّه من البديهيات أنك لا تقوم بتصدير الغاز أو تحويله حتى تكون قد استخدمته إلى الحدّ الأقصى في اقتصادك الداخلي، وظلّ لديك منه بعدها فائضٌ كبير (هذا له أسباب سعرية تتعلق بطبيعة الغاز ونقله). لم تبدأ أميركا بالدخول في مجال تسييل الغاز وتصديره، أو تحويله إلى بتروكيمياويات، حتى سنوات قليلة ماضية، حين وصل إنتاجها من الغاز إلى مستويات تاريخية وقد استخدمته في الداخل إلى الحدّ الأقصى وبكلّ الوسائل الممكنة. تخيّلوا أن السعودية قد ظلت لعقودٍ تحرق مليون برميل نفطٍ أو أكثر، كلّ يومٍ، لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فيما هي تحوّل غازها إلى بلاستيك.
فلنشرح المسألة على النحو التالي: لو أنّك - حرفيّاً - لم تفعل شيئاً غير أن تغلق «سابك»، وتأخذ هذا الغاز وتحرقه في معامل الكهرباء بديلاً من السوائل، ثمّ تضع النفط الذي وفّرته على ناقلاتٍ وتبيعه في السوق، فسوف تحصل على عائدٍ يفوق (بكثير) أرباح «سابك» في أي سنة من تاريخها. بل حتى لو أنك حقنت هذا الغاز في باطن الأرض، في الحقول النفطية، فسوف تزيد إنتاجها بقدرٍ يفوق أرباح «سابك» أيضاً بكثير (وسوف تستعيد فوقها، في المستقبل، أكثر هذا الغاز). أنت هنا تستخدم الشمبانيا لكي تصنع بيرة. ولكن هل تعرفون من يحبّ «سابك» حقاً؟ الشركات الأجنبية الكبرى. ومعامل «سابك» غالبيتها شراكاتٌ مناصفة مع أجانب، وهم يتسابقون على هذه العقود فهي تعني لهم أرباحاً مضمونة بالمليارات - بفضل تصدير الغاز السعودي. لهذا السبب لن تجد شركةً مشهورة في مجال الطاقة، من «توتال» إلى «اكسون» وغيرها، إلا ولديها شراكةٌ في مصنعٍ مع «سابك». في إيران أيضاً لديهم صناعة بتروكيمياويات كبيرة، ولكنها تأتي - مع صناعة الصلب - في المرتبة الثالثة لتوريد الغاز بعد الاستهلاك المنزلي والكهرباء؛ والمصانع تبنيها شركاتٌ محليّة وبمكوّنات محلية إلى درجة بعيدة. غنيّ عن القول هنا إنّ المخططين في السعودية لم يفكّروا حتّى في إنشاء شبكة أنابيب تمدّ الغاز إلى المنازل والصناعات، مع أن غالبية الشعب يعيش في بضع مدنٍ كبيرة يكفي أن تغطيها حتى تؤمّن معظم الطلب الداخلي. نعود مجدداً إلى حقيقة أنّ دورك في النظام العالمي يحدّد كيف تنظر إلى ثروتك وكيف تستخدمها، وهل تفكّر - حين تجد لديك مورداً - في كيفية استثماره في الداخل، أم أن عقلك يذهب مباشرةً إلى التصدير؟
«رؤية» قصيرة الأمد
فهم محمّد بن سلمان المشكلة التي أمامه، وهي واضحة وبسيطة مفادها أن الريع النفطي لن يكفي لتمويل نظام التوزيع والدعم الاجتماعي كما كان في السابق. من هنا انطلق وليّ العهد في اتجاهين متناقضين، اتّجاهٌ «تقشّفي» يصبو إلى تخفيف الأعباء على الدولة من خدماتٍ وتوظيفٍ وغيرها من أشكال توزيع الدخل، واتجاهٌ «إنفاقي» يقوم على استثمار مبالغ خرافية في مشاريع مثل «يوم»، وشراء أصولٍ ضخمةٍ في الخارج، وصفقات سلاحٍ تليق بجيش دولةٍ كبرى. نبوءتي عن المستقبل هي تقريباً كالتالي: سيفهم وليّ العهد بسرعة أنّه لن يتمكّن من الاستمرار بالإنفاق على «رؤيته»، وأن العائد على الاستثمارات لن يغطي التكاليف، فيقوم بتقليصها عاجلاً أم آجلاً (أي استباقياً بإرادته أو مجبراً تحت ضغط الديون). البوادر واضحة. حتى في هذه السنوات، حيث الوتيرة القصوى للبناء في مشاريع ابن سلمان (حتى ارتفعت بسببها أسعار مواد البناء عالمياً) ظلّ النمو السعودي متواضعاً ومتذبذباً، فكيف سيصبح في المستقبل حين يتوقّف البناء أو تخفُت وتيرته؟ ولم تظهر بعد، رغم كل الدعاية، قطاعات جديدة مؤثرة خارج القطاع النفطي، أو مجالات أثبت البلد فيها مزايا تفاضلية. في الحقيقة، فإن سياسات ابن سلمان قد أدّت إلى تقليص أو محو عدد من نشاطات الدورة الاقتصادية (وبخاصة تلك التي تهمّ صغار المستثمرين، ولكن هذا موضوع مختلف).
تبقى لنا في هذه الحالة، منطقياً، سياسات التقشّف. ولأن الاقتصاد السعودي هنا سيظلّ بنيوياً وفي العمق على شكله الحالي فإن النتيجة، باعتقادي، هي أن المواطن السعودي سوف يهبط، تدريجياً، إلى مكان الوافد الذي يقبع حالياً تحته في السلّم الطبقي. بمعنى أنّه لو كان أبوك مهندساً، وجعله ذلك مديراً عاماً في الدولة في الماضي، فأنت ستكون مهندساً مشرفاً على ورشة. وإن كان والدك عنصراً في الحرس الوطني، فأنت سوف تقود تاكسي، إلخ. وسوف يكتشف أصحاب نظرية «النفط يولّد الكسل» كيف أنّ ابن سلمان سيجعل غالبية السعوديين «يعملون»، ولكنهم سوف يأخذون أدواراً ضمن الاقتصاد الاستهلاكي الحالي، وليس في نموذجٍ تنمويّ حديثٍ منتج. أمّا عن المفاعيل السياسية لهذه التحوّلات، فهي ممّا يستحيل (بالنسبة إليّ على الأقل) توقّعه أو الكلام فيه.
ما يحصل في السعودية اليوم هو في جانبٍ منه فشلٌ لعلم الاقتصاد. فكرة أنه من بين آلاف الاقتصاديين المدرّبين في مختلف المؤسسات السعودية، والمصرف المركزي ومراكز الدراسات، لا يخرج من ينظّر للاقتصاد السياسي في بلاده بشكلٍ شمولي وجذري. كما في الكثير من دول الأطراف، تعمل غالبية الاقتصاديين المحترفين على طريقة المحاسبين، فيما توكل المشاريع الكبرى والتخطيط لشركات الاستشارات ومخيّلة الأمير. ولكنّ المسألة هنا، كما نعلم، ليست «تقنيّة» إلا بالمعنى السطحي. على حدّ قول الاقتصادي الأميركي مايكل بيتيس، حتى حين تكون هناك «حلول» واضحة أمامك، والمؤشرات تدلّ على نوع التغيير الذي ينبغي اتباعه، فإنّ الدول في الكثير من الحالات لا تسلك هذا الطريق، والسبب هو دوماً سياسي. «سياسي» بمعنى أنّ هناك علاقة اجتماعية تقبع خلف كلّ توزيعٍ للثروة، وكلّ نمط تنمية، وأي نظامٍ اقتصادي. هناك أناسٌ يحصّلون عائداتٍ وأرباحاً بفضل هذا النظام، وتغييره يعني تغيير قنوات الدخل هذه، وهنا تكمن الصعوبة الحقيقية. ماذا تفعل إذاً لو كانت كامل البنية الاقتصادية لديك، وكلّ من يستفيد منها في الداخل والخارج، قد صُمّمت لخدمة التبعية؟
خاتمة: ملاحظة عن مسألة التعليم
لديّ هنا هامشٌ لا بدّ أن أفتحه عن مفهوم التعليم العالي في دول الأطراف. من الأساسي أن نتذكّر أنّ النهضة الكبرى للجامعات في أميركا مثلاً، وتمويل الدولة لهذه المؤسسات البحثية، لم يكن بهدف تخريج طلابٍ وطباعة شهادات في الأدب الإنكليزي، بل لأهدافٍ «عملية» وإستراتيجية. أي لكي تخترع هذه المختبرات القنبلة النووية والكمبيوتر والإنترنت. بمعنى أنّ ضرورات الدولة والاقتصاد استلزمت بناء قاعدةٍ علميّة متفوقة (من المعروف أنّ ميزانية أيّ قسمٍ في العلوم الاجتماعية والآداب في أميركا هي عبارة عن «فراطة»، وملاليم، أمام أصغر مشروعٍ بحثيّ تجريه الأقسام العلمية كالهندسة والكمبيوتر والطب). وفي اليابان وكوريا والصين، بالمثل، كانت الجامعات بمثابة الأداة لاستيعاب التقنيات الحديثة من الخارج، وإجراء الأبحاث التي يحتاجها الاقتصاد والجيش في مرحلة التحديث. حتّى الطلاب الذين تخرّجهم الجامعة يفترض بهم أن يخدموا مشروعك التنموي الذي، في غيابه، ستحصل على عددٍ هائل من خريجي العلوم السياسية.
دعوني أشرح: حين درست العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية ببيروت في أواخر التسعينيات، كان القسم صغيراً جداً وهامشياً، لا يتعدّى عدد الطلاب القادمين إليه في كلّ سنةٍ العشرات - أكثرهم قد ضلّ طريقه إليه لسببٍ ما، وأكثرهم سيترك بعد السنة الأولى. كنّا بمثابة «زائدة دودية» في جنب كلية الحقوق الكبيرة، وكان البعض في الكلية يتساءل أحياناً بصوتٍ عالٍ - وأمامنا - عن جدوى وجود قسم العلوم السياسية من الأساس. وهذا، للأمانة، لم يكن تجنيّاً بالكامل. «ماذا، بحقّ السماء، سوف تفعل بشهادة علوم سياسية؟» كما كان يقول أستاذنا الراحل جان سالم. تخيّلوا أنني اكتشفت أنّه في السنوات الماضية، وبخاصة بعد 2005، أصبحت جحافل من الطلاب اللبنانيين تختار هذا الاختصاص تحديداً. أعدادٌ مهولة تلقاها في كلّ مكان تقول لك إنها تدرس السياسة والعلاقات الدولية. في أميركا، مثلاً، الطلاب يختارون هذا الاختصاص بكثرة لأسبابٍ منطقية وعملية. من ناحية، فالكثير منهم يخطط لدخول مدرسة الحقوق أو البزنس بعد الشهادة، ليصنعوا بعدها الكثير من المال، والعلوم السياسية مدخل مثالي لهذا النمط من الدراسات العليا. كما أنّ أميركا، بعد كلّ شيء، لديها إمبراطورية لكي تديرها، وهي تحتاج إلى اختصاصيين في كل مناطق العالم ولغاته، وإلى جيشٍ من الديبلوماسيين والخبراء والجواسيس. أما في بلدٍ كلبنان، فلماذا عندنا كلّ هؤلاء المختصين في أوراسيا وأميركا اللاتينية؟ بماذا فكّرتم جميعاً قبل أن تلتحقوا؟ رجاءً لا تقل لي إنّك تتبع الفضول والهواية في اختيار اختصاصك ومستقبلك. هل لديكم أي نوعٍ من التوجيه المهني؟ (نحن لم يكن لدينا).
الفكرة هي أنّه في بلادنا، حيث لا يتشابك نظام التعليم مع نموذج إنتاجي ومع حاجاتك الوطنية الفعلية، فأنت سوف تحصل على صنفين من المتعلّمين: عددٌ كبيرٌ من الناس الذين يمتلكون شهادات عليا، ولكن من غير مهارات حقيقية يحتاجها السوق؛ وعددٌ مماثل في الاختصاصات التي عليها طلبٌ للعمل في الخارج أو للهجرة، كالهندسة والأعمال. أنت في الحالتين إمّا يتمّ إعدادك للعمل في الخليج والغرب، أو ستجد نفسك وسط اقتصادٍ غير منتج لا حاجة فيه إلى الشهادة، ولا يقوم توزيع الدخل على اكتساب الخبرة والمهارة - ولكنك ستكون قادراً على الحديث بطلاقة عن العلاقات الروسية-الصينيّة.
* كاتب من أسرة «الأخبار»


![سلسلة الاقتصاد والسياسة [9]: السعودية وثمن التبعيّة](https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/2024630212254692638553793746929800.png)