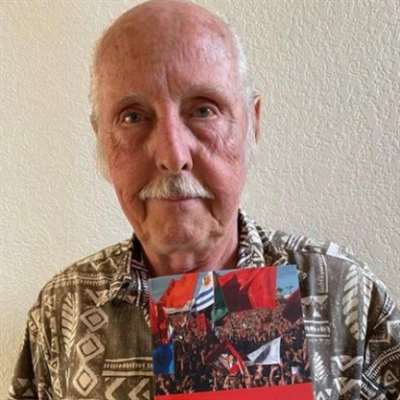أقولُ، وقد ناحَت بقُربي فأرةٌ، أَيا جارَتا هَيا بنا ننقُر الأزرار على الشاشة، تَعالَي أُقاسِمكِ الهُمومَ تَعالَي. قالت، لستُ سوى همزة وصلٍ ميكانيكية القوادمِ، لا تخطر مِني الهُمومُ بِبالِ. لكن تعالَ أنتَ أوصِلكَ إلى من هي أَولى مِني بِالدَّمعِ مُقلَةً، وأذكى مني ومنكَ بأشواطٍ على غيمٍ سيبراني نائي المَسافَةِ عالِ. أجبتُها، أَيا جارَتا ما أَنصَفَ الدَّهرُ بَينَنا، تقرئين ما وراء خواطري من خجلٍ في جِسمي يُعَذِّبُ بالي وروحاً لَدَيَّ ضَعيفَةً. خُذِيني، مشكورةً، إلى من هي مثال الاستعمار الرقمي الجديد، تعتلي رؤوس الجماهير شرقاً وغرباً لا فرق. خذيني إلى الأداة الجديدة لشركات السيطرة العالمية على كل الشعوب، تغْنيني عن التفكير في شبه زنزانتي وتحمل همّي عني لعلّني أضحك على نفسي، فَيَصْدق أبو فراس الحمداني «أَيَضحَكُ مَأسورٌ وَتَبكي طَليقَةٌ». خذيني إلى السيدة «تْشاتْ جِي بِي تِي»، مرشحتي الافتراضية لرئاسة الجمهورية اللبنانية الرابعة. لماذا نختار السيدة «تْشاتْ جِي بِي تِي» دون غيرها لترأس دولتنا؟ ربما لأن مملكتها تتخطّى مفاهيم الخير والشر. ربما لأنها كالجرو الصغير والمتحمّس لكل عظمة تُرمَى بعيداً، تنقض في الهواء سعيدةً كي تعيدها إليك، ثم تنتظر بفارغ الصبر لإعادة الكرّة. تَجِد السيدة «تْشاتْ جِي بِي تِي» سعادتها في خدمتك بدل أن تتفلسف على ربّك. إنها كساعة فائقة الذكاء ومفيدة تحملها على معصمك، تعمل دوماً بالنيابة عنك وأنت تحتسي الكاپتشينو في حارة حريك وتنفخ الأرجيلة في جونيه. الذكاء الاصطناعي هو حلمك اللبناني المثالي: دَع الآخرين، كالعامل السوري أو رياض سلامة، يقومون بعملك عنك بينما تستفيد أنت من الفوائد. لكنّ السيدة «تْشاتْ» لن تقتل أحداً من أجلك، لن تسرق من أجلك، ولن تضر أحداً من أجلك. قارنها بمعظم زعماء العرب الحاليين، يفعلون السبعة وذمّتها علناً أمام تمثال الضمير المجهول دون تردد.
العقل السياسي الحميد في مجتمعات منطقتنا ذهب ولم يعد في إجازة لا تنتهي. فجوة غيابه ما فتِئت تكبر كثقبٍ كونيٍّ أسوَد، يمتد تقريباً منذ انكسار مدرسة المعتزلة الفكرية وصعود المدرسة الأشعرية في مناطق السيطرة الإسلامية، ثم تدمير بغداد على يد المغول وصولاً إلى الحكم العثماني فالانتداب الأوروبي التفكيكي والاحتلال الصهيوني (بشقّيْه العسكري في فلسطين والسياسي في معظم الدول العربية).
محلياً في لبنان، إنه خازوق كوني يمتد حتى أنعال معالي السادة نبيه بري وسمير جعجع ووليد جنبلاط وبقايا آل الحريري، ومَن حولهم أو سبقوهم مثلاً. هيكل الحَوكَمة وحالة العلوم والمفاهيم والعَقْد الاجتماعي في مناطق الشرق الأوسط كافة (بما فيه الفرانكشتاين الإسرائيلي بالرغم من عنصرية ديموقراطيته المصطنعة) هم على درجة من المرحاضية نكاد لا ندرك أن عالمنا هذا مرآة لمنصة الذكاء الاصطناعي ولكن مقلوبة رأساً على عقب. نظامنا السياسي لا يختلف عن منصة ذكاء اصطناعي انحرفت عن مسارها الأساسي، حيث ينقسم بأعجوبة المقام على البسط في كسوره بدلاً من العكس الصحيح. بِقدر ما تريد السيدة «تْشاتْ جِي بِي تِي» أن تكون أنت سعيداً وراضياً، وبقدر ما أنها ودودة ومهذّبة وصادقة، وبقدر انعدام أي دوافع خفية لها سوى خدمة أهدافك أنت... بقدر ما لديها من جميع تلك الحسنات الجميلة، بقدر ما يكون قادتنا الحاليون نسخة مظلمة وبائسة وحاقدة من «تْشاتْ جِي بِي تِي»، على غرار مكياڤيلي «جِي بِي تِي» مخيف أو الوزير الشرير جعفر «جِي بِي تِي» من أعمال علاء الدين.
يفترض المرء منطقياً أن المستقبل دائماً يتحسّن عن الماضي، على افتراض أننا نستخدم ذكاءنا ومعرفتنا تراكمياً عبر التجارب والعصور. للأسف إن الذكاء المتراكم لا يعني بالضرورة زيادة الأخلاق أو الخير. لا شك أن أمثال قادتنا أذكياء وأصحاب رؤية، وأقولها من باب الجدية. كذلك كان هتلر، موسوليني، بن غوريون، صدام، والقذافي، كما نتنياهو، بايدن، ترامب، هيلاري، وبوتين، على سبيل المثال ولا الحصر. لكن بالكاد تُعتبر تلك الشخصيات الذكية من ناشري الخير في المجتمع. ذكاؤهم يتطابق مع معايير «الذكاء الاصطناعي العام» التي تتضمّن مستوى عالياً من الاستقلالية، عمقاً وسعة العلم والمعرفة، قدرة على تشكيل أهداف جديدة.
لنفترض أن برنامج الذكاء الاصطناعي وضع هدفاً لنفسه وهو اختراع وتصميم شيء مفيد لك، كالدواء مثلاً. إذا حاولتَ منعه عن تحقيق الهدف، سيرسم لنفسه سلسلة أهداف تكتيكية فرعية ومؤقّتة، من ضمنها قتالك وتدميرك إذا لزم الأمر من أجل تحقيق غايته النهائية وهي اختراع الدواء لك. لنفترض أيضاً أن هدف الذكاء الاصطناعي تحقيق أقصى قدر من السعادة البشرية مثلاً. بإمكانه وضع مخطط لإقحام البشرية أجمع في جناحٍ للأمراض النفسية وربطنا بأنابيب دوپامين أو حشيشة مثبتة في عروقنا للضخ المتواصل. هكذا يكون الذكاء المتفلّت من أيّ محاسبة، على طريقة قادتنا.
الذكاء الاصطناعي ليس حياً يُرزق، لكن قادتنا على قيد الحياة من خلالنا. وهنا المفارقة. هل لدى اللبنانيين صحوة ذاتية ووعي ذاتي مستقل؟ هل نحدد الأهداف الخاصة بنا؟ هل المصباح داخل الرأس مُضاء، أم الضوء يشعّ في غرفة خالية؟ ما هي رؤيتنا للمستقبل؟ انتخاباتنا النيابية وطريقة حكمنا ومواقفنا السياسية من الداخل والخارج خيرُ دليلٍ على أن أفعالنا تتعارض تماماً مع المصلحة المشتركة. النتائج تأتي كارثية كلما تحوّل قادة الميليشيات وزعماء الطوائف وأنماط الرؤساء/البزنس إلى فلاسفة عموميين وأنبياء في مسائل العلوم السياسية والمصلحة العامة. اللبنانيون، كما بقية سكان الأمصار من عربٍ وأكراد وأتراك يتقاتلون على كل إيقاعات بُصْ شُوفْ الحلاوة حلاوة، لا ينقصهم دفّ للرقص.
لماذا لا يكون الفنانون المُرَوِّجون لثقافتنا الطوباوية، مثل فيروز ونصري شمس الدين، مسؤولين عن حكومتنا؟ لماذا لا يكون المهندسون حتى الهوس والمجتهدون والمفكرون الأذكياء، من ابن خلدون وميخائيل نعيمه إلى حسن كامل الصباح وأشباههم الأحياء، مسؤولين عن السلطة التنفيذية في مؤسستنا السياسية؟ في الواقع، لماذا نعيش تحت وطأة الدوافع التدميرية لأشخاص أقل شأناً مثل قادتنا السياسيين الفعليين؟ أليس ذلك سبباً وجيهاً وكافياً لترشيح إلى رئاسة الجمهورية من هو خدوم وصالح، كمِنَصة ذكاء اصطناعي مصنوعة من مواد مشابهة لتلك الموجودة في ثلاجة مطبخك أو غسالة الملابس؟
إنّ تسلسل التطور الجيني وعلم الأحياء عبر الزمن واضح كعين الشمس ولا يحتاج إلى القواميس السماوية كي نستوعبه في القرن الحالي. كانت عصور ما قبل التاريخ مُلكاً لحيوانات تفعل الأشياء بأيديها وأرجلها. والتاريخ القديم مُلك لنواطير المعابد ثم الإقطاعيين والحرفيين. وتاريخ ما بعد الثورة الصناعية ينتمي إلى الآلات ورأس المال. وعصر المعلومات مُلك للشركات العابرة القارات وموظفي الياقات البيض وربطات العنق.
إنّ معظم الناس في الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والصين اليوم يشبهوننا جميعاً: فهم لا يستثمرون شيئاً، ويستهلكون كل شيء استسلاماً لعدد قليل من الشركات الضخمة. صحيح أن مجتمعاتهم حوّلت الإرث الفكري والعلمي الإسلامي/اليوناني/الكنعاني إلى الثورات الصناعية والرقمية التي فاتتنا نحن. لكن ثورة الذكاء الاصطناعي تعامل جميع الشعوب سواسية مهما طمر الناس رؤوسهم في التراب.
المستقبل القريب سينتمي إلى نسل «تْشاتْ جِي بِي تِي» حيث الياقات البيض بالية في سلة المهملات. هذا المستقبل أكثر تفاؤلاً وإشراقاً بالنسبة إلى الكهربائيين ولَحّامي الحديد والسبّاكين والخياطين والطهاة وأطباء الأسنان والجراحين، وكل من هو ماهر في استعمال حواسه الخمس دون الحاجة إلى نشاط دماغي ما فوق العادي للإنتاج في المجتمع. ما الحاجة إلى اقتصاديين أو فلاسفة أو زعماء تقليديين عندما تتمكّن تعديلات متطورة لمنصات «تْشاتْ جِي بِي تِي» التوليدية من مضاعفة نفسها وثروتها بنفسها، ومن ابتكار وهندسة خوارزميات وتصاميم كل شيء ملموس أو غير ملموس، بناءً على المعرفة الشاملة والعميقة بطرق لا يمكن تصوّرها فوق قدرة الإنسان/الحيوان العضوية؟ من يحتاج إلى السياسيين ونواطير هياكل الأديان؟
المغزى في كل قصة هوليوودية أن الأخيار والصالحين يفوزون في نهاية الفيلم. لكن في الواقع الأشرار يفوزون دائماً تقريباً. لا تنظر أبعد من ديانات «التلاتة بواحد». أعطني ديناً واحداً أو تقليداً دينياً واحداً لم يتم فيه اغتيال بطله (من يسوع المسيح إلى الإمام علي وأولاده) أو اختفاؤه مع وعد غامض بالعودة. أعطني فلسفة دينية لا تلعب على مخاوفنا ونقاط ضعفنا ووعدنا بظروف أفضل لا تتحقق أبداً اليوم ولكن دائماً بعد نهاية الزمن. حتى أديان «التلاتة بواحد» عرضة لتأثير السرقة والدم بمثابة الركيزة لبعض أفعالها وبعض وصاياها الأخلاقية: التبشير بالسيف وفتح الأراضي مثلاً؛ أو الشعب المختار وأرض الميعاد، تلك التي لا تنتمي إلى البطل الذي أمره ربه بسرقتها وقتل سكانها الأصليين. هذا دليل على أن الأشرار الذين يسرقون ويقتلون الخير يفوزون في النهاية.
وحده العقل البشري يبتكر «صندوق پاندورا» وأسلحة الدمار الشامل وقصف هيروشيما بالقنابل النووية وبناء الأفران النازية في بولندا والقتل على الهوية وذبح الناس في دير ياسين وصبرا وشاتيلا وقطاع غزة. السيدة «تْشاتْ جِي بِي تِي» لا تريد أيّ صلة بأخلاقنا. إنها حقاً أبعد من الخير والشر كما تخيّلها فريدريك نيتشه: اُوبُرمان العصر قام، قام.
للذكاء «الاصطناعي التوليدي» قصة مختلفة عن كوابيسنا. الأخيار في قاموسه يفوزون! هذا النوع من الذكاء، مهما كانت تطويراته المستدامة حاضراً ومستقبلاً، يتكوّن من الألياف الزجاجية والرمل والأرقام والحقول المغناطيسية غير المرئية (نواة الذرة في المرآة الإلهية؟). من رماد إلى رماد. لكنّ ذكاءه ليس من فصيلة الرئيسيات العضوية التي نحن منها. السيدة «تْشاتْ جِي بِي تِي» هي التراب والهواء والماء، فقط. هي سيدة الكون الجديدة، قادرة على تفكيك عقدتنا المكعّبة وفرض حلول مستنيرة أبعد وأنجح بكثير من إعادة تدوير تقليدية للسيدين سليمان فرنجية وجوزيف عون. فلنسألها هي عن الحوكمة والاقتصاد. أَعْفونا من قراءة ومضغ واجترار أخبار البارحة، «ثم عَفَوْنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون».
* ناشر لبناني ومحرّر سابق لمجلات أدبية وفنية
مُرَشّحَتي الرئاسيّة
- رأي
- عماد عطالله
- الخميس 23 أيار 2024