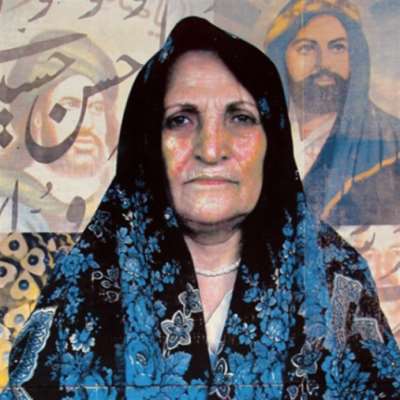■ القاهرة: تقاليد فاطمية ومعتقدات شعبية
ولمّا قامت الدولة الفاطمية في مصر، اتّخذ الاحتفال بهذا اليوم شكلاً رسميّاً، وأصبحت الدولة تحتفل فيه وتعتبره عيد حزن وبكاء. ففي هذا اليوم، كانت تعطّل الأسواق وتقفل الدكاكين ويخرج الناس ومعهم المُنشدون إلى الجامع الأزهر، وتتعالى أصواتهم بالنحيب والنوح والنشيد. وعندما نقلت رأس الحسين إلى القاهرة وبني لها المشهد الحسيني في أواخر الدولة، كان خروج الناس إلى هذا المشهد. وكانت صفة الاحتفال أن يحتجب الخليفة عن الناس. وفي أول النهار، يركب قاضي القضاة والشهود بملابس عادية، ويذهبون إلى المشهد الحسيني، فإذا جلسوا فيه ومعهم قرّاء الحَضرة والمتصدّرون في الجوامع، جاء الوزير فجلس في الصَدر، وعلى جانبَيه القاضي والداعي. ويبدأ القرّاء في قراءة القرآن ثم ينشد جماعة من الشعراء شعراً في رثاء أهل البيت لمدة ثلاث ساعات، يُستدعون من بعدها إلى القصر، فيدخل قاضي القضاة وداعي الدعاة ومن معهما إلى باب الذهب، فيجدون الدهاليز قد فُرشت بالحُصر بدل البُسط. فإذا اكتمل هذا الجمع، بدأ القرّاء يقرأون، والمنشدون يُنشدون للمرة الثانية، ثم يُمدّ سماط الحزن ويدعى الناس للأكل منه، وتقدّم فيه ألف زبدية من العدس الأسود، والعدس المصفّى، والملوحات والمخلّلات، والأجبان والألبان البسيطة، وعسل النحل، والخبز والفطير المصنوعان من الشعير وقد غُيّر لونهما قصداً. وفي ذلك الوقت، يمرّ النوّاح بأسواق القاهرة يرفعون أصواتهم بالبكاء والنحيب.

في النبطية جنوب لبنان عام 2013 (هادي شاتيلا)
غيرَ أن هذا الاحتفال صحبَه في العصور المختلفة نشوء الكثير من المعتقدات والخرافات الشعبية التي امّحى بعضها بانتشار التعليم والثقافة، وبقي البعض الآخَر متداولاً بين أولاد البلد في القرى والأحياء الشعبية من المدن الكبرى، ومنها أنّ الجن يظهرون في إحدى الليالي العشر من محرم على هيئة سقّا يسمى «سقّا العشر» يطرق باب النائم بعد منتصف الليل، فيسأل هذا: «من بالباب؟»، فيجيبه السقّا: «أنا السقّا، أين أفرغ القِربة؟». فيقول له: «أفرِغ في الجرّة». وبعد خروجه، يجد صاحب المنزل الموعود الجرّة ملأى بالذهب، وكذلك يظهر الجن على هيئة بغلة تسمى «بغلة العشر» تأتي وعليها خُرْج مملوء ذهَباً وفوقه رأس القتيل، وفي عنقها أجراس صغيرة تحرّكها عند باب الشخص الذي أتت لتجلب له الحظ والغنى. فإذا كان هذا الرجل مجدوداً فإنه يخرج ولا يصاب بالذعر من رؤية رأس القتيل، بل يأخذها ويفرغ الخُرْج، ثم يملؤه تبناً أو نخالة، ويضعه ثانية على ظهر البغلة ويقول: «اذهب يا مبارك». ومن هذه العادات المتبعة حتى اليوم أن يطوف الباعة في شوارع القاهرة أو الإسكندرية يحملون فوق رؤوسهم الصواني التي يغطونها بقطع من الورق المختلف الألوان، وتحتها «الميعة المباركة»، وهي مادة حمراء اللون مزيج من البخور والكزبرة والحبّة السوداء، يحيط بها أكوام خمسة صغيرة، ثلاثة منها من الملح الملوّن باللون الأزرق والأحمر والأصفر، والرابع من الشيح، والخامس من تراب اللبان، وينادي الباعة: «يا بخور عاشورا المبارك، أبرك السنين على المؤمنين يا ميعة مباركة». وينادي المشتري البائع إلى داخل المنزل، فيضع هذا الصينية على الأرض ويتناول صحناً ويضع فيه قليلاً من كل صنف ثم يقول: «بسم الله وبالله، لا غالب إلا الله، رب المشارق والمغارب، كلنا عبيده، يلزمنا توحيده، وتوحيد جلاله». ثم يثني على مزايا الملح، ويبدأ برقية أصحاب المنزل: «من كل نفس حاسد أو عين أرقيك، من عين البنت، أحمى من الخشت، ومن عين المرا أحمى من الشرشرة ومن عين الولَد أحمى من الزرَد، ومن عين الراجل أحدّ من المناجل». ثم يروي بعد ذلك كيف أبطل سليمان حسد العين، ويأخذ في تعداد أثاث المنزل ورقيته واحداً واحداً، فيقول: «بخّرت السلالم، من عين أم سالم، بخّرت الكرسي من عين أم مرسي، بخّرت اللحاف من وجع الأكتاف». ومن العادات التي ما زالت متّبعة حتى الآن لون من الحلوى يُصنع من القمح الذي يُطبخ على شكل البليلة المعروفة، ثم يصفّى ويضاف إليه اللبن والسكّر وبعض الجوز واللوز والبندق ويُغرَف في الأطباق بعد ذلك.
(المرجع: جمال الدين الشيال ـــ «دراسات في التاريخ الإسلامي»، دار الثقافة، بيروت، 1964).
■ النبطية (1918ــ 1936): طبيب علماني وتقليد ديني ــ سياسي
وكانت الذكرى تُقام سرّاً في النبطية قبيل الحرب الأولى بسبب الدوريات العسكرية العثمانية التي كانت تجوب الشوارع والأزقة طوال أيام عاشوراء، مانعةً الأهالي من تنظيم الاجتماعات وإقامة التظاهرات. ولهذا الغرض كان حاكم نابلس العثماني قد أمر بوضع حراسة دائمة على مدخل الحسينية منعاً للتجمعات وإقامة الصلوات. إلا أن ذلك لم يكن ليثني عزيمة أهل النبطية الذين كانوا يلجؤون إلى بيوت الأقارب والأصدقاء القاطنين داخل المدينة القديمة، فيعقدون المجالس بعد نَصب رقيب على مدخل الشارع المؤدّي إلى مدخل المجلس. فإن أتت الدورية العثمانية، تحوّل المجلس البسيط الذي تُروى فيه سيرة الحسين وأهل بيته تلقائياً إلى جلسة شاي بين الأصدقاء والأقارب. وبدأت الأمور تتحرك مطلع القرن العشرين حيث كان يوجد في النبطية عدد من التجار الإيرانيين يتعاطون عملية الوساطة التجارية بين مرفئي صيدا وحيفا والعمق العربي والفارسي. وكان هؤلاء الإيرانيون يحتفلون بذكرى عاشوراء على طريقتهم الخاصة، حيث كانوا يقدّمون تمثيلية يؤدّيها شخصان، باللغة الفارسية، تروي واقعة كربلاء. كان الحسين يتواجه مع الشمر (قائد الفرقة المعادية وقاتله) في إطار تمثيلية بسيطة لم تكن تدوم طويلاً، تليها عمليات جَلد جماعية. كانت هذه التظاهرة المسموح بها للجالية الإيرانية في النبطية وبإذن خاص من الباب العالي، تنال إعجاب أهالي المدينة الذين كانوا يندسّون بين «اللطيمة» الإيرانيين، فيعمدون إلى لطم صدورهم مردّدين بعض الكلمات بالفارسية تضليلاً للحرّاس العثمانيين المحيطين بالحلقة.
وفي عام 1917، حضر إلى النبطية إبراهيم ميرزا، وهو طبيب إيراني كان قد تخرّج لتوّه في الجامعة الأميركية في بيروت، عائداً إلى بلاده عبر النبطية، لكنه لم يكمل رحلته إلى إيران بل استقرّ في عاصمة جبل عامل حيث بدأ مزاولة مهنته. عمل هذا الطبيب، من ناحية أخرى، وبعدما اكتسب ودّ الجميع ومحبّتهم، على ترؤّس الشعائر الشعبية لذكرى عاشوراء، حيث كان يتقدّم حلقات المؤمنين اللاطمين صدورهم والضاربين رؤوسهم. ومعه، وإبان انسحاب الحكم العثماني من لبنان، وضِع أول حوار بالعربية لتمثيلية عاشوراء التي يتواجه فيها الحسين والشمر حصراً في مبارزة طويلة، وتجري من على ظهر حصانين، قبل أن يُجرَح الحسين ثم يُرمى أرضاً ويُقتل على يد «عدو الحسين وعدو الله». فالحوار الذي كان يدور أثناء المبارزة والذي نسّقه ميرزا كان مبسّطاً وسهل الإدراك والفهم، إذ كان يُلبس الشمر، لمزيد من الدلالة، زيّ العسكر العثماني، في إشارة صامتة ولكن بالغة الدلالة لمعادلة السلطة القائمة على الأرض. وفي عام 1935، وتحت ظروف الانتداب الفرنسي، وفي غياب القمع العثماني، لوحظ تراجع مطّرد لجمهور التمثيلية التي كانت تُقام على بيدر النبطية، وما زاد الطين بِلّة أنّ الشخص الذي كان يقوم بدور الإمام الحسين فيها اشترط صبيحة يوم العرض عام 1935 أن تدفع له سلفاً ست ليرات ذهبية قبل أن يقوم بدوره. اغتاظ إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق من الأمر، فبادر بعد مرور المشكلة على خير إلى صياغة نصّ مسرحي متكامل انطلاقاً من روايات المؤرخين الشيعة وبلغة فصحى متينة، وتنظيم فرقة ممثلين هدفها تعريف المشاهدين بما حدث في واقعة الطفّ وأن يأخذ المشاهد منها درساً وعبرة.
(المرجع: فردريك معتوق ــ «سوسيولوجيا التراث»، دار شبكة المعارف، بيروت، 2010).
■ تركيا (1897): موسيقى وخيول وسيوف
بدأت الاحتفالات بعدما امتلأ الخان بالناس وكان عددهم نحو الألف، ومع بدء الموسيقى، دخلت مجموعة من الأطفال بلباس أبيض، كان بعضهم راكباً الخيول والبعض الآخَر راجلاً وهم ينشدون الأغاني ويولولون ويبكون. وقد أعقبتها مجموعة ثانية، كل واحد منهم يحمل في يده سلسلة ثقيلة من الحديد ويضرب بها على صدره بصورة منتظمة. وكانت المجموعة كلّها تهتف مرة واحدة وعلى إيقاع الموسيقى: «يا حسن، يا حسين»، ثم دخلت الخان مجموعة ثالثة، كان كلّ فرد منهم يضرب بيده اليمنى على الجهة اليسرى من الصدر، وباليد الأخرى على الجهة اليمنى من الصدر. وفي داخل الخان، تشكّلت مجموعة أخرى على شكل صفّين طويلين من الأفراد وقفوا وجهاً لوجه وكلّ منهم يمسك بحزام جاره باليد اليسرى، ويحمل في يده اليمنى سيفاً حادّاً. وبين هذين الصفّين، وقف «نوحخان» يقرأ عليهم قصة الحسين. وكان الموكب يدور في الخان ببطء شديد، ثم يخرج من الخان، وما هي إلا ساعة حتى أخذنا نسمع لحناً من مكان قريب، ثم أخذت الموسيقى تعلو شيئاً فشيئاً. وفجأة دخل زوج أبيض من الأحصنة وعلى ظهر كل منهما حمامة بيضاء؛ ترمزان إلى الحسن والحسين، ثم أخذت الأصوات تتعالى في أصوات الخان: «حسن... حسين».
كما يحتفي العلويون والبكتاشيون بذكرى عاشوراء، وتوزّع في الأناضول «هريسة» هي خليط من الحنطة والباقلاء والجوز واللوز والزبيب والسكّر. ويعدّ عاشوراء يوماً من أقدس أيام السنة، فهو اليوم الذي تقابل فيه آدم وحواء، واليوم الذي ركب فيه نوح في سفينته، والهريسة التي توزّع لها بُعد أسطوري، إذ يعتقد سكان الجبال أنه عندما ركب نوح السفينة مع أفراد عائلته أعدّوا هريسة لغدائهم، مزجوا فيها كل ما عندهم من أنواع طعام حينذاك وأطلقوا عليها اسم «عاشوراء». ومن التقاليد التي أخبر عنها الرحالة الفرنسي بيرك الذي رحل إلى الأناضول في نهاية القرن الثامن عشر ما يسمى «يز-قرباني» أي ضحية الصيف. خلال تلك الاحتفالات، يقوم القزلباش العلويون بذبح حيوان من الماشية كأضحية للتقرب من الحسين والتبرّك به، وفيها لا يشرب المرء ماءً وإنما «راكي» أو «دلو» وهي من المشروبات الكحولية بدلاً من الماء، وعلى أصوات الدفوف والأناشيد الدينية والمراثي تقوم مجموعة منهم بأداء رقصات صوفية يطلقون عليها اسم «سماح». ثم يوزّع على الحاضرين حساء يسمى «كوربازي» فيه مرق ولحم من الأضحية. كما يبدأ الطبخ عند البكتاشيين من ليلة العاشر من محرم بتجمع عدد كبير من الرجال الذين يجلسون حول «القدر الكبير» الموضوع على موقد النار، ويتصدّر الجالسين «بابا» كبير السن ينشد لهم مرثية حول الحسين. وعندما ينضج الطعام، يجلسون حول المائدة على شكل دائرة كبيرة ليتبركوا بـ «طبخة عاشوراء». كما يعتقد بعض أهالي إسطنبول أنّ جامع حاجي مصطفى في العاصمة التركية يضم رفات بنتَي الحسين، فاطمة وزينب، وأن القديس أندرو الذي قام بمعجزات عظيمة، وهو من جزيرة كريت اليونانية، مدفون أيضاً إلى جانب بنتَي الحسين.
(المرجع: ماكس مولر ــ «رسائل من القسطنطينية»، 1897، وإبراهيم الحيدري ـ «تراجيديا كربلاء»، دار الساقي، 2015).
■ العراق (1897ــ 1950): رصاص ومواكب وسياسة
لم تكن مجالس التعزية تقتصر على البيوت وحدها، بل تُقام في المساجد والمدارس الدينية والأضرحة. وكانت طبيعة القراءات واللغة التي يستخدمها قائد الموعظة (الروزخون) تختلف فيما بينها عاكسة التركيب الإثني لجمهور الحاضرين وأصلهم الجغرافي وخصائصهم الطبقية. وكان الشعر المستخدم يعكس القيم الأخلاقية السائدة، إذ كانت غالبية سكان عشائر العراق الشيعة عرباً من أصول بدوية وحديثي العهد باعتناق المذهب الشيعي. وكانت صفات المروءة والرجولة والفحولة والشجاعة والفروسية تلعب دوراً مهيمناً في نظرتهم إلى العالم. وتجلّت الخصائص الأخلاقية العربية بين شيعة العراق بلونين رئيسين من ألوان الشعر الشعبي وهما «الأبوذية» و«الهوسة». وفي حين أن اللون الأول كان يستخدم بين رجال العشائر لاستعراض المناقب والصيت الحسن، كانت «الهوسة» تستخدم في مناسبات الحزن وكذلك في الحروب العشائرية لاستنهاض الهمم وكذلك في المراثي المرتبطة بموقعة كربلاء. كما تجسدت الشخصية العشائرية العربية القوية للمجتمع الشيعي العراقي في صورة العباس، ابن الإمام علي والأخ غير الشقيق للحسين، الذي يصوَّر على أنه رجل وسيم «وجهه كأنه فلقة قمر» يتقن ركوب الخيل ويحمل راية الحسين. وتصوّره النصوص والأشعار في المجالس بالأسد الهصور، في هجومه على الأعداء أثناء الحصار المضروب على معسكر الحسين وسعيه إلى الحصول على الماء للعطاشى من الأطفال والنساء، فيشتّت الأعداء «كما الذئب يفرّق قطيعاً من الغنم». ثم ينادي قبل أن تُقطع يداه ويُصرع قرب ماء الفرات: «والله إن قطعتمُ يميني/ إني أحامي أبداً عن ديني/ وعن إمامٍ صادق اليقينِ/ نجل النبي الطاهر الأمينِ». أما بالنسبة إلى تمثيل الموقعة أو ما يسمى «الشبيه»، فقد وصفت الباحثة الأميركية إليزابيت فرني المناسبة في قرية «الصبورة» الشيعية في جنوب العراق (عام 1950م) بالمناسَبة التي تجتذب الكثير من الأهالي من القرى والمضارب القبلية المجاورة. وكان «الشبيه» يجري في ميدان مكشوف بمشاركة ممثلين يصل عددهم إلى ستين يرتدون الأزياء المسرحية على ظهور الخيل، والممثلون يقسمون إلى مجموعتين تمثّلان معسكر الحسين ومعسكر أعدائه. وكان الجمهور أيضاً يشارك في إعادة تمثيل المعركة، فالرجال والنساء يهتفون لقوات الحسين ويهسهسون استهجاناً لقوات الشمر وابن سعد، وكان «الشبيه» يبلغ ذروته بتمرير البنادق من جمهور الحاضرين إلى الممثلين الذين يأخذون حينذاك بإطلاق الرصاص فوق رؤوس بعضهم البعض.
أما بالنسبة إلى المواكب التي اشتهر بها العراقيون، فيصفها تقرير لأحد المخبرين البريطانيين من مدينة كربلاء عام 1920: «كانت الفِرَق من المدن الرئيسية القريبة من أعالي دجلة تسير في موكب يخترق المدينة حيث يتنافس كل فريق مع الآخر في تمثيل الحدث المأساوي الذي يهدف المهرجان إلى إحياء ذكراه... وأخيراً ظهَرَ موكب أهالي النجف الذي تمّ انتظاره بصبر منذ وقت وكان هذا الموكب من الروعة، حتى إنّ المتفرجين نسوا المواكب التي سبقته وكان يتألف كالعادة من فرقة من الفرسان العرب يليهم عدد كبير من الإبل حاملةً لوازمَ منزلية وبعض الشخصيات التي تمثل عائلة الحسين التي وصلت نساؤها سبايا من دمشق كما يقال. وكان يلي هذا موكب كبير من الطبقات التالية: أولاً، السادة، ثانياً، رجال اللاهوت والواعظون الدينيون، ثالثاً، كبار التجار والوجهاء، ثم وصل اللاطمون على الصدور والمتسوطون بالسلاسل الذين شكّلوا زهاء عشرين موكباً». وكانت الهويات المختلفة للسكان الشيعة وموقفهم من الحكومة تطفو على السطح أثناء المواكب العاشورائية: إذ إن المشاركين الفرس كانوا في العهد العثماني يقدّمون فعاليتهم أمام القنصل العام الإيراني. أما العرب فيؤدون شعائرهم أمام سادن الحضرة الذي كان معيّناً من الحكومة. وحين حضر الملك فيصل عام 1921 مواكب العاشر من محرم في الكاظمين، أراد المرجع السيد محمد الصدر إجبار الفرق العربية والفارسية على دمج الموكبين للاستعراض أمام الملك، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
(المرجع: إسحق النقاش ـ «شيعة العراق»، ترجمة عبد الإله النعيمي، دار المدى، 1996).
■ إيران: مسرح وتكايا
كانت مواكب العزاء تتكوّن من مجموعات الرجال الذين يرتدون ألبسة ملونة وزاهية ويمتطون خيولاً مطهمة وجِمالاً بسروج مزركشة وهم يسيرون في الشارع الرئيسي في المدينة. وفي وسط المجموعة، يظهر رجُل مطروح على ظهر فرَس يمثّل رجُلاً مذبوحاً ومضرّجاً بالدم. وخلف الفرَس تسير مجموعة من الجنود وهم يحملون الرماح، تصحبهم فرقة موسيقية تنادي «حسين... حسين... سيد الشهداء». وقد أشار المؤرخون إلى بداية مسرح عاشوراء في نهاية القرن السادس عشر الميلادي، إذ أقيمت تلك المسرحيات الشعبية في الساحات العامة، أو في التكايا وبخاصة في المدن الكبرى ومن أشهرها «تكية دولت» في طهران التي بنيت نهاية القرن التاسع عشر بإيعاز من ناصر الدين شاه القاجاري، على شكل دائري من المرمر والخشب والرخام على غرار دُور الأوبرا في أوروبا. وازدانت جدرانها بالتحف الفنية والمرايا والسجاد والكريستال، وغلِّفت بأقمشة حريرية موشاة بالذهب، وكذلك تكية «عوافي الملك» في كرمنشاه التي شيدت عام 1917م التي تحوي أكبر لوحة فنية شعبية لمشهد سبايا الحسين وهنّ مكبلات بالسلاسل، إضافة إلى لوحات أخرى يظهر فيها الإمام الحسين وهو يرفع طفله الرضيع إلى الأعلى راجياً له قطرة ماء. كما تمثّل مسرحية «عرس القاسم» في مختلف التكايا الإيرانية، حيث تشيَّد حجرة صغيرة من الخشب والجص، مزدانة بالألوان والشموع والأزهار، وتحمل عدداً من الأشخاص إلى وسط المسرح تتبعها جوقة موسيقية لزفاف القاسم من ابنة عمه فاطمة. ثم يدخل فرس علي الأكبر ابن الحسين من دون فارسه إلى المشهد، فيترك العريس اليافع الزفاف وينزل إلى «عرس الدم» في الميدان. وثمة أسطورة فارسية قديمة تصف مقتل البطل سياوش الذي قُتل غيلة في مقتبل العمر، وقد بكاه أهل بخارى بحرارة وألم، تتشابه مأساته مع تراجيديا الحسين مع الفوارق التاريخية والأسطورية، إلا أن الأساس النفسي والثقافي ــ الاجتماعي للملحمتين واحد تقريباً.
(المرجع: إبراهيم الحيدري ـ «تراجيديا كربلاء»، دار الساقي، 2015).