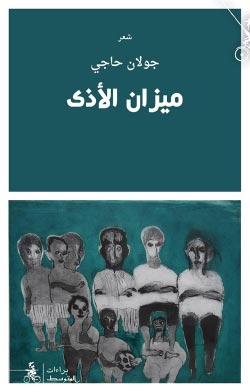يقول حاجي: «أنساني الضجرُ مخاوفي/ فألِفتُ هذا المنزل: نادماً، أغلقُ فمي؛ وحيداً، أفتحُ قلبي/أنا سعادتي وخرابي /أفتحُ الكتاب وأغلقه وأفتحه /فاتحاً في انتصار صغير/ بابَ قبر/ أغلقه على نفسي/ كطفلٍ يتّخفى في خزانة».
أما الملاحظة الأخرى في هذه المجموعة، فهي القدرة على اعتصار الألم، وتحويله إلى مادةٍ ملموسة يُمكن إدراكها من خلال صبغ الكائنات الحيَّة بالشعور الإنساني. يقول حاجي: «في أحد الصباحات/ رأيتُ كلبك وقدمه المقطوعة تتدلى بين فكيّه الداميين/ واقفاً مثل حمار زرادشت ذي القوائم الثلاث/ يحيا في قاع بحر قزوين وإلى السواحل يصل روثه كهرماناً انتهت مسابحه في أسواق ماردين». ويتابع في موضعٍ آخر: «هل نسيتَ كم انبهرت بالزرافة المحترقة؟ ذاك الانبهار مضحك الآن/ مخجلٌ/ لا يعقَل أو حتى لا يُطاق/ لستَ متأكداً متى شاهدتها على غلاف مجلة توقفتْ عن الصدور/ اسمها (كراسٌ): زرافةٌ بعيدةٌ تحترق وراء امرأة واقفة فخذُها سلّمٌ من الأدراج».
يحاول حاجي أن يجعل من قصائده جسراً للتواصل مع الآخرين. هذه الكتابة هي مجردّ محاولة لتضميد جروح عدّة. لذلك نجد احتفاءً بالغياب والعُزلة في صورتها الأكثر قسوة، فالغائبون حاضرون هنا ولو مجازيّاً. وبالرغم من هذه اللغة المتقشفة في النصِّ إلا أن الثراء البصري يحضرُ بقوة، مثل الجزء المعنوَّن بـ «ضوءٌ في الماء» الذي يحاول فيه حاجي أن يجعل من اللون أبجدية للعُنف والقسوة. لقد حاول من خلال نصوص نثرية أن يتماهى مع معرض الفنان البصري بيل فايولا عند زيارة معرضه في القصر الكبير في باريس عام 2014. إن الإنسان بكل ما فيه من مشاعر إنسانية فوضويّة ومصائر شتى، هو تنويع للوحة ضخمة تُسمى الحياة.
يقول حاجي: «يخلعون الخوّذَ الفسفورية والقفازات الخشنة/ ويسندون هذا المساء ظهورَهم إلى الصخر/ ربطوا السلاسل إلى الرافعات/ وقطعوا بمقصاتٍ كبيرة حبال المشنوقين/ وتركوا هذه المرأة تُصلي/ وحدها على الضفة/ مكتوفة بيضاء الشَعر/ لا ضرورة للكلام/ أدرك الجميع/ عمال الإنقاذ وعمال البناء على الخشبة/ المسرح أمام أشجارٍ مُعمِرّة تحت الغيوم/ والجمهور الضجرانُ يبتعدُ/ إذ يَظنُّ أنّ لا شيء يحدث هنا». ولا يتوقف حاجي في مدائح الوحدة والقسوة عند هذا الحدّ، بل نجد تيمة مماثلة في المقاطع المعنونة بـ «الزناة» التي ظهرتْ على هيئة كتيبٍ صغير مُترجم إلى اللغة الدنماركية مصحوباً برسوم بهرام حاجو من عام 2011. تفيض هذه المقاطع بالجثث، وبالطيور الميتة داخل الرأس، وبالوحدة كجرار فارغة، وبالمصابيح المطفأة، وأحاديث الزهو والحسرات، والسجن المفتوح على الدوام، والقتلة المترصدون، والوشاة إلخ.
أبجدية رصينة في جوهرها، وحداثية في إطارها الخارجي
إن أبرز ما يميز هذه المجموعة المتنوعة في أخيِّلتها وصورها، الاستناد إلى أبجدية رصينة في جوهرها حداثية في إطارها الخارجي، فالمعجم الشعري هنا ثريٌ ومتنوّع. يُمكنْ ملاحظة ذلك من خلال بناء الجملة الشعرية على مستوى المفردات والنسق كأن يقول: «في أحواضِ الأشجارِ المَطليَّة بالكلس يَبستْ أوراقُ الدلبْ/ واستظل الهديلُ/ على سور التكيّة الجنوبيّ تجلس الريحُ/ وتُقلّب كتاباً مُستعملاً/ القُبة الكبرى كثؤلولٍ في خوذةٍ/ تتمرأى في صمت النافورةِ/ القبابُ الأخرى بيوضُ رُخٍ لن يَعود/ ظلالُ الفقاعاتِ تقطعُ الممشى». لكن هذه اللغة ليست جافة أو إنشائية إنما مرنة طيّعة تتجاوب مع تجددّ الصور، فلا زخرفات أو خطابة بل فقط اقتناص المفردة من أقرب طريق للهدف. وبالرغم من أن هذه المجموعة كُتبت قصائدها على فتراتٍ زمنية غير مُتصلّة، إلا أنها تحوي الأسئلة ذاتها حول ماهية الحروب، والقلق اليومي المُعَاش إلى جانب هموم الذات الفردية.
لا يُمكنْ حصر أفكار المجموعة في مقالٍ واحد؛ حيث تبدو التنويعات اللغوية والبصرية جليّة داخل النصِّ، وتُحيل بدورها إلى إفادة الشاعر من طبيعة تكوينه الثقافي. في المسافة الفاصلة بين حركة الترجمة، ومشهديَّة القصة القصيرة، أنجز حاجي هذه المجموعة الفاتنة القاسية التي تُضيف إلى الحرف واللون معاً. في أحد المقاطع، يقول حاجي: «العصفورُ الذي على سلكِ الغسيل تعرّف إليّ دون أن يعرفَ اسمي/ كانت ساقاه أنحلُ من السِلك؛ ولكنهما تخدمان حياته جيداً/ أفزعتهُ بظهوري فأطلق الفزعُ جناحيه عالياً/ لا فرق لديه بين سائر الأشكال التي يُطلقْ عليها اسمُ البشرْ/ سيّان أنا وسواي/ فعيناهُ البارقتان لا تستأمنان أحداً/ أما أنا فأكرهُ إني أحرس اسمي الذي وهبته كي يأسرني/ أجرّهُ ويجرّني/ فالتصق بوجهي وصار جزءاً من نبرة صوتي/ استغربه أحياناً إذا قرأته أو سمعته/ أو أضجر منه وأمقته كالآخرين جميعاً/ أمضيتُ وقتاً طويلاً كي أسجنَ نفسي في اسمي/ إذ كلُّ أمرئ يُدفَنُ حيّاً في اسمه: قبرٌ من الخوف والوحدة والمتعة وسوء الفهم». نعم. إنه الشعر حين يتحوّل إلى ترجمةٍ لليومي المحتوم.