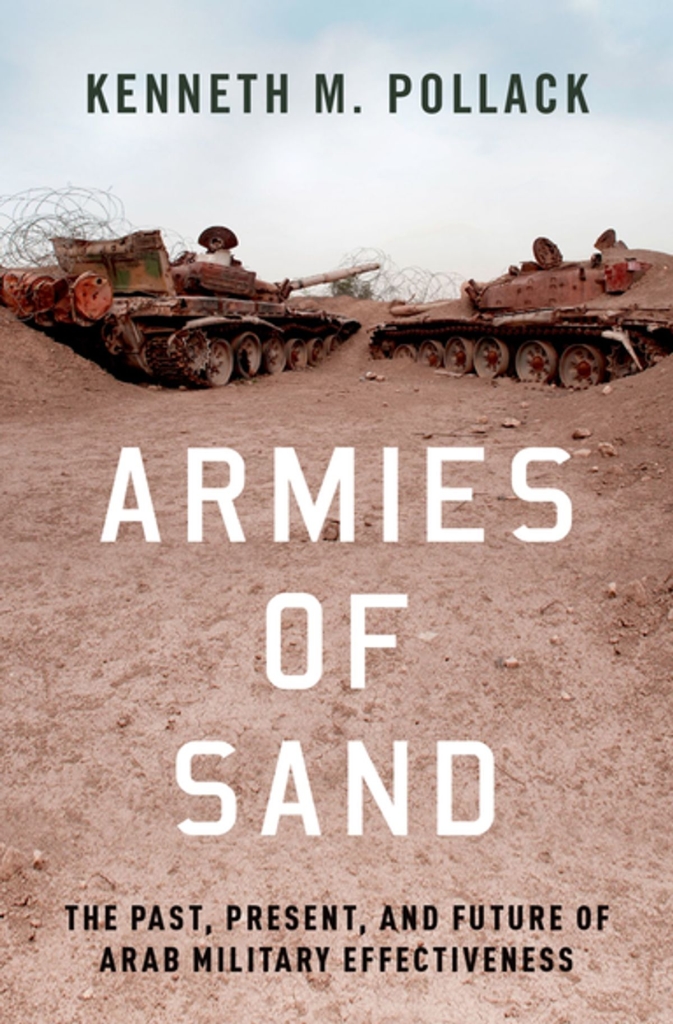
حتى الكتب السيّئة لها فوائد. عبر هذه الكتب، مثلاً، قرأت عدداً كبيراً من مذكّرات الزعماء الصهاينة والأدبيات الصهيونية الكلاسيكية؛ وبفضلها تعلّمت أموراً لم أكن لأتعرّف عليها لو لم يكن الكتاب بدولار؛ كأن أقرأ مذكّرات دنيس رودمان وأتعلّم عن فلسفته في الحياة، أو أحاول أن أفهم افتتان الشعب الأميركي بروايات ستيفن كينغ وأمثاله. استطراداً: نظريّتي عن الكتب والقراءة هي أنّ النص المكتوب يشبه، بمعنى ما، السجّاد العجمي. السجّاد العجمي هو أساساً وسيلة لتخزين عددٍ هائل من ساعات العمل الماهر في سلعةٍ معمّرة (حين تتجاوز المجتمعات مرحلة الاكتفاء البدائي ويصبح لديها فائض من قوّة العمل، تبدأ بالبحث عن وسائل لـ«تخزين» هذه الطاقة في سلعٍ أو مشاريع أو أعمال فنيّة، الخ). السجادة الفارسية تحتفظ دوماً بقيمتها لأنها تختزن آلاف الساعات من العمل اليدوي، ولا يمكن استنساخها بكلفةٍ أقلّ؛ وحين تشتريها، فأنت تشتري كلّ هذا الجهد الذي وضعه فيها العمّال المهرة وتتملّكه لنفسك.
الكتاب هو تماماً كهذا المثال: شخصٌ أفنى سنوات من عمره ليتعلّم عن موضوعٍ معيّن ويبحث ويجمع، ثمّ يكثّف كلّ هذا الجهد في نصٍّ يمكنك أن تقرأه خلال ثماني أو عشرة ساعات (قراءة الكتب البحثية يستغرق وقتاً أطول بكثير من الروايات أو المذكرات)، أي إنّ في وسعك أن «تتملّك» كامل جهد هذا الانسان وعمله، على مدى سنوات، خلال ساعاتٍ من القراءة، وأن تستوعب هذه المعرفة والخبرة وتجعلها جزءاً منك. من هنا، أنا لا أعرف - من ناحية استغلال الوقت - نشاطاً انسانيّاً أو «صفقةً أفضل» لتمضية وقتك (وبعد عمرٍ معيّن، فعلاً لا شيء أفضل). عقلانياً، يجب أن تبحث عن الكتب الجيّدة، ولكن حتى الكتب «السيئة» لها فوائد وتختزن جهداً.
من بين «كتب التخفيضات» كان هناك صنفٌ من الكتب عن الزعماء والقادة والسياسيين هو ليس سيرةً لهم بالمعنى البحثي النقدي، بل سيرة مدائحية (hagiography)، ينشرها سياسيّ للترويج لنفسه أو يخطّها كاتب بتكليفٍ من زعيمٍ أو ملك. هي ليست مثل كتب المدائحيات التي تنشر بالعربية عن ملوك العرب ورؤسائهم، فيها حدُّ ما من المصداقية وتتبّع التاريخ، ولكنها تقدّم شخصية البطل دوماً في أحسن صورة ممكنة، وتخفي عيوبه، وتقدّم روايته عن الأمور (أذكر من بينها كتابٌ اشتريته بدولارٍ عن حياة الملك حسين، اعتقد أنه كتاب رولاند دالاس، يجعل ملك الأردن يبدو كالنبي سليمان).
كتاب بولاك هو مثالٌ عن هيولية مفهوم «الثقافة»
ما أودّ الوصول اليه هو أنّ المؤرّخ اندرو سكوت كوبر قد نشر كتاباً من هذه النوعية عن شاه ايران. قد تسأل، كيف يمكن أن تجمّل شخصيةٍ كالشاه محمد رضا بهلوي؟ استثار ضدّ حكمه ثورة شعبية عارمة، وقاد سلالته، بل كامل التقليد الامبراطوري في ايران، الى الفناء. فشل في التنمية، وأفلست حكومته، وهو، فوق ذلك، لا يمكن أن تعزو اليه الكثير من الصفات الشخصية الحميدة: لا يملك كاريزما من أي شكل، وسلوكه الجامد كان محطّ تندّر، ولا يمكن القول إنّه كان شجاعاً، فقد فرّ من البلد مرّتين (عام 1953 وعام 1979) تاركاً العرش عند أوّل بادرةٍ للخطر، وشارف على الفرار مرتين ايضاً على الأقل (عام 1963، كان الشاه وعائلته على وشك استقلال الطائرة وترك البلد حين أخبره جنرالاته بأن المعارضة قد تم سحقها وأن الوضع تحت السيطرة ولا حاجة إلى أن يصاب بالذعر). كيف يمكن أن تقدّم شخصيةٍ كهذه بشكلٍ مجيد؟ هذا تحديداً هو ما يحاول أندرو سكوت كوبر فعله في كتاب عنوان: «سقوط السماء، آل بهلوي والأيام الأخيرة لإيران الامبراطورية»، الناشر هنري هولت، 2016).
في بلاط الشاه
الخيبة كانت لأنّ الكتاب الأول لكوبر كان بحثياً وممتازاً («ملوك النفط»، 2011). ولكنّه هنا، بتعابيره، أراد نشر كتابٍ سهلٍ للعموم، وأن «يراجع» السردية السائدة عن الثورة الايرانية وآل بهلوي. إن كان كتاب كوبر الأول قد قام على بحثٍ أرشيفي، فإنّ كتابه الجديد عن آل بهلوي مبني أساساً على مقابلات شخصية. أجرى كوبر عدداً كبيراً من المقابلات مع شخصياتٍ مهمّة من بلاط الشاه ونخبته: «الشاهبانو» فرح ديبا، مسؤول السافاك برويز سابِتي، سفير الشاه في واشنطن اردشير زاهدي، مسؤول الاعلام يومها (ونسيب فرح ديبا) رضا قطبي، وأبناء وأحفاد شخصيات مثل حفيد المرجع شريعتمداري أو حفيدة الشاه، ماهناز زاهدي، إضافة الى سياسيين من تلك الحقبة مثل علي قاني وبني صدر، ودبلوماسيين كخليل الخليل، السفير اللبناني الذي ظلّ في طهران حتى أسابيع قليلة قبل سقوط الشاه. من هنا، كان كتاب كوبر بمثابة «تاريخ شعبي» لأسرة بهلوي ونظرتها الى أحداث السبعينيات - مع هيمنة بشكلٍ خاص لسردية فرح ديبا ومحيطها واردشير زاهدي.
عند كوبر، كان الشاه محمد رضا انساناً لا يحرّكه سوى حبٌّ جارفٌ لبلاده، ويتملّكه شعورٌ دائم بالمسؤولية تجاه شعبه. حقّق لإيران قفزات هائلة واحتراماً دولياً، ولكن الشعب لم يقدّر ذلك وخُدع بدعاية الاسلاميين. هو، إضافة الى ذلك، كان حاكماً رحوماً، لم يقتل نظامه خلال فترة القمع في السبعينيات أكثر من 400 إيراني «على الأكثر» (بحسب كوبر)، والغضب الشعبي ضدّه، والثورة نفسها، لم تكن ضرورية أو مبرّرة، إذ إنّه كان قد تخلّى أصلاً عن سلطاته التنفيذية، وينوي تسليم الحكم الى ولده وجعل إيران ديمقراطية حرّة (في الحقيقة، كان الشاه يركّز كل السلطات في يده منذ عام 1953، وحتى حين عرف أنه مصابُ بالسرطان عام 1973، وأمامه سنوات قليلة، افترض أنه سيعيش للحد الأقصى، وخطّط لأن يحتفظ بالسلطة كاملةً حتى ذلك الحين؛ وهو لم يعلن التنازل عن السلطة التنفيذية إلا حين كان الأمر قد انقضى، والتظاهرات تعمّ البلد، وهو يتفاوض على أي شيء).
الشاه، عند كوبر، كان عميقاً ذكياً عطوفاً لمّاحاً، ولكنّه كان ينجح في إخفاء كلّ هذه الصفات. العيوب التي يذكرها كوبر عن الشاه هي من نوع أنّه كان خجولاً، أو يتجنّب المواجهة ويفضّل التجاهل والانكار على تلقّي السيّئ من الأنباء، وأنّه كان يثق بشعبه وبحبه لملكه «أكثر مما يجب». ولكن الذنب الأساسي للشاه عند كوبر هو أنّه كان «رحيماً» وديمقراطياً ولا يقبل بسفك دماء الايرانيين. هذا، أساساً، هو تفسير الكتاب لنجاح الثورة: الشاه يقيّد يد السافاك ويمنعه من القمع، يرفض عرضاً من صدّام حسين لقتل الخميني وهو في العراق، يرفض أن يسمح لقوّاته بقمع المتظاهرين، الخ. «القول الفصل» في الثورة الايرانية، في كتاب كوبر، يأتي على لسان صدّام حسين، حين استقبل فرح ديبا وهي في زيارة للعراق عام 1978، في محاولة للحصول على تأييدٍ من المرجع الخوئي. تقول ديبا إنّ صدّام مال باتجاهها وقال لها «أخي الشاه لديه دبابات ومدافع، أليس كذلك؟ فليخرجها (الى الشارع). من الأفضل أن يموت ألف إيراني اليوم على أن يموت مليون في المستقبل». يقدّم كوبر كلام صدّام حسين على أنّه كان «نبوءةً»، والطريق الذي كان على الشاه أن يسلكه، ولكنّ أخلاقه قد منعته عن ذلك، فكلّفته عرشه (على الهامش: يقول كوبر إنّ الملك حسين، صديق الشاه، عرض أن يشارك في قمع المتظاهرين بنفسه، فيما عبّر السادات وفهد بن عبد العزيز عن جزعهم من احتمال سقوط الامبراطور).
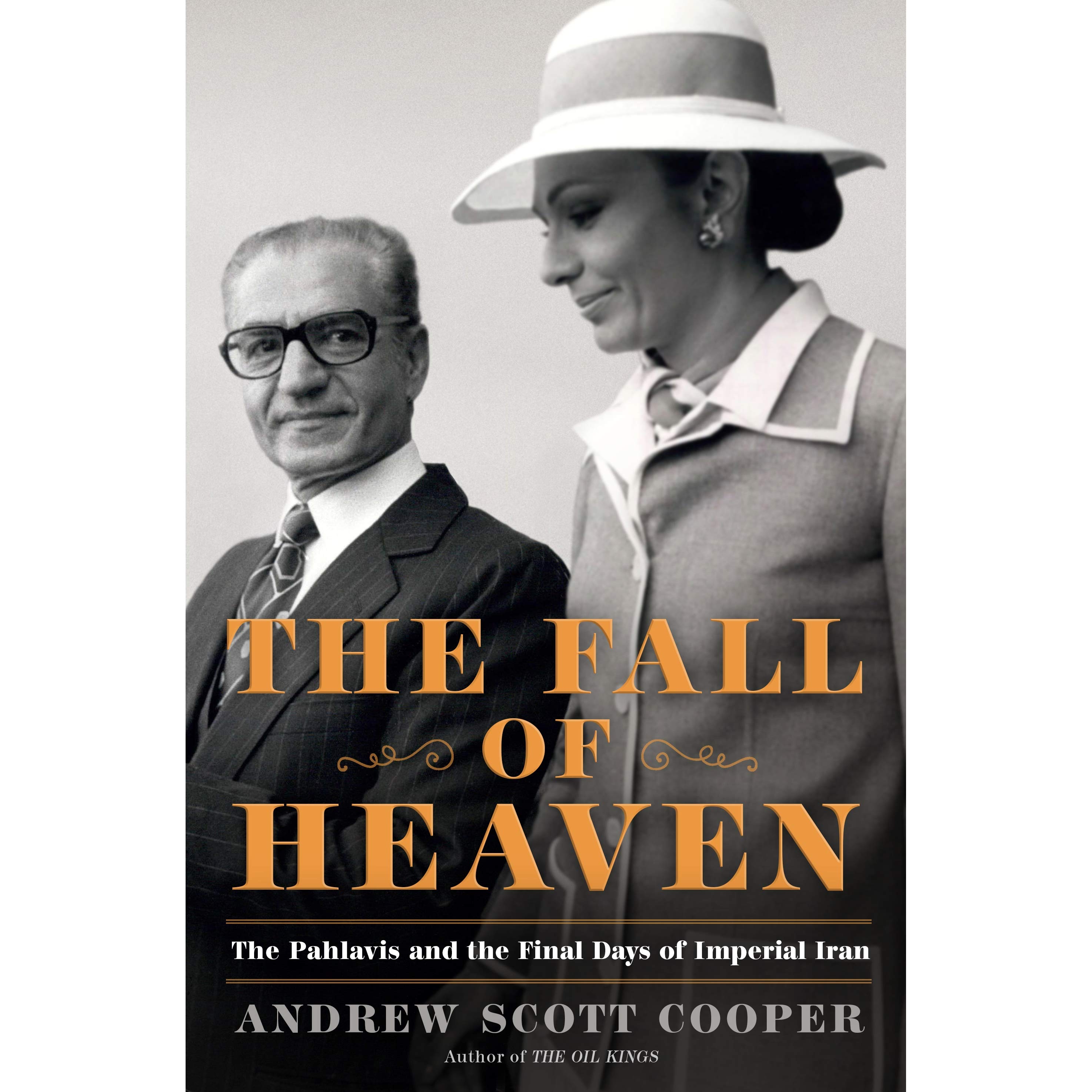
لن نقوم هنا بعرض التواريخ التي تعاكس كوبر في سرده، وهو أساساً يروي الأحداث من وجهة نظر أهل القصر، مع القليل من الكلام عن الأوضاع خارجه، ولا يشرح، مثلاً، أنّه لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تقمع مظاهرات، كلها بمئات الآلاف، تجري في وقتٍ واحد في عشرات المدن، من كرمنشاه الى يزد. وأنّ حظر التجوال والحكم العسكري، حين تمّ تجريبه، لم يؤدِّ إلّا الى انفجار المتظاهرين والسقوط الكامل للنظام. المشكلة أساساً أنّك في بلدٍ «امبراطوري»، كانت السلالات - تاريخياً - تحكمه عبر قدرٍ كبيرٍ من اللامركزية وشبكة من السلطات المحلية (حتى الجيش كان يأخذ صفة «جهوية»: كلّ إقليمٍ وتجمّع قبلي يدرّب فرسانه ويرسلها بشكلٍ مستقلّ لخدمة الشاه. البختيار والكرد واللار الخ. والمشاة الذين يرمون بالبنادق - التفكنجية - يتمّ تجنيدهم من فلاحي الولايات الشمالية، ولهم تقاليدهم وشخصيتهم الخاصّة). بلدٌ كهذا لا يمكن أن تحكمه، فجأةً، عبر فردٍ أو مركزٍ واحد. بتعابير أخرى، لا يمكن للشاه أن يستمدّ شرعيته من عرش القاجار والساسانيين، ثمّ يحاول حكم ايران كأنه ضابطٌ أمسك البلد في انقلاب.
ما فعله كوبر أنّه، ببساطة، ينتقي الرواية التي تناسبه، مهما كانت ضعيفة، ويقدّمها إلى القراء كحقيقةٍ لا شكّ فيها. هكذا، مثلاً، نسب حريق سينما «ريكس» في عبدان الى الثوار الاسلاميين: نظام الشاه نفسه لم يتهم الاسلاميين بحريق «ريكس»، بل اتهم يومها «مجاهدي خلق»، والرواية غير منطقية، والمحاكم بعد الثورة حققت وأدانت المذنبين؛ غير أن كوبر يصف، بطريقة سينمائية تشويقية، نسخة أخرى عمّا حصل بناءً على شهادة واحدة - تخالف كل السجل التاريخي - موجودة في كتابٍ غير معروف لكاتب اسكتلندي غير مختصّ. بالمثل، يسرد كوبر قصّة مدهشة عن اختفاء الامام موسى الصدر في ليبيا، فيجعل اختطافه أمراً مباشراً من آية الله بهشتي، وأنّه قتل لأن الشاه كان على وشك جعله رئيساً للوزراء في إيران، وأنه كان في طريقه الى المانيا للقاء مندوبي الشاه والتفاوض معهم. المصادر عن هذه القصة «الغريبة» هي أيضاً غير واضحة، بينها شهادة لمسؤول مخابراتي أميركي ولبرويز سبتي، والاثنان لا يمكن أن يعرفا بالضبط ما جرى في ليبيا (وأن لا يعرف به غيرهما). إضافةً إلى ذلك، كان كوبر «كريماً» الى حدٍّ لا يصدّق مع كلّ من أعطاه مقابلةً. هم جميعاً يبدون على طول الكتاب مثالاً عن النزاهة والجدّ والحكمة، كلّهم كانوا يرون الى بعيد، ويحاولون ما في وسعهم لمنع السماء من السقوط (تتساءل هنا، كيف سقط نظام الشاه بهذه الطريقة المدوية وهو يملك كل هؤلاء المسؤولين الأكفّاء). والفساد والتقصير لا يأتي إلّا من خارج هذه الدوائر ومن خصومهم في البلاط. لا يوازي مديح كوبر لرجال الشاه (حتّى أعطيكم فكرة عن الأسلوب الذي يستخدمه، هو يصف جنرالات النظام - السيّئو السمعة في ايران، مثل عويسي وخسروداد - بهذا الشكل «عسكريون محترفون بكلّ إخلاص، ورجالٌ وطنيون أقسموا بحياتهم على حماية العرش والمملكة»)، لا يوازي مديح كوبر لبلاط الشاه الّا كراهيته لأعدائه. هو لا يستخدم تعبير «مظاهرات» و«متظاهرين»، تقريباً، حتى الثلث الأخير من الكتاب ودخول إيران في مظاهرات رمضان 1978 الجارفة؛ بل يتكلّم حصراً عن «عصابات» و«رعاع» (mobs)، إرهابيين وأعمال شغب (riots). حتّى إنّك لا تفهم كيف تتحوّل أشهرٌ من التخريب والشغب، فجأة، الى مظاهرات بالملايين تطالب بموت الشاه.
العرب والقتال
إن كان كوبر قد خطّ كتاباً مدائحياً في آل بهلوي، فإنّ كينيث بولاك قد أخذ كتاباً ممتازاً، نشره عام 2002، ومسخه في ما زعم أنّه «جزءٌ ثانٍ». بولاك، عميل الـ«سي آي إي» السابق، نشر في بداياته كتاباً شهيراً عن العسكرية العربية («العرب في الحرب»، 2002) كان، يومها، من أكثر الأعمال بالانكليزية شمولاً وتفصيلاً في الموضوع. في مخطوطه الأوّل، استفاد بولاك من سنوات عمله في المخابرات، والوثائق العسكرية الأميركية، ومقابلاتٍ مع ضباط ومستشارين عسكريين، وكان يحاول أن يجيب عن سؤال: «لماذا تفشل الجيوش العربية في القتال»؟ كان الكتاب يحوي سرداً طويلاً للمعارك التي خاضتها عدّة جيوش عربية (مصر، العراق، سورية، السعودية، ليبيا) منذ عام 1948، مع تقييمٍ لأدائها فيها - وكان هذا هو الجزء المفيد، والأطول، في الكتاب. وفيه تفصيلات ومعلومات جديدة عن تجارب الجيوش العربية لم نكن نعرفها من قبل. في الوقت ذاته، كان في الكتاب أيضاً حجّة «نظرية»، ثقافوية الى حدٍّ ما، تحاول شرح فشل العرب في بناء جيوش فعّالة عبر خصالٍ ثقافية عربيّة، ولكنها لم تكن ركناً مركزياً في العمل.
في كتابه الجديد («جيوشُ من رمال»، منشورات أوكسفورد، 2019) يكرّر بولاك بشكلٍ مختصر سرد المعارك والحروب من كتابه الأوّل، ثمّ يضيف معلوماتٍ وأمثلة حصلت بعدها، ويتوسّع بشكلٍ كبير في حجّته حول الثقافة العربية والفشل العسكري. كلّ هذه الأجزاء الإضافية، باختصار، قد قلّلت من قيمة كتابه الأصلي ولم تضف اليه. كلّ السرد للحروب التي جرت بعد عام 1993 تنقصه المصادر الحصريّة والمفيدة، التي استفاد منها بولاك في السابق، ويعتمد مصادر ثانوية وصحافيّة، فيكون السرد مليئاً بالأخطاء والنواقص. على سبيل المثال هو يتكلّم، بتكرارٍ، عن دور «حزب الله» في الحرب الأهلية اللبنانية، وكيف شكّلته الحرب الأهلية، وكيف «انتصر» فيها، ثمّ تفرّغ لمواجهة اسرائيل (و«حزب الله» تشكّل بعد عام 1982، وكانت مشاركته في الحرب الداخلية محدودة، وأكثرها ضدّ حركة «أمل»)، أو يقدّم توصيفاً مريعاً لأحداث الحرب ضدّ «الدولة الاسلامية» في العراق. أو يحكم بأنّ الحرب بين «حزب الله» و«أمل» في الثمانينيات كانت هي «حرب المخيّمات». هناك قاعدة في البحث الأكاديمي، وبخاصة في مناهج كالعلوم السياسية قد تتكلّم فيها عن دولٍ وأمثلة لا تعرفها جيّداً: ليس من واجبك دوماً أن تعرف كلّ شيءٍ عن الحالة التي تكتب عنها، ولكن ممنوعٌ عليك أن «تستعرض جهلك» عبر أخطاءٍ فاضحة من هذا النوع، فالقارئ سيفقد الثقة بما تقول (في مشكلة شبيهة، كان من الممكن أن نستمتع، في كتاب اندرو سكوت كوبر، بقصص وحكايات عن بلاط بهلوي وشخصيات القصر، لولا أننا غير متيقنين بالكامل من صحّة أيّ منها).
ليس من واجبك دوماً أن تعرف كلّ شيءٍ عن الحالة التي تكتب عنها، ولكن ممنوعٌ عليك أن «تستعرض جهلك» عبر أخطاءٍ فاضحة
ولكنّ المشكلة الحقيقية كانت في الجزء «النظري» من الكتاب، حيث يدافع بولاك عن فكرته الثقافوية ويوسّعها ويعطيها مكاناً مركزياً في البحث. الجيوش العربية، يقول بولاك، تخسر الحروب حتّى حين تكون - كما في حروب 1967 و1973 ضدّ اسرائيل أو حرب ليبيا في تشاد - متفوّقة كمّاً ونوعاً على الخصم. هذه الخسائر المتكرّرة هي ما دفع بالحكومات العربية الى التخلّي عن القوة والحرب كوسيلة في السياسة، وجاء جيل من الأنظمة والزعماء (كالسادات وعرفات) يقوم نهجهم على تجنّب المواجهة العسكرية والسعي عبر الدبلوماسية حصراً (يقول بولاك إنّ صدّام حسين كان آخر زعيمٍ عربيّ يستخدم جيشه لتحقيق ما يريد في السياسة، ناسياً مثال ابن سلمان واليمن). سبب هذه الهزائم والأداء الضعيف، يحاجج بولاك، ليس سوء القيادة أو «العقيدة السوفياتية» أو المستوى الاقتصادي المتدنّي لدى العرب أو التسييس، أو باقي الحجج التي تساق عادةً في هذا الإطار (ويصرف وقتاً لتفنيد كل من هذه الحجج على حدة: هناك دول اعتمدت العقيدة السوفياتية وبرعت في القتال - ككوريا الشمالية - وهناك دول أفقر من العرب وأقلّ تقدماً نجحت في فن الحرب، وهناك دول عربية اعتمدت عقائد عسكرية مختلفة أو غيّرت عقيدتها - كالجيش المصري - ولكنها تظهر المشاكل ذاتها مع ذلك). المذنب هو الثقافة العربية، فهي تنتج أفراداً وشعوباً «لا تصلح» للحرب الحديثة. الثقافة العربية «السائدة» - عند بولاك - بطركيّة، تعلّم تنفيذ الأوامر وتمنع الضباط الصغار من الإبداع والارتجال اللذين تستلزمهما حرب المناورة؛ هي - على عكس ثقافة الغربيين - تقدّم المظاهر والحفاظ على ماء الوجه على الصّدق، فيكذب الضباط على رؤسائهم ولا تنتقل المعلومات بسلاسة بين مرتبات الجيش. الثقافة العربية، يضيف بولاك، تشجّع على الاستكانة وعدم القيام بمبادرات، خشية أن تخطئ وتصاب بـ«العار»، فالأفضل أن لا تفعل شيئاً حين لا تكون مجبراً على العكس، الخ.
من الواجب أن نذكّر هنا بأنّ النظريات الثقافوية، و«الجوهرانية» بشكلٍ عام، تتعرّض للنقد الشديد ويقلّ استخدامها في العلوم الاجتماعية، ليس لأنّها «سيئة» (بالمعنى الأخلاقي)، بل أساساً لأنها غير مفيدة. حاول الكثيرون على مرّ السنين، ولم يتمكّن أحد من تقديم تعريفٍ وضبط لمفهوم «الثقافة» هذا، ويُفهمنا كنهه وحدوده وكيف يعمل بالضبط (بالمعنى نفسه، مدرسة الاستشراق لم تخبُ لأنّها «عنصرية وسيئة»، بل لأنها لم تعد مفيدة، ولا تقدر على شرح الشرق الأوسط المعاصر، وقد تخلّفت عن مناهج التاريخ الحديثة. من هنا حلّ «المؤتمر الاستشراقي» نفسه عام 1973، قبل سنواتٍ من نقد إدوارد سعيد، كما أن المناهج «الحديثة» البديلة من الاستشراق، بالمناسبة، قادرة على أن تكون عنصرية و«سيّئة»، وأن تحمل انحيازات واستخدامات سياسية وإمبريالية مثل الاستشراق التقليدي تماماً).
كتاب بولاك هو مثالٌ عن هيولية مفهوم «الثقافة»: هو يبدو مناسباً وجذّاباً لتفسير أيّ شيء - التنمية، الفشل في التنمية، العنف، الاستبداد، الديمقراطية، الخ - ولكن من المستحيل أن تضع يدك عليه وتضبطه. إن وسّعته تضمّ «الثقافة» كلّ شيء (الدين، الايديولوجيا، أسلوب الحياة، الخ) وإن حاولت تحديده لا يعود يشرح ويفسّر. يحلّ بولاك المشكلة ببساطة عبر القول إنّه لا يهتمّ لماهية الثقافة أو مصدرها أو كيف تنشأ، فهذا ليس موضوعه، ولا يتبنّى رأياً في هذا الاطار، ثمّ يرصف مجموعة هائلة من التعريفات (المتناقضة) حول معنى الثقافة. مرة يصفها بأنها عملية وظيفية شبه -داروينية (تزيل العادات السيئة وتبقي على العادات الجيدة)، ومرة يصفها كنظام مفتوح لا منطق له، ومقابل كل مقولة شعبية مقولة معاكسة لها؛ هي شيءٌ لا يمكن حصره على مستوى الفرد حتى نفهمه، ولكنه يفعل على مستوى الجماعات، الخ، أي إننا، مع بولاك، لا نعرف تحديداً ما هي «الثقافة»، ولكننا نعرف أنها تسبّب كلّ هذه الخصال الجماعية. وحين نشهد جيشاً له أداءٌ جيّد، كالأردن عام 1948، يخلق بولاك «استثناءً». جنود «الفيلق العربي» كانوا من البدو، يقول بولاك، هم إذاً خارج الثقافة العربية الحضريّة ولا يخضعون لتأثيرها (!)، وضباطهم كانوا بريطانيين، يضيف الكاتب. لم ينتبه بولاك الى أنّ الجيش السعودي والحرس الوطني يجنّدون أيضاً من بين أصحاب ثقافةٍ بدوية، وقد بنى الجيش مستشارون أميركيون، والنتيجة كما نرى).
ولكن، خارج هذا الموضوع، هناك مشكلة أكبر في عمق حجّة بولاك: منذ أن نشر الرجل كتابه الأوّل، لم يعد العرب فاشلين «مثاليين» في الحروب كما كان يصفهم. «حزب الله» و«حماس» و«أنصار الله» (وتنظيمات عراقيّة وسلفيّة) أثبتت براعةً قتالية كبرى في السنوات الأخيرة، ووقفت في وجه قوىً أضخم منها بكثير وهزمتها في بعض الأحيان، وارتجلت وأبدعت وأظهرت كل الصفات التي قال بولاك إنها تنقص الجيوش العربية. هنا إمّا يتجاهل بولاك هذه الأمثلة، أو يخرج بـ«استثناءات» على الطريقة الأردنية: مقاتلو «داعش» هم «مخالفون للثقافة السائدة»، ولهذا السبب هم يختارون التنظيم المتطرّف، الكوماندوس السوري قاتل جيداً في وجه إسرائيل عام 1982 لأنّ اختيارهم كان من نخبة الجنود، التي لا تمثل الثقافة العامّة؛ أمّا تفسيره الأكثر غرائبية فكان حين قدّم فرضية أن مقاتلي «حزب الله» مبدعون على عكس الجيوش العربية لأنهم شيعة، والشيعة لديهم اجتهاد فقهي على عكس السنّة، وهو ما يجعلهم أكثر انفتاحاً فكرياً من باقي العرب (والنظرية كلها تقوم على سوء فهم، شائع في الغرب وبين نخبٍ عربيّة، لمعنى «إغلاق باب الاجتهاد»).
لا يأخذ بولاك في الاعتبار سببيّة محتملة، أبسط بكثير، عمّا يسمّيه «الفشل العربي» في الحرب. الفشل هنا قد يكون، تحديداً، هو فشل جيش الدولة العربية «الحديثة» وليس فشل «الثقافة العربية». بمعنى آخر، «الجيش الرسمي العربي» قد يكون، ببساطةٍ، شبيهاً بالدولة الوطنية التي تشكّلت في المرحلة الاستعمارية وجزءاً من المؤسسة نفسها - وهي فشلت في التنمية، وفي بناء بيروقراطية كفوءة، وفي تنظيم مؤسسات وطنية، فكيف تبني جيشاً قوياً وفعالاً؟ لم تنجح الدولة العربية، على اختلاف سياقاتها، في إنتاج جيشٍ رسميٍّ كفوء، ولكن العرب، حين تنظّموا خارج هذه المؤسسة، تمكّنوا من إنشاء بعضٍ من أبرع التشكيلات العسكرية في العالم. النظرية المؤسسية هنا، التي ترجع الى تاريخ هذه المؤسسات ونشأتها والعادات التي ترسّخت فيها، قد تكون أبسط وأفعل من التفسير الثقافوي لشرح ما يجري. الجيوش «الناجحة عسكرياً» في الجنوب، كحالة كوبا وكوريا الشمالية التي يستخدمها بولاك، هي جيوشٌ قامت كبديلٍ من الجيش الرسمي الذي تركته المؤسسة الاستعمارية أو كنقيضٍ له، بني على أساسٍ جديدٍ بالكامل، أما الأنظمة العربية - حتى «الثورية» منها - فقد كان جيشها امتداداً للمؤسسة القديمة (يجب أن لا ننسى أن الكثير من قادة الدول والجيوش العربية كانوا نخباً حداثوية وثوروية تعتبر نفسها، بتعريف بولاك نفسه، «خارج الثقافة العامة التقليدية»).
لا يرى بولاك هذه العلاقة وهو منهمكُ في شرح «الثقافة العربية» ومشاكلها، ولكن الخبراء والمسؤولين الغربيين - على حدّ قول الزميل الكاتب إبراهيم مالك - لديهم ميلٌ إلى أن يتجاهلوا المعلومات التي «لا تعجبهم» والوقائع التي «لا تناسبهم» في بلادنا (بولاك، بالمناسبة، ليس صهيونياً فحسب، بل تمَّ اتهامه في مرحلة بالتجسّس على الحكومة الأميركية لصالح منظمات صهيونية) وأن لا يروها ببساطة، وهذا «السلوك الثقافي»، في الحقيقة، قد لا يكون أمراً سيّئاً.


