مقالات مرتبطة
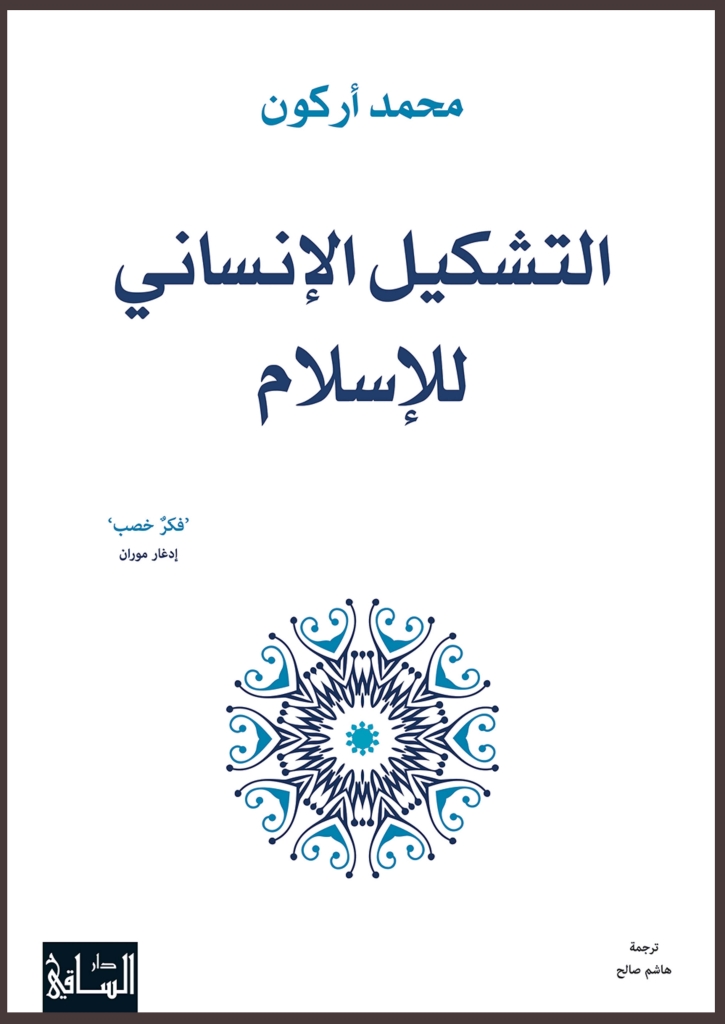
يعتبر المفكر الفرنسي، إدغار موران، في تقديمه، أن صاحب «معارك من أجل الأنسية» قد خاض منازلته الفكرية على جبهتين: نقد العقل الإسلامي ونقد العقل الغربي، ولهذا الغرض استخدم مناهج وأدوات معرفية مختلفة تسندها عقلانية منفتحة، باحثاً عن المسلمات الأبستيمية التي تتحكم بالخطابات والمذاهب، مؤيداً مواقفه بالنقد التاريخي الذي يضع الرسول وكلامه في التاريخ المتعين، والنقد السيميوطيقي مستفيداً من أعمال السيميائي الروسي غريماس (Greimas). والغاية «نقد العقل الجامد»، لا سيّما في الإسلام، من دون أن ينزع عن القرآن سرّه الإلهي، ولكنه يضفي عليه إنسانيته التامة. إذ يرى أركون في كتاب الله «إنساني الإلهي» (l’humain du divin). ولكونه ابن ثقافتين، فقد تعرض غالباً لسوء الفهم، ويُقدِر موران أن خصبه الفكري سيظهر أكثر فأكثر في المستقبل.
تتناول الحوارات أهم المسائل التي تعرض لها أركون في أعماله الكثيرة، ومن المفيد جداً للمهتمين بتتبع مساره قراءة الفصل الأول حيث «التكوين الفكري لمثقف فرنسي - جزائري»، والفصل الثاني الذي يروي فيه رحلته من طالب في الجزائر العاصمة وصولاً إلى باريس. وقد اخترت أنا في قراءتي أن أتوقف في العرض عند قضيتين تمسّان الحال الراهنة، وهما الصلة بين الديني والسياسي ووظيفة علماء الدين.
يستجوب الباحثان أركون عن الديني والسياسي في زمن نزول القرآن ويبديان خشيتهما من أن يدخل الأمر في نوع من المفارقة الزمنية؟ يجيب المفكر الجزائري بأن حياة البشر تجري في فضاء اجتماعي- سياسي، حيث تحيل «سياسة» إلى polis الإغريقيّة التي تعني المدينة، أي المجتمع السياسي على نحو عام والدولة بالمعنى الأشمل. ومنذ الفلسفة اليونانية، قامت السياسة على تصوّر ماهية الحياة السياسية. وبناء على هذا الاعتبار، يوجد سياسة في الخطاب النبوي، في شكل عام، لا في القرآن فحسب، لكن أيضاً في التوراة، فالنبي موسى عبر عن نفسه في فضاء اجتماعي، والأمر نفسه بالنسبة إلى المسيح. ففي الفضاء الجمعي، تطرح كل أنواع الخطابات من أفراد الجماعة في شأن حياتهم المشتركة، وثمة منافسة على السلطة، وبالتالي على التحكم في هذا الفضاء، وحينها يمكن أن يرتسم في الخطاب القرآني، حتى الروحي والطقسي، وجه سياسي، وأيضاً يبسط الطقسي الديني نفسه في فضاء سياسي.
إذاً، الأنبياء الثلاثة المذكورين لا يصنعون السياسة بالمعنى الحالي للعبارة، لكن يعيشون في فضاء سياسي يُنظمه قانون. وفي حالة القرآن، لم يكن هناك دولة خلال فترة نزول الخطاب النبوي، وأقيمت الدولة السياسية فعلاً، في دمشق لاحقاً، بعد وفاة الرسول. ويلفت أركون إلى أن الإدارة السياسية زمن الخلفاء الراشدين ارتبطت بتراث واسع قبلي وعشائري، في مكة والمدينة، قائم على مفهوم العصبية، ولا تزال «الحقيقة الأنتروبولوجية» للسلطة موجودة، نراها في حكومات الدول الوطنية بعد زوال الاستعمار. ويمكن التحليل العقلاني أن يضع الأمور في نصابها. وقد تأسست المدونة الحقوقية في ظل الأمرة القيمية لـ «كلام الله» الذي ظهر نفسه في سياق قبلي.
لا يدّعي أركون بأنه يقوم بعملية «تفكيك» (اقرأ تقويض باللفظ الهايدغري)، بل يُلقي نظرة متبصرة على مجتمعات باتت مُعقدة، ولكن تُبسط بوشاح لغة قانونية مجردة ومُلزِمة، كونها تأتي في مجرى قيّم الخطاب النبوي، مع حضور لافت للإلهي، وحضور هذا الأخير في المخيلة سيُعطي حياة للبنيان الحقوقي (أو الفقهي). ويتوجب في زعم أركون الوصول، كما في فرنسا، إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والدينية، بحيث تكون أمور البشر بين أيديهم، ويبقى المقدس والديني قائماً في اعتقادات الناس، وهذا يكون شأنهم الخاص.
والحال، لم يدخل الإسلام في تجربة السلطة كما جرى عيشها في الفضاء الأوروبي، وهو فضاء مسيحي.كان يصطدم باستمرار بجدلية الديني والسياسي. ولا يملك الإسلام أي تجربة في جدلية العلماني/ الديني، وغالباً ما تواجه التصورات المستجدة برفض قاطع.
وفي دراسة أركون لابن مسكويه، تبيّن له، أنه منذ القرن العاشر الميلادي، غاب أي تفكّر أتيقي في أرض الإسلام، ولا تنحصر «الأتيقا» في وعظ الناس، إنما إجبار العقل الفلسفي على التفكير، بصرامة ومسؤولية، لتحديد القيم الكونية، وليس تلك الخاصة بالأمم الدول، والثقافات المحددة، والقبائل والجماعات المسلمة أو المسيحية. وهو يرى أن للعقل الديني (أو اللاهوتي) حدوده التي لا يستطيع تجاوزها، وكذلك العقل الحديث، فعلى سبيل المثال، لم يدِن الرق، لا بل أسهم في تبريره.
يطرح السائلان على أركون مسألة ما يجب أن يكون عليه «العلم بالإسلام»، فيبدأ من نقاش كتاب ماير هاتينا (Meir Hatina) «حراس الإيمان في العصور الحديثة: العلماء في الشرق الأوسط» (الجامعة العبرية، القدس، 2009)، معترضاً على العنوان نفسه، فأركون يُفرِق بين «الاعتقاد» و«الإيمان». إذ إنّ «الاعتقاد» كلمة واسعة تُغطي حقلاً من الموضوعات المتغيّرة في مجرى الزمن وبحسب الأمكنة، يقف دائماً في قبالة التعبير الحر عن الشخصية، وعائقاً في وجه تشكل هذه الأخيرة. أما «الإيمان»، فيخص باطنية وحرية الذات البشرية وتشكلها في العمق، يُقاوم تقلبات الزمن ويسكن الشخص منذ طفولته، في حقيقته الأعمق، ويسهم في تربيته وثقافته وترقيه. ولهذه الأسباب يتوجب، في عرفه، ضبطه ومساءلته ونقده في أسسه وتشكله، ومن المهم معرفة كيف يدير ويحكم الشخص. ويشير أركون إلى أن كلمة «إسلام» في القرآن تعني «الإيمان»، أي الخضوع للأمر الإلهي. وفي البداية، عنت عبارة «حراس الإيمان»، فئة من الناس كانوا على استعداد للاستشهاد ذوداً عن الدين. وهؤلاء ينظر إليهم التراث الإسلامي على أنهم فئة قامت خصيصاً للسهر على العقيدة القويمة، المنظور إليها من الجماعة على أنها الوحيدة الحقيقية، والقادرة على إدامة العهد والصلة مع الله.
يفتح دخول أي نمط من الحداثة إلى البلدان الإسلامية، الباب واسعاً أمام نقاش جديد بأسئلة غير مسبوقة حول الإيمان: كيفية الحفاظ عليه وإعادة تعريفه وإصلاحه... وقد يحصل ذلك بإرادة فردية أو بتأسيس مذهب يُعدِل في تعريفه، ما يُثير حجاجاً يصل حد الانشقاق. والسؤال يبقى: من الذي يحسُم في مسألة القديم والجديد؟ فالجديد عند أولئك المكلفين بالحفاظ على الإيمان كما جرى تحديده في لحظة محددة من الزمن هو زيغ وضلال، فالإيمان قد حُدد مباشرة من الله. ويحجر «الحرّاس» على أي حرية في التفسير ولا يقبلون بإمكان أي تغيير، في حين يرى أركون أنّ «الإيمان» دينامي غير جامد، وهو لا ينظر إلى «الاعتقاد» على أنه مقولة أخلاقية، بل يراه اقتناعات هشّة تفتقد الصلابة، بسبب غياب الحجج التي تسندها ويجري تلقيها من دون نقد. أما الإيمان، فمتجذّر في أعماق الإنسان يمتلك عفوية تدفع إلى العمل والتقدم والتفكير، إنه مشروع حياة «يُنتج» الوجود.
ينظر أركون إلى «حراس الإيمان» هؤلاء بوصفهم أصحاب أيديولوجيا ناشطين لم يسمعوا بالحداثة، ويظنون أنهم يفعلون حسناً حين يوجهون الحاكم نحو الخير ويشيعون الاعتقاد والطاعة. طاعة الكل في وضع من الجهل، وهذا عمل أيديولوجي سلبي، فحين نُنكر الحداثة تكون غير موجودة. فالشيخ الراحل يوسف القرضاوي، مثلاً، يجهل ببساطة المنهج التاريخي والتاريخانية وتحليل الخطاب، والبحوث الجديدة حول مقاربة النصوص. أما الإسلاميون، وهم في الأساس ناشطون سياسيون، فيتمسكون بعقيدة جامدة ويرفعون لواء القوة ويقتلون من يخالفهم. وهم جذريّون يريدون فرض رؤاهم السياسية على المجتمع. إنهم يستحضرون القيم القرآنية كي يمنحوا أنفسهم الشرعية وفرض مشروع سياسي، وهم يخلطون، في الواقع، كل شيء في معمعة أيديولوجية رهيبة، وتأتي سلطتهم من استخدام العنف السياسي. يقدم العلماء بإزائهم وجهاً سلمياً ووداعة من دون اللجوء لأي عنف لإرهاب الناس. لكن حول الموقف الديني والصلة مع الإيمان لا يوجد فارق كبير، في نظر أركون: تميّز الإسلاميين هو في الفعل من جهة، وتبسيط الإيمان من جهة أخرى، علماً أنهم في الحقيقة لا يكترثون كثيراً بالإيمان وتعبيراته، إذ المهم عندهم هو إظهار هذا الإيمان بطريقة مرئية مُستفزة، ويكفي حينها الذهاب إلى المسجد علانية، فمضمون الإيمان هو شأن العلماء وليس شأنهم.
العلماء ووفاقاً لآية قرآنية، هم أولئك الذين تعمقوا في العلم القرآني بحيث باتوا قادرين على الدفاع عنه وحمايته ونقله، وثمة حديث نبوي يعزز من وضعهم كورثة للرسول بسبب تلك المعرفة التي لديهم عن «العلم» ووظيفتهم في نقلها لتغذية الاعتقاد، وبدرجة أكبر الإيمان، فهم في مقام الوسيط والحامي والمُعلِم. ولاحقاً تغيّر الوضع، إذ أصبح بعض العلماء علماء حقيقيين منشغلين بالمعرفة وحتى بالمعرفة الخاضعة للجدل وليس المحفوظة عن ظهر قلب، في صيغة أحاديث وآيات وتفسيرات. كان هناك علماء كبار نظير ابن تيمية والطبري.
العلم في العصر الوسيط، في اعتبار أركون، انتسب إلى التاريخ الأسطوري (mytho – histoire) أكثر من انتسابه إلى التاريخ كما نفهمه اليوم. فالعلماء بناؤو الإيمان الساعين إلى المعرفة كرسوا أنفسهم لعملية النقل، وبعملهم هذا وضعوا تراثاً مُعتبراً، كان استثماراً للعقل ليواكب الإيمان. لكن هذه الدينامية تغيرت اعتباراً من القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديَّين. إذ برز وضع ابستمولوجي جديد هو «حراس الإيمان»، وبقي الوضع كذلك إلى يومنا مع ديناميات مختلفة. ولا يزال العلماء، كما في الأمس، مقطوعي الصلة مع العلم، ولا سيَما العلوم الاجتماعية منذ القرن التاسع عشر. لقد فقدوا الصلة مع دينامية الخطاب النبوي وفقدوا اتساع النظر السياسي والعلمي للعصر الوسيط الكلاسيكي، وخلال فترة ما يُطلق عليه الانحطاط (ق 16 إلى ق 19) افتقدوا التصورات الفلسفية واللاهوتية. واليوم، هناك فئة أخرى هم الدُعاة، ولهؤلاء وظيفة اجتماعية لها عواقب سياسية ونفسية، ولا تقف عند حدّ هداية بعض الأشخاص.
يُقِر أركون إن أعماله المكتوبة للجمهور الأوروبي كانت من أجل أن يُصحح سياسته لا نحو الإسلام كدين فحسب، بل نحو المجتمعات الإسلامية مثل الجزائر وتونس والمغرب، إذ كان يائساً من الوضع في البلدان الإسلامية. في ختام الكتاب، نجد قائمة بأعمال ناقد العقل الإسلامي، التي اهتمت «دار الساقي» بترجمة أبرزها، مثل: «أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟»، و«نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية»، و«حين يستيقظ الإسلام»، و«قراءات في القرآن».


