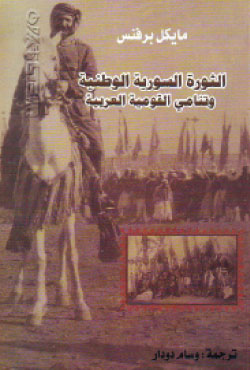يضيء مايكل برفنس في كتابه «الثورة السورية الوطنية وتنامي القومية العربية» (دار قدمس ـــ بيروت ــــ ترجمة وسام دودار) على ملابسات وكواليس الثورة السورية الكبرى التي اندلعت شرارتها من الجنوب السوري عام 1925، لتشمل لاحقاً مختلف أرجاء البلاد. اعتمد الباحث الأميركي على 5000 آلاف وثيقة، أفرجت عنها الخارجية الفرنسية أخيراً، بالإضافة إلى مقابلات أجراها مع شخصيات عاشت تلك الفترة الملتهبة. سنتعرف هنا إلى وجوه غير تلك التي تصدّرت الواجهة. أسماء ظلت مجهولة في السردية السورية الرسمية للثورة، فيما تحوّلت أسماء أخرى إلى أيقونات مقدّسة بما يتلاءم مع توجهات مؤرخين مدفوعين بانتماءاتهم المذهبية الضيّقة. تكشف الوثائق الجديدة حرص حكومة الانتداب الفرنسي على اختزال الثورة بالصراع بين وجهاء الإقطاع المحلي من جهة، ونظام كولونيالي يرغب في نشر المدنية في البلاد من جهة أخرى. يشير مايكل برفنس إلى محاولة النخب السورية، وطبقة التجّار، السيطرة على المتمردين في الأرياف، وسعيهم إلى خطف الثورة.
الصراع الريفي/ المديني، لم يتوقف بجلاء الفرنسيين عن البلاد، بل أخذ شكلاً جديداً على أيدي حكومات الاستقلال من خلال النفي والإقصاء والهيمنة؛ إذ «تكمن أهمية الانتفاضة في أنها جسّدت المناوشات الأولى والصراع على قيادة سوريا بين وجهاء المدن والنخب الريفية الجديدة» يقول. أول التمردات بدأ بحادثة اعتقال أدهم خنجر المتهم بمحاولة اغتيال جنرال فرنسي، وكان قد لجأ إلى بيت سلطان باشا الأطرش (1922)، ما عدّه الأخير خرقاً للأعراف المحلية.
هكذا جمع رجاله وانتظر مرور قافلة عسكرية فرنسية متوجهة من السويداء إلى دمشق لإطلاق سراح ضيفه المتوقع نقله إلى دمشق، وقد تمكّن فعلاً من مباغتة القافلة وقتل ثلاثة جنود فرنسيين، وأسر خمسة آخرين. لم يكن أدهم خنجر موجوداً في القافلة، إذ نُقل إلى دمشق على متن طائرة في صباح ذلك اليوم. بعد هذه الواقعة، وضعت حكومة الانتداب اسم سلطان باشا الأطرش على قائمة الخارجين عن القانون، ففرّ إلى الأردن، فيما أعدمت أدهم خنجر. انطلقت الثورة السورية الكبرى إذاً، من الأرياف، وهي وفقاً لما يقوله مايكل برفنس «حركة جماهيرية شاملة، كما كانت تكتيكاتها العسكرية أكثر راديكالية مما كانت قيادة النخبة على استعداد لاحتضانها. وكانت الثورة بمثابة الشرارة لظهور سياسة شاملة في العالم العربي، وقد شكّلت انهياراً حاسماً لنظام النخبة المتمثل في الساسة الوجهاء».
هناك سرديات متباينة للأحداث الوطنية السورية، أدرجها بعضهم في سياق رؤيتهم إلى دولة قيد التشكّل في مرحلة ما بعد الاستعمار، وشددوا على الأبعاد الوطنية، ما فوق الطائفية التي سعت فرنسا إلى تعزيزها، من دون فحص دقيق للتباينات الاجتماعية وصعوبة تجانسها كأمة. لكن هذه السرديات ستختفي في مطلع السبعينيات، بالإضافة إلى ظهور خيبة أمل في الخطاب القومي. اكتفى السرد الوطني الرسمي ببعض المسلسلات التلفزيونية التاريخية «ولم يعد هناك من مكان لروايات تنافس السرد البطولي الرسمي» الذي تجاهل عن عمد أحد العناصر الجوهرية في الثورة «وحدة أهالي حوران ومجتمع التجار الدمشقيين في تحدّي السلطة».
اشتغل حزب «البعث» في سردياته على اعتبار الثورة الكبرى واحدة من سلسلة طويلة من الثورات في مختلف أنحاء البلاد. ويوضح مايكل برفنس في أطروحته أنّه «لم تكن الفكرة القومية الوحيدة للتعامل مع التمرّد؛ إذ ظهرت في السنوات الأخيرة كتب تؤكد الجوانب الطائفية للانتفاضة». ويتوقف عند دراسات اللبناني حسن البعيني الذي ذهب إلى سرد طائفي صريح للثورة، متجاهلاً صورة «الأمة السورية»، وهو ما نجده في كتابات كولونيالية موازية سوّغت النظرة الطائفية على ما عداها بقصد تسويق فكرة تقسيم البلاد طائفياً. هناك أيضاً كتابات فيليب حتي وحنا بطاطو؛ إذ قدّم الأول مساهمة رائدة في فهم مكائد النخب الحضرية في السياسة القومية، فيما سعى الثاني إلى سبر جذور النظام السوري المعاصر في الريف، وشرح العملية التي تحوّل فيها أعضاء مجتمع طائفي ريفي إلى نخب حضرية جديدة.
انتفاضة الجنوب التي بدأت سلميّة تحوّلت لاحقاً إلى مقاومة مسلّحة نتيجة التواصل بين زعماء حوران، وبعض الشخصيات الوطنية الدمشقية مثل عبد الرحمن الشهبندر، ونسيب البكري. وتكشف وثائق الاستخبارات الفرنسية أن الاحتجاجات الشعبية تجاوزت دمشق نحو حماه، ثم دير الزور، رغم قصف العاصمة مدة يومين كاملين بالمدفعية. لكن هل كانت الهوية الوطنية السورية واضحة في ذهن المتمردين؟ في الواقع، ظلّ الجدل محتدماً بين الثوار «هناك من كان يسعى إلى دولة علمانية لا طائفية، فيما دافع بعضهم الآخر عن رموز الهوية الإسلامية التي استبعدت الأقليات». فشل هجوم الثوار على دمشق، أنهى الارتباط المباشر لأهل النخبة بالتمرّد، وخصوصاً بعد فرار أعضاء «حزب الشعب» خارج البلاد، وانكفاء أصحاب الأملاك والتجار عن المواجهة المسلحة. وهذا ما جعل المتمردين في الريف المحيط بالعاصمة، يفرضون إتاوات على التجار لدعم الثورة.
تكشف إحدى الوثائق عن رسائل إنذار وجّهها القائد العام للثورة في الغوطة عبد القادر سكر إلى تجار في حي الميدان، يفرض فيها «دفع 200 ليرة تركية، وينذركم بالدفع على الفور». وفي رسالة أخرى «يطلب قائد المنطقة منكم أن ترسلوا 200 ليرة تركية، عشر عباءات، بندقيتين ألمانيتين، وكيسين من الخرطوش. تنبيه: نحذركم بعدم التأخير».
خلافاً للادعاءات الفرنسية والاحتجاجات التي قدمها متسلمو هذه الرسائل، فإنّ هذه المطالب، وفقاً لما يقوله مايكل فرنس «لم تكن ابتزازات بسيطة»، وقد آمن الذين كتبوا هذه الرسائل بانتفاضتهم واعتقدوا بوضوح أنّهم في بداية كفاح وطني. في المقابل، لم تخل الانتفاضة من قطّاع طرق كانوا يطلبون الفدية وجمع الأموال باسم الثورة. ويستشهد بما كتبه فوزي القاوقجي في مذكراته «أكدت الأحداث ما لمسته وشعرت به: كان أفضلهم فئة الناس العاديين. كانت كل مصائبنا وهزائمنا بسبب طموحات ومنافسات قادتنا الذين كانوا يهتمون فقط بالظهور والرياء». سُحقت الانتفاضة بعد سنتين من اندلاعها، و«بقي صدى صوت الثوار في محفوظات أعدائهم، وفي ذكريات رفاقهم القدامى الذين قضوا».
الأوراق المجهولة للثورة السورية الكبرى