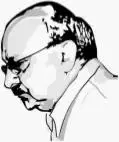الأسابيع الأُولى من عهد ترامب [1]
في تقدير التحليل السياسي، قد يكون تقييم عهد ترامب وتصنيفه مبكراً جدّاً بعد مضيّ أسابيع فقط على تسلّمه الثاني لرئاسة الجمهورية الأميركية. لكنّ ترامب ليس رئيساً عاديّاً ولا يحمل أجندة عادية. هو مقدِمٌ على إجراء تحوّل جذري لم يسبق له مثيل (في السياسة وفي المجتمع)، خصوصاً في السياسة الداخلية، منذ عهد فرانكلن روزفلت الذي حكَم كزعيم أوحَد تجرّأ على تخطّي مدة الولايتَين في الحُكم، قبل أن يمنع الدستور الأميركي في التعديل الثاني والعشرين الرئيسَ من تخطّي الولايتَين في الحُكم (كان في ولايته الرابعة عندما مات في نيسان 1945).
دونالد ترامب رئيسٌ مستعجلٌ جدّاً، ويريدُ أن يهزّ الدولة الأميركية، وأن يهزَّ العالم معها. وهو يتمتّع بتأييد حماسي من قبل البِيض في أميركا، كما حظِيَ بزيادة في التأييد عند الذكور السُّود واللّاتينيّين بسبب الانطباع أنّ الحزب الديموقراطي تخلّى عن الفقراء وذوي الدخل المحدود وحتى عن الطبقة المتوسطة. هذا لا يعني أنّ ترامب والحزب الجمهوري سيأخذان في الحسبان مصالحَ الطبقات الشعبية. الحزبان مرتهنان بالكامل للمصالح الماليّة الكبرى التي تجنح ذات ما يسمى باليمين وذات ما يسمّى باليسار، فيما هو الوسط المائل إلى اليمين في التصنيف الأيديولوجي في علم السياسة.
كان ترامب خلال حملته الانتخابية ينفي بصورة مُطلَقة أن يكون مسؤولاً عمّا يسمّى مشروع 2025 وهو مشروع الانتقال في الحُكم والذي أعدّته مؤسسة «هيرتيج» اليمينية المحافظة. كان يقول إنّه لا يعلم حتى مضمون المشروع ولم يكن يكذب في ذلك. هذا رئيس غير معروف عنه عمْق القراءة والاطّلاع. هو يسهُل عليه إطلاق الشعارات واستثارة مشاعر الجمهور وغرائزه. لكنّ الفريق المحيط به متأثرٌ جدّاً بمشروع 2025. لكن نلاحظ، في التغييرات التي أَقدَمت هذه الإدارة عليها في ما يسمى بإصلاح الدولة، تأثّراً واضحاً بمشروع 2025 الذي يستهدف ما كانت ثورة رونالد ريغان قد وعدَت به، ألَا وهو تقليص الدولة، أو تقليص الحكومة.
وتقليص الحكومة لا يعني إلّا الانتقال إلى الخطّ الذي تتصنّف فيه العقائد الأيديولوجية بين انعدام دَور الدولة في السوق، أي الرأسمالية الصرفة، وبين التدخّل الكبير والنافذ للدولة في السوق على طريقة الأنظمة الاشتراكية. وكلّما تقلّص دَور الدولة تفلّتَ رأس المال وازدادت الفروقات بين الطبقات. رفيق الحريري عندنا مثّل (مع رفيق دربه رياض سلامة) الانتقال إلى تقليص دور الدولة في السوق فيما مثّل نظام فؤاد شهاب مَيلاً نحو تدخلٍ أكبر، وإنْ لم يكن هائلاً، في السوق لتقليل الإجحاف الاجتماعي الذي كان ينذرُ بتفجّر طائفي وسياسي نظراً إلى توازي (لا مطابقة) القهر بين الطبقة والطائفة آنذاك.
يتحدّث ترامب اليوم عن إمكانيّة تخطّي الولايتَين وخدمة ولاية ثالثة (أو أكثر؟). وكلام ترامب يجب أن يؤخذ على محمل الجدّ هنا، خصوصاً في ما يتعلّق برغبته في البقاء في السلطة. هو لم يكن يريد تسليم الحُكم إلى جو بايدن عندما خسر الانتخابات في عام 2020. كادَ أن يُشعِل ثورة شعبيّة لمنع بايدن من تولّي منصب الرئاسة. وبايدن والحزب الديموقراطي لم يأخذا على مَحمل الجدّ القاعدة الشعبية العريضة لدونالد ترامب وحاولا، عبر القانون (والقانون مطواع في الدول الغربية خلافاً للنظريات)، منْع ترامب من خوض الانتخابات أو الفوز بها. ألم نلاحظ أنّ كلّ الدعاوى القانونيّة ضدّ ترامب توقّفت فجأة بعد انتخابه؟ هذه مثل الدعاوى المختلفة ضدّ نتنياهو في إسرائيل. هي تلاحقه وهو يتملّص منها بخفّة (وأخيراً قارن بين وضعه وبين وضع ترامب وأنّ القضاء هو عدوّ لليمين).
الجمهورية الأميركيّة تغيّرت كثيراً منذ أن تولّى ترامب الرئاسة فيها. هو تقريباً يحكُم عبر القرارات التنفيذيّة. والقرارات هذه لا تخالف الدستور الذي لم يحدِّد تماماً نطاق هذه القرارات وصلاحيتها. القرارات التنفيذيّة باتت سلاحاً بيد الرئيس ويتجاوز فيها - لو أراد - الصلاحية التشريعيّة الاستثنائيّة للكونغرس. الدستور يعترف بسُلطة الرئيس التنفيذيّة، مميّزاً بينها وبين السّلطات التشريعية والقضائية في الجمهورية. وبناء على هذه السُّلطة التنفيذيّة، اجترح الرؤساء ما يسمى «القرارات التنفيذية» التي أفرط الرئيس السابق جو بايدن في استعمالها.
هي نظريّاً ليست إلّا قرارات تنفّذ ما شرّعه الكونغرس، من دون زيادة أو نقصان. وهي مرغوبة لأنّها سريعة الإقرار بعد توقيع الرئيس عليها. هي فعّالة في مجال الدعاية السياسية لأنّها تعطي للجمهور الفكرة عن نشاط الرئيس الجديد وجدّيته في تغيير سياسات سَلَفه. لكنّ الدستور لا يسمح أبداً بأن تكون هذه القرارات متجاوزة أو منفصلة عن قرارات السلطة التشريعية والقضائية. وهذه القرارات خاضعة لمراجعة السلطة التشريعية والسلطة القضائية بحُكم الفصل بين السلطات في الدستور الأميركي.
إنّ ما يجري في أميركا في الأسابيع الماضية يتعارض كلّياً مع الدعاية الأميركية عن نفسها حول العالم خصوصاً في سنوات الحرب الباردة
أي إنّ السلطة القضائية تستطيع أن تُبطلَ عمل هذه القرارات عبر الحُكم أو الإفتاء في مخالفتها للدستور. كما إنّ الكونغرس الأميركي يستطيع أن يسنَّ قوانين تُبطل عمل هذه القرارات. لكن الجديد هنا أنّ إدارة ترامب غير تقليدية في كلّ ما تقوم به، حتى في مجال احترام الفصْل بين السلطات. لم يبدر عن هذه الإدارة بعد النيّة في احترام خضوعها لحُكم السلطة القضائية في دستورية القرارات التنفيذية أو عدم دستوريّتها. كما إنّ الكونغرس الأميركي الخاضع لقيادة الحزب الجمهوري متماشٍ كلّياً مع سياسات ترامب.
أمّا المعارضة الديموقراطية، فهي في حالة غيبوبة أو استسلام تامٍّ اعترافاً منها بشعبية الرئيس بين الناخبين البِيض الذين لا يمكن للحزب الديموقراطي أن يعود إلى الحُكم من دونهم. إنّ ما يجري في أميركا في الأسابيع الماضية يتعارض كلّياً مع الدعاية الأميركية عن نفسها حول العالم خصوصاً في سنوات الحرب الباردة. بابتزاز شديد وتبسيط مخادِع قرّرت الحكومة الأميركية آنذاك أنّها تقود ما يسمّى العالم الحُرّ والذي ضمَّ، في ما ضمَّ، حُكم بينوشيه في تشيلي وحُكم فرانكو في إسبانيا وحُكم آل سعود في السعودية.
ما يحصل للحُكم الأميركي اليوم هو دليل آخر على هشاشة الديموقراطية الغربيّة، وأن رئيساً ذا شعبية مثل ترامب أو فرانكن روزفلت (في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية) يستطيع أن يستعمل الآلية الديموقراطية للحُكم بصورة مُطلَقة أو شبه مُطلَقة. نتحدّث عن حكم تسلّطي وعن إخضاع للمعارضة وقمع الأصوات المزعجة. وبما أنّ الكونغرس خاضع للحزب الجمهوري، وبما أنّ المحكمة الدستورية العليا باتت ذات أكثرية محافظة يمينيّة، فإنّه من الممكن لترامب أن يوسّع نطاق صلاحيات الرئيس حتى لو تعارضَ ذلك مع الدستور.
هو مثلاً يستطيع أن يمدّدَ لولاية ثالثة لو استطاع تعديل الدستور بالطريقة المنصوص عليها في الدستور، أي حصول اقتراح التعديل الدستوري على ثلثَي مجلسَي الكونغرس أو ثلثَي المجالس الاشتراعية في البلاد. وعلى النصّ أن يحظى بالموافقة في ثلاثة أرباع الولايات (في مجالسها الاشتراعيّة). شعبية ترامب الهائلة يمكن أن تسمح له بالحصول على هذا الإنجاز غير المسبوق، خصوصاً لو أنّ «إصلاحاته» (بقيادة إيلون ماسك) في تقليص الدولة لاقت الاستحسان والتأييد من قِبل الناخبين، خصوصاً البِيض.
يحاجج الكثير من الأميركيين بأنّ دونالد ترامب ليس عقائديّاً، بمعنى أنّه لا يحمل في داخله أيديولوجية أو فلسفة مُحكمة، وهذا صحيح، كما إنّ مواقف ترامب في مجال القيم الاجتماعية كانت أقرب إلى اللّيبرالية في الماضي. لكنّ ترامب ليس شخصاً بحدّ ذاته، بل هو ظاهرة، بمعنى أنّه يركَب موجة أوصَلته إلى الحُكم وكان يمكن أن توصل غيرَه لو أنّ أحداً عرفَ كيف يتلاعب مثله بمشاعر الناخبين والناخبات البيض وعواطفهم بالمهارة التي امتاز بها، بصرف النظر عن أخلاقيات هذه المهارة.
هل أنّ الجمهورية الأميركية تكشف عن وجهها الحقيقي أم أنّ ترامب، حسب مزاعم الليبراليين هنا، يأخذها في اتّجاه مغاير لتاريخها؟ لو أخذْنا مسألة الحرّيات الديموقراطية لقلنا إنّ هناك تاريخاً شائكاً لحيّز الحرّيات منذ تأسيس الاتّحاد. في البدايات في القرن الأول كان هناك قانون يمنع التعرّض إلى الحُكم. وفي كلّ مراحل الحروب الأهلية في القرن التاسع عشر، أو الحروب الأجنبية على اختلافها، فإنّ الحكومة كانت دائماً تتخطّى الدستور أو تعلّق العمل بأحكامه كما فعل أبراهام لينكلن في الحرب الأهلية.
وفي الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي سنوات ما بعد 11 أيلول، نجحَت الحكومة من دون أيّ معارضة في تقليص الحرّيات وتعليق أحكام الدستور وإصدار تفاسير للدستور تتعارض مع المنطق. التعديل الدستوري الثامن مثلاً يمنع العقوبة «الوحشية وغير المألوفة» ولكن إدارة بوش وتشيني أفتت بأنّ التعديل هذا لا يتعارض البتّة مع عقوبة الإغراق بالماء، والتي قتلت عدداً من المساجين.
الديموقراطيات الغربية في حالة قلق تعدُّه وجوديّاً. تهاوت كلّ مزاعم الدولة اللّيبرالية حتى في الدول المعروفة بالوداعة مثل الدول الإسكندنافية؛ لأنّ منافع دولة الرعاية الاجتماعية كانت مقصودة حصراً للسكان البيض من تلك الدول. لكنّ وفود مئات الآلاف من المهاجرين، خصوصاً المسلمين والأفارقة منهم، استفزّوا (بلَون بشرتهم وبدينهم) الناخبين البِيض الذين لم يقبلوا بمشاركة هويّتهم العرقية في الأساس مع الوافدين الجدد. إنّ الحرب على دولة الرعاية الاجتماعية هي حرب على المهاجرين وتعبير عن إصرار البيض على حصْر ثمار الضرائب بـ«السكان الأصليين» بمفهوم العِرق الأبيض (ولو كانوا قد استوطنوا على حساب السكان ما قبل الأصليين).
انكشاف حقيقة الدولة الديموقراطية في الغرب كان نتيجة طبيعية لافتضاح شعار نهاية الاستعمار وللتغيير الديموغرافي الذي لحق بالمجتمعات الغربية نتيجة وفود مهاجرين من غير البِيض. ولم يكن هناك أزمة أبداً في بدايات الجمهورية الأميركية إزاء توافد المهاجرين البِيض، باستثناء العنصرية الكامنة في داخل منظومة العنصرية البيضاء ضدّ الكاثوليك وضدّ الإيرلنديين. وكان هناك طبعاً عنصرية مؤسّسَة ضدّ السكان الأصليّين والمستعبَدين السُّود والآسيويّين في غرب البلاد. ترامب ظاهرة لها موازاة في معظم الدول الغربية مع تنامي نفوذ ما يسمى باليمين الجديد، وهو اسم ملطّف لحركات فاشية وعنصريّة وحتى نازية بلَبوس جديد.
(يتبع)
* كاتب عربي
«@asadabukhalil» حسابه على إكس