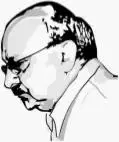يوسف الخازن... الذي رأى إسرائيل

يعيد الباحث غسان الخازن في كتابه «رؤية يوسف الخازن للدولة اليهودية (دراسة تحليلية)» (دار نلسن ـ 2025) تسليط الضوء على مثقف لبنانيّ فذّ إنّما على مثقف استثنائيّ لمع في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
يعود غسان الخازن إلى يوسف الخازن، «الشيخ الكسرواني» المولود عام 1871 في جبل لبنان، هذا الرجل الذي يبدو اليوم مجهولاً أو مغموراً، بوسعنا التجرؤ على وصفه بأنه أحد آخر النهضويين.
في تأريخٍ منزوعة عنه الأسطرة ويخلو من التجميل، إذ يتجرأ المؤرخ على نقد النص الماثل أمامه (كتاب «الدولة اليهودية - وجهة نظر أحد أبناء البلاد» الذي ترجمه)، يتتبع غسان الخازن بدقةٍ وصرامةٍ السياق العام الذي ساد مدة كتابة يوسف الخازن كتيّبه «الدولة اليهودية ــ وجهة نظر أحد أبناء البلاد» (1919).
وبالمعلومات المتوافرة لديه، يؤرخ غسان الخازن، سيرة يوسف الخازن التي تبدو عصيّة على التركيب الكرونولوجي بسبب «غموض يكتنف حياة الشيخ في المراحل التي سبقت إيابه إلى لبنان بُعيد الحرب العالمية الأولى».
لا يهدف تنقيب المؤرخ إلى إعادة إحياء شخصية تاريخيةٍ ونفخ الروح فيها بغية المغالاة، أو التنطع بـ«أصل السلالة» و«أصالة العائلة»، إنما لتبيان الأثر الذي تركته هذه الشخصية النهضوية وراءها. ما هو هذا الأثر على وجه التحديد؟ إنه كتيّب «الدولة اليهودية ــ وجهة نظر أحد أبناء البلاد» الذي كتبه يوسف الخازن عام 1919 بالفرنسية (ترجمه غسان الخازن). هذا الكتاب الذي كان في الأصل محاضرة قدّمها الخازن لجمهور فرنسيّ أثناء هجرته إلى باريس، وقد صدر فيما بعد ككتيّب ضمن سلسلةٍ من المؤلفات طالت الصهيونية وفلسطين نشرتها آنذاك مجموعة باريسية كانت تدعى «أصدقاء الأرض المقدسة».
أنجز يوسف الخازن كتابه الرؤيوي بعد مرور عامين على وعد بلفور، عندما كان المشروع الصهيوني يضمر مبتغاه
تبدو العودة إلى نص يوسف الخازن اليوم راهنةً وملحة ليس بسبب استشراف الخازن للخطر الصهيونيّ الداهم فقط، إنما أيضاً بسبب كيفية نقد الخازن للصهيونية بذاتها. نتحدث هنا على مستوى مقاربة الموضوع وطريقة الاشتباك معه. تبدو قراءة نص يوسف الخازن ملحّة لأن خطابه المائل إلى «التداولية» لهو درس بلاغيّ بإمكاننا الاستفادة منه. لغة الخازن مكثفة، طافحة بالإحالات، تنبثق من سياقٍ ساخن وهي مغرضة لها وظيفة قصدية، يصف الخازن تهديداً وشيكاً مستعيناً بأمثلةٍ تاريخية يسهب بسردها.
الخطاب الذي يلقيه الخازن أشبه برسالةٍ تخبرنا عن مستقبلٍ مرعب قد يحلّ قريباً. هذا أحد «أبناء البلاد»، وهي عبارة استعملها يوسف الخازن عمداً بما تثيره من حساسية عند المستعمر، يكتب ويحاجج جمهوراً أوروبياً على طريقة «الإنسانويين» و«الأخلاقيين» الفرنسيين الذين عرفهم عصر النهضة الأوروبية حول شؤونٍ قوميةٍ ومحليّةٍ سكنته.
مع غسان الخازن إذاً نتعرف إلى يوسف الخازن. الشيخ الذي لم تغره الامتيازات الحاصل عليها، هو القادم من سلالةٍ وصفت يوماً بـ«أمراء جبل لبنان» أخذ لنفسه مساراً مختلفاً لا يتوافق مع أدبيات الأمراء، بل مساراً يثير الجلبة. نقرأ ما تيسر من سيرة يوسف الخازن فنجد أن نهايته تتماثل مع بدايته: في المنفى. هذه ضريبة يدفع ثمنها الثوار عادةً. لم يفتعل يوسف الخازن ثورة ولم يدعُ لواحدة ولكنه لا يختلف عن الثوار كثيراً.
بطاقة تعريف
بعد تخرجه من الكلية الإنجيلية السورية، توظف يوسف الخازن في الإدارة المالية في مصلحة «الدومين المصرية الأجنبية». وسرعان ما تخلّى عن وظيفته، وانغمس في الصحافة كأن جلّ ما أراده هو البقاء على تماس مع قضايا مجتمعه. لقد كان يوسف الخازن رائداً في إصدار الصحف والمجلات، لعلّ أبرزها جريدة «الأخبار» المصرية، ومجلاتٍ مثل «الخزانة الشهرية» (1900) و«بريد الأحد» (1902).
هاجر يوسف الخازن إلى فرنسا هرباً من حكم الإعدام الغيابي الصادر بحقه من الديوان العرفي بسبب نشاطاته المعادية للسلطنة العثمانية، فعمل في جريدة «لو تان» (le temps) الفرنسية ثم عاد إلى لبنان في أواخر عام 1919 وعيّن عضواً في اللجنة الإدارية للبنان الكبير عام 1920.
سيصبح الخازن نائباً في المجلس النيابي لثلاث دوراتٍ متتالية (1922-1925-1929) ولكنه، وهذي نقطة مائزة، لم يختلف مع الفرنسيين على «إدارة الإنتداب»، بل اختلف معهم حول الانتداب نفسه.
يروي لنا غسان الخازن أنّ مقالات يوسف الخازن النقدية الساخرة ضد «مسيو كيلا» حاكم لبنان الكبير آنذاك تحت عنوان «حديث الكلاب» أثارت ضجة واسعة في جميع الأوساط، وقد تحوّل عداؤه تدريجياً من عداء للمنتدبين إلى عداء للدولة المنتدبة. في أواسط الثلاثينيات، عقد يوسف الخازن علاقات وثيقة مع إيطاليا الموسولونية التي زارها برحلة وفد صحافي إلى جانب إسبانيا الفرنكية. وعلى أثر إعلان الحرب العالمية الثانية، اعتقلت سلطات الانتداب يوسف الخازن ووضعته في الإقامة الجبرية في أحد أديرة ريفون، وعطلت جريدة «البلاد» (1934) الذي كان يصدرها في لبنان إلى جانب جريدة «الأرز» (1921).
بعد قيام حكومة فيشي، أخلي سبيل يوسف الخازن وعاد إلى مزاولة نشاطه السابق. إلا أنه عند اجتياح قوات الحلفاء للبنان، فرّ إلى تركيا ثم إلى إيطاليا «ووجد نفسه منفياً من جديد كما كان في مطلع شبابه وكـأن المنفى قدره». بقي يوسف الخازن في إيطاليا حتى وافته المنية عام 1962. من مقرّه في روما، استمرّ يوسف الخازن في نشاطه السياسيّ، إذ اعتاد كل يوم جمعة أن يتوجه إلى جمهوره في الشرق الأوسط عبر «راديو باري» في حديث سياسي مبثوث، محذراً فيه من انتصار العالم الأنغلوساكسوني الذي نكبهم في الحرب العالمية الأولى، ومن وعد بلفور الذي سوف «ينكبهم مرة ثانية في حال انتصاره (العالم الأنغلوساكسوني) مرة جديدة».
تتبدى بعض ملامح يوسف الخازن أمامنا بعد قراءة كتاب غسان الخازن. عدا عن كونه قارئاً نهماً يمتلك مخزوناً ثقافيّاً هائلاً، نكتشف نباهة يوسف الخازن، الصحافيّ الحذق، الذي يُبدع في كشط الزيف والكشف عن المستور. كتب يوسف الخازن «الدولة اليهودية ــ وجهة نظر أحد أبناء البلاد» بعد مرور عامين على وعد بلفور، عندما كان المشروع الصهيوني يضمر مبتغاه. روجت الصهيونيّة نفسها بدايةً باعتبارها: «تبحث عن الأرض المتوافرة. لسنا بصدد انتزاع الملكية أو التعدي على حقوق أحد، بل أن نستقر حيث المكان الشاغر وأن نعيش ولنا أطيب العلاقات بجيراننا».
غير أنّ يوسف الخازن استطاع رصد، منذ البداية، النوايا المخبوءة عند الصهاينة ولم تقنعه المرونة التكتيكية التي أظهرها الصهاينة كأنه كشف خداعهم المتّبع. فقد اعتاد دعاة الصهاينة كتم مرادهم والإعلان عن مطلبٍ يناقض مطلبهم الحقيقي الذي يخفونه.
تعاطى يوسف الخازن مع المشروع الصهيوني بالفجاجةِ نفسها التي يكتنفها هذا المشروع الذي حاول عرّابوه جاهدين ستر حقيقته عبر شعاراتٍ ديبلوماسية براقة مفعمة بالسلاسة. إنّ المشروع الصهيوني عند يوسف الخازن منذ بداية التلويح به، هو استيطانيّ، ينطوي على عنفٍ وعلى رغبة عارمة بالتوسع، أي إنّ المشروع الصهيونيّ مشروع إحلالي بالضرورة.
إنها رؤية «نبوئية» كما يصفها غسان الخازن لسببٍ وحيد: لأنها جاءت عام 1919، ففي ذاك الوقت كان الحديث عن المشروع الصهيوني مهادناً، في أنّه لم يعر اهتماماً للنهم التوسعي عند الصهاينة أو اعتراه الزيغ؛ فالتحليلات برمتها اكتنفها شيء من الريبة تجاه اليهود وغرقت في التفسير الديني. ما يميّز كتيّب يوسف الخازن أنه رأى باكراً الصهيونية باعتبارها مشروعاً تدميرياً، يروم «التحقق في فلسطين وعلى فلسطين» ولن تقف أي حدودٍ حائلاً أمامها لأنها، أي الصهيونية، أشبه بـ«الأجسام الغازية» التي لا تعرف سوى التمدد «بسبب حاجتها الاقتصادية وتطلعاتها القومية».
تعاطى يوسف الخازن مع الصهيونية كمشروع أيديولوجي مترسخ، وهنا ما يميّز هذا الشخص أيضاً: هو لم يأخذ على محمل الجد تقلّبات الدول الراعية للوعد البلفوريّ.
فالخازن ولو أنه كان يتوجه إلى إنكلترا- التي عدّلت في مرحلة الثورة الفلسطينية الأولى من موقفها وأصدرت «الكتاب الأبيض» الذي نصّ على كبح هجرة اليهود إلى فلسطين وغيرها من البنود التي أثارت سخط المؤتمر الصهيونيّ- لم يكن ليعوّل على تعديل أيديولوجيّ ــــ أي يطال خشونة المشروع الصهيوني ــــ قد ينبع من تعديلٍ سياسيّ.
فالمشكلة الأساسية بالنسبة إلى يوسف الخازن، كامنة في مؤتمر السلم المعقود عام 1919 في باريس، وهي سنة إصداره لكتيبه، لأنه «رأى، لتقرير مصير فلسطين، الاستماع إلى الصهاينة ممن لا ناقة لهم ولا جمل في تلك البلاد (فرنسا) بدل الإصغاء إلى ممثلي فلسطين المعتمدين».
«نبوءة» ونصّ طليعي
يعد كتيّب يوسف الخازن «الدولة اليهودية- وجهة نظر أحد أبناء البلاد» نصاً طليعياً. هو ينطلق من توصيف المستشرق الفرنسي إرنست رينان القائل إن الكيان الصهيوني «مشروع معادٍ للطبيعة». بيد أنّ الخازن لا يعلل طرحه وفقاً لتفسيرات غيبيّة أو أخرى جوهرانيّة تخص يهودية الشعب اليهودي.
يكتب في ختام كتيّبه «سيكونون (اليهود) كما قال الشاعر، هم أصحاب المنزل ونحن الضيوف». عداء يوسف الخازن مع المشروع الصهيوني هو عداء مع مشروع «سيّئ الإلهام، رجعي، غير ممكن، بل إنه خطر».
ولأن القيمين على هذا المشروع كانوا حائرين في البداية حول المكان الذي سيرسو مشروعهم عليه، فإن الخازن يرفض بأن يكون «مستقبل إسرائيل في إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان آخر».
كان يوسف الخازن جازماً حيال المشروع الصهيوني. موقفه من المسألة الصهيونية لهو موقف أيديولوجيّ يختزل كالآتي: تهيمن الصهيونية على أراضٍ ليست لها وتستبدل شعباً بآخر، ولا تلبث التوسع فتنحو صوب حدودٍ أخرى لإشباع رغباتها الاقتصادية، ولن يكون بالإمكان احتواء حركة مماثلة. بيد أنّ كثراً في زمن الخازن، وعلى رأسهم الملك فيصل، ارتؤوا أنه بوسعهم الانصهار مع المشروع الصهيوني، أو التعايش معه، وخصوصاً إذا اقتصر الأمر على فديرالية تدار وفقاً للحكم الذاتي كما نظّر جورج سيمنه.
ليست الأمور بهذه السذاجة عند يوسف الخازن. كان الخازن يفنّد التصاريح الواردة بوصفها خطاباً يحمل أيديولوجيا قائلها. على سبيل المثال، نجده يعود إلى ما أورده كاتب يهودي يدعى إسرائيل زانغويل، ليبني موقفه المفارق انطلاقاً مما أفصح به الأخير.
يكتب الخازن: «يعتقد زانغويل أنّ بالإمكان استبعاد العنصر غير اليهودي المقيم في فلسطين عبر دفع تعويض مالي له وإن رفض هؤلاء المساكين الإذعان يتغلب زانغويل على أمرهم بأن يعلنهم بحماسة المبتدئين، بدواً، ويطبق عليهم مبدأ انتزاع الملكية بالقوة. وقد تتساءل بعض النفوس الورعة إذا ما كان القانون يعتبر ملكية البدو أقل قدسية من ملكية الحضر وإذا ما كان هؤلاء المساكين بدواً فعلاً؟ لكن هذه الأسئلة تبقى عديمة الفائدة منذ لم يعد هناك «قضاة في برلين» (عبارة تعني انتصار الحق على القوة)».
وسط نصّ زاخر بالإحالات، مغمس بالاستعارات الأدبية البديعة التي يستعين بها يوسف الخازن لصقل حججه ولفتح أفق جديد في المسألة المطروحة، نراه، بين الفينة والأخرى، يخفف من حدّة الإيقاع ويتكئ على البداهة. هكذا نراه يجيب عن تساؤل بديهيّ: «باستطاعة العالم الذي عاش ألفي سنة بلا دولة يهودية أن يستمر في الاستغناء عنها قرابة عشرين قرناً أخرى».
ما الفائدة إذاً من إنشاء دولة يهودية؟ ما النفع منها، وما هو الجديد الذي ستجلبه يا ترى؟ يعود يوسف الخازن إلى تصريح لهيرتزل أفاد فيه عن قيام دولةٍ علمانية عقب إنشاء الوطن اليهودي، ثم يجلب الخازن قول لحاخام فرنسيّ تساءل على إثر إعلان هيرتزل «كيف يمكن لدولة علمانية أن تكون يهودية؟». يطرح الثاني سؤاله ممتعضاً فيما يوسف الخازن يشهر الحقيقة بوجه ادعاء هيرتزل زائف. يلعب يوسف الخازن مع المفارقات، نحن إزاء بلاغة أسلوبية رفيعة.
إنّ المشروع الصهيوني عند الخازن بكل ببساطة مرفوض رفضاً قاطعاً لأنه معادٍ للطبيعة؛ لأنه توسعيّ: «لنلاحظ أن المنظمات الصهيونية لا تكتفي منذ الآن باستعمار فلسطين، بل هي تدخل سوريا وشبه جزيرة سيناء في إطار مشاريعها». على أنّ يوسف الخازن رأى أنّ هذا التوسع يقوم بشكلٍ رئيسيّ على استبدال شعب بآخر. سيفرض المشروع الصهيونيّ «سيطرة عرقية أو دينية» يكتب يوسف الخازن. ولأن الصهاينة سيستعينون بأفكار وتصورات مستمدّة التلمود لتسويغ سياستهم ولتبريرها، نقرأ مطالعة طويلة يفكك فيها يوسف الخازن المزاعم التوراتية ويقلب المسائل رأساً على عقب.
إذا كان اليهود لهم الحق بفلسطين، فإن العرب أيضاً لهم الحق في الأندلس، ما رأيكم في هذه المعادلة؟ ثم إنّ «المقدّس» الذي ينسبه اليهود لأنفسهم في فلسطين، هو «المقدّس» أيضاً عند المسلمين والمسيحيين في فلسطين. على هذا النحو، يحرص يوسف الخازن على نسف التهويد الصهيونيّ، أو اليهودية الصهيونية، أي كيف استقطبت الصهيونية اليهودية وجعلتها ديناً لمشروعها، إنه يقوم بالأحرى بتفريغ العناصر الجامدة بسبب «قدسيّة» تعزز من قوّة الصهيونية وتعطيها دفعاً وألقاً.
منذ البدء، لا يفرّق يوسف الخازن بين موطن يهودي ودولة يهوديةٍ. المشروع الصهيوني واضح عنده: هناك كيان قيد الإنشاء، وسيكون كياناً يهودياً، وسيكون عنصرياً، وإننا لنصنفه اليوم بالـ«أبارتهايد»، لأنّ يوسف الخازن رأى عام 1919 أن حلّ الدولتين يصبو إلى مزحةٍ سمجة، ففي «دولة يهودية لا تضم تحديداً إلا يهوداً و «أمميين» (تعبير يقوله اليهود على من هم من غير اليهود) فذلك محال».
كان يوسف الخازن على ثقةٍ تامّة برغبة المشروع الصهيوني العمياء في التمدد والتوسع، وجازماً في طبيعة هذا المشروع العنيفة الذي يفضي إلى سحق كل «آخر» لا يتطابق مع «شعبه». وقد علم بأنه «لا يمكن إيقاف مثل هذه الحركة التوسعية، متى سالت شهيتها، في منتصف الطريق».
غير أنّ الخازن المتيقّن من القوّة التدميرية والجامحة التي يكتنزها المشروع الصهيونيّ في جوهره رفض أن تكون إسرائيل «قوة عمياء بيد بريطانيا». فقد انتبه الخازن إلى أنّ الجولات المتعددة التي سبق وقام بها هيرتزل في الماضي، والتي بدأها مع القيصر الألماني وأكملها في زيارته للسلطان العثماني عارضاً عليه تسديد ديونه، يكشف عن تحرّكٍ فوضويّ في ظاهره إنما يشي بانتهازيةٍ تماثل انتهازية سائر الدول.
وسائر الدول هنا تعني الغرب، وعلى رأسها بريطانيا التي ترعى المشروع الصهيونيّ، هكذا نجد يوسف الخازن يرسم أولاً ملامح هذا المشروع وفقاً لأداء مهندسه؛ هيرتزل الانتهازيّ، كما نجده يتعاطى مع المسألة الصهيونية من منطلق «قيم الأنوار» التي عرفها هذا الغرب ويعمد إلى مقاربة هذه القيم مع طبيعة المشروعٍ الصهيوني.
قبل فضحه لادعاء هيرتزل الزائف بأن مشروعه سيكون علمانياً، والعلمانية هي سمة من سمات «الأنوار» الأوروبية التي ستكون إسرائيل «امتداداً» لها، عرّج يوسف الخازن على «حق الشعوب في تقرير المصير»، فنجده يكتب «لا يمكن إعطاء شعب حق تقرير مصيره بفرض تسلط شعب آخر عليه»، ويضيف «ليس لعبارة «أمم» (الفلسطينيون) وقعها الأفضل في المسامع من عبارة رعية بل العكس هو الصحيح، في نظام متسامح بعض الشيء يمكن للمرء أن يتخلى عن انتسابه إلى الرعية ليصبح مواطناً».
لقد استطاع يوسف الخازن ليّ عنق الصهيونية، وفضحِها عبر تفكيك ماهيتها، وقد استطاع استشراف معنى إسرائيل قبل قيامها بما يقرب من الربع قرن. بيد أنّ يوسف الخازن لم يكن على مستوى اليقين نفسه حول إمكانية تحققها، أي في نجاح المشروع الصهيوني وإقامة إسرائيل من عدمها. بقي في كتيّبه متلكأً حول ما إذا كانت إسرائيل ستبصر النور أم ستكون مشروعاً مجهضاً، على أنه توقّع، في حال «انوجدت» أن يكون استقبالها عسيراً. هكذا نقرأه يختم نصّه في تذكير قرائه بالصراع الذي وقع بين العبرانيين والكنعانيين: «الزنابير المعاصرون الذين ينطلقون ضدنا ليطردونا تدريجياً من إرث آبائنا. هؤلاء قد يقعون على ياعيلات حيث يتوقعون راحابات».
بعد سرده لسيرة يوسف الخازن بشكلٍ مقتضب، وإحاطته بالسياق الثقافي والسياسي الذي كان سائداً فترة كتابة يوسف الخازن لكتيّبه، يعلّق غسان الخازن نقدياً على ما ورد في كتيّب «الدولة اليهودية ــ وجهة نظر أحد أبناء البلاد».
لا يقع في فخ محاكمة الماضي انطلاقاً من الحاضر، أو في خطأ إسقاط معايير يفرضها الراهن على ماضٍ لا يشبه الحاضر بشيء. يكتفي بتقويض ما يبدو شاذاً في نصّ يوسف الخازن للحفاظ على نقاء الطرح وجودته. هو أولاً يقرّ بأن يوسف الخازن كان مخطئاً في اعتباره أنّ المشروع الصهيوني قد يتعثر ويحول دون تحققه.
لقد راهن يوسف الخازن على إمكانية كبح الدول الأوروبية للنزعة التوسعية الإسرائيلية، بيد أن ما حدث هو أن «معظم هذه الدول نأت بنفسها عن نقد إسرائيل إن لم تدعمها» كما يقرّ غسان الخازن.
والأخير دحض تصوّر يوسف الخازن المتعلق باليهود بوصفهم أحفاد العبرانيين، وهذا ليس رأياً إنما حقيقة علمية. اليهودية ليست مجموعة إثنية أو عرقية، كما إنّ علاقة العبرانيين بالسكان العرب الفلسطينيين أقرب إليهم من علاقتهم باليهود الحاليين المتناثرين حول العالم.
يقال هذا اليوم مع الأخذ في الحسبان منشأ يوسف الخازن والمنابع التي استقى منها ثقافته، فتركيبة يوسف الخازن الفكرية تعود إلى عصر النهضة في زمن لم تكن فيه الأنثروبولوجيا قد تخمّرت بعد. لكن في زمن يوسف الخازن أيضاً، لم توجد شاشات التلفزة، رغم ذلك فقد رأى حقيقة إسرائيل؛ الكيان الإحلاليّ الذي نشاهده على حقيقته في البث المباشر كل يوم.
توضيح
غسان الخازن
نص «الدولة اليهودية في فلسطين» يخاطب جمهوراً فرنسياً رفيع المستوى الثقافي، ذاك أن مؤلفه الشيخ يوسف الخازن قد أكثرَ فيه من الاستشهاد بحشدٍ من الأحداث التاريخية وبأسماء جمهرة من الأعلام وبمروحةٍ واسعةٍ من المؤلفات الأدبية المشهورة والمغمورة وبمقتطفات من المقاطع التوراتية والأحاديث النبوّية، ما يجعل الإحاطة بكامل إشارات النص وتلميحاته عصيّة على أيّ قارئ.
لقد قمت أثناء تعريبي للنص الفرنسي بكتابة تعليق على كل الوقائع التاريخية والأسماء والكتب والاقتباسات الواردة فيه والتي وجدتها ضرورية (خاصة أن قسماً كبيراً منها ليس له صدى إلا في الذاكرة الغربية) حتى يتمكن أيُّ قارئٍ عربيِّ من الإلمام بكامل ما عناه نصّ الخازن والتمتع بمميزاته.
لم أكتفِ بذلك بل تعمدت التوسع والإسهاب في التعليقات حتى تتجاوز طبيعتها المقتضبة وتتحول إلى تأريخ مفصل للمشاريع الصهيونية منذ القرن الثامن عشر حتى صدور وعد بلفور.
آمل أن أكون قد وفقت في مسعاي. وقد اعتمدت في الهوامش المصطلحات الآتية:
النجوم وهي هوامش النص الأصلي الفرنسي.
الأرقام وهي تعليقاتي على النص المترجم.
والأرقام الرومانية وهي تعليقاتي على بعض مصطلحات الترجمة.
كما ميزت في النص بعض العبارات بالحرف الأسود الغامق دلالة على ورودها بالخط المائل (écriture Italique) في النص الأصلي الفرنسي.