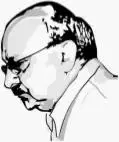شوقي بزيع: بيروت «عاصمة»... الشعراء
 هو ذا صاحب «مرثية الغبار» مقتفياً أثر المدينة في قصائد أقرانه... ومتوقّفاً عند المحطات التاريخية والسياسية والعمرانية التي جعلت منها فضاءً مفتوحاً، ومختبراً عربياً للحداثة. النتيجة «بيروت في قصائد الشعراء ــ دراسة ومختارات» (دار الفارابي)
هو ذا صاحب «مرثية الغبار» مقتفياً أثر المدينة في قصائد أقرانه... ومتوقّفاً عند المحطات التاريخية والسياسية والعمرانية التي جعلت منها فضاءً مفتوحاً، ومختبراً عربياً للحداثة. النتيجة «بيروت في قصائد الشعراء ــ دراسة ومختارات» (دار الفارابي)حسين بن حمزة
لم يستسهل شوقي بزيع الموضوع حين فكّر في إنجاز أنطولوجيا توثّق حضور بيروت لدى شعراء لبنانيين وعرب وأجانب، خاطبوا المدينة وذكروها في قصائدهم. كان في استطاعته أن يجمع عدداً من القصائد. يُدبِّج لها مقدمة صغيرة مكتوبة على عجل، وينتهي من الأمر. لكنه رغب في أن تكون لمختاراته قيمة مرجعية تتجاوز مناسبة «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» التي أُعدّ الكتاب ضمن فعالياتها.
هكذا، استهلّ كتاب «بيروت في قصائد الشعراء ـــــ دراسة ومختارات» (دار الفارابي) بدراسة طويلة ومعمّقة تحتل 75 صفحة، عرض من خلالها سيرة متقطعة أو محطات تاريخية وسياسية وعمرانية للمدينة، بالتوازي مع سيرة ومنعطفات واستعارات شعرية صنعتها المدينة نفسها. كأن القارئ مدعوّ إلى سيرتين متداخلتين للمدينة التي قُيِّض لها أن تتميز بمكانة فريدة في مخيّلات الشعراء، وأن يُكتب عنها أكثر مما كُتب عن أي مدينة عربية أخرى.
يبدأ بزيع من زمن ما قبل الميلاد، ويمرّ على أحداث تاريخية مفصلية مرت بها بيروت، قبل أن يصل إلى زمنها الراهن. نقرأ ونتأكد من فكرة أن التاريخ الحقيقي لبيروت يبدأ من لحظتين أساسيتين: نهاية القرن التاسع عشر، مع إنشاء «الكلية السورية الإنجيلية» (الجامعة الأميركية حالياً)، والجامعة اليسوعية، وظهور أولى الصحف والمجلات، وتطور الحركة المسرحية، وظهور أول رواية عربية، وصدور مؤلفات لكتّابٍ نهضويين... ثم حقبة الخمسينيات والستينيات التي لطالما وُصفت بأنها العصر الذهبي لبيروت ولبنان برمته. لقد قامت بيروت على طبقات عديدة ومتلاحقة من التراكم الثقافي، لكنها انتظرت حتى الخمسينيات لتصبح مختبراً حقيقياً للحداثة، وفضاءً مفتوحاً تتجاور فيها كل الاقتراحات الممكنة في الشعر العربي.
إذا سلمنا بأولوية هاتين اللحظتين وركّزنا على الثانية، لأن المدينة لا تزال تتنفس من هوائها وترى نفسها في مرآتها، فإن في الإمكان تأريخ الحضور البيروتي بطريقة مختلفة تأخذ ما أنجزه بزيع بالاعتبار... لكنها تفسح في المجال أمام الحديث عن تأثير بيروت في تجارب الشعراء الذين عاشوا فيها، سواء كانوا لبنانيين أو عرباً. لا ننسى هنا أنّ بيروت هي المدينة العربية الوحيدة التي تعني للقادمين إليها أكثر مما تعنيه لأهلها. التأثير الذي نعنيه هنا هو الانعطافات والتبدلات العميقة التي أحدثتها بيروت في الشعر نفسه، وليس فقط حضور اسمها في الشعر.
اعتمد بزيع ورود اسم بيروت في القصيدة معياراً لحصولها على حق الحضور في الأنطولوجيا، والواقع أنه المعيار الوحيد هنا، إذْ لا يمكن العثور على معيارٍ آخر يمتلك القوة والوجاهة نفسها. المشكلة أنّ هذا المعيار يجعل القيمة الشعرية للأنطولوجيا خارج نفوذ صاحبها وذائقته. بسبب المناسبة، تسرّبت قصائد متفاوتة الجودة إلى الأنطولوجيا. لو كان الأمر مرهوناً بذائقة صاحب «سراب المثنى» لاستبعد قصائد عدّة يعرف أنها ضعيفة شعرياً، إلا أنه سمح بها لأنها حائزة دفتر شروط الأنطولوجيا. في المقابل، لم يتجاهل بزيع ما سيُقال عن جودة اختياراته، فذكر في المقدمة أن بعضهم غلّبَ «الموضوع على الشكل والتطريب على المعنى، والتوظيف السياسي الحماسي على الكثافة والتقصّي وجمالية الحرية»، مشيراً إلى أن القصائد التي كتبت عن حصار بيروت 1982 «ضاهت في غزارتها عدد القذائف التي سقطت على المدينة في الفترة نفسها».
مرتين أو ثلاث مرات، أجاز بزيع حضور قصائد تخاطب بيروت من دون أن تسميها صراحةً. لم تكن تلك القصائد كافية لكسر المعيار،
القصائد عن الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، تفوق عدد القنابل
لعلَّ حضور بيروت الأكثر تأثيراً موجود هنا، في كونها فضاءً يقصده الشعراء لكي يحكوا بها مخيلاتهم الريفية، كما فعل لبنانيون قدموا إليها من الأطراف، أو مخيلاتهم المحلية، كما فعل عربٌ أغوتهم سمعة المدينة التي كانت الحداثة والحرية والأفكار الجديدة والجريئة تتسكع في صحفها ومقاهيها وشوارعها، ومطابعها ومكتباتها ومسارحها وصالاتها التشكيلية.