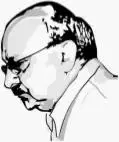عمارة طرابلس العثمانية: الولاء للسطان
من لا يعرف طرابلس فسيظنّ للوهلة الأولى أنها (فقط) ساحة صراع عبثي بين باب التبّانة وجبل محسن، وأنها مدينة منغلقة، لكنها مدينة عريقة ويمتد تاريخها بعيدا جدا، وحظيت باهتمام عمراني لافت في العهد العثماني، ما أبقاها موالية للباب العالي حتى الرمق الأخير.
في خطوة ترمي إلى إطلاع الجمهور البيروتي على تاريخ طرابلس العريق، وتحديداً لجهة العمارة التاريخية والآثار والأبنية التراثية الغنية فيها، استضاف (أمس) «مركز يونس إمرة الثقافي التركي» في بيروت البروفسور الدكتور خالد تدمري، ليحاضر عن «تخطيط مدينة طرابلس وعمارتها التركية».
محاضرة تدمري هي أول نشاط ثقافي يقوم به المركز الثقافي التركي بعد فترة توقيف قسرية بسبب أزمة مخطوفي إعزاز. حضرها سفير تركيا في لبنان إينان أوزيلدز، الى جانب سفير أذربيجان، وعدد من المهتمين «كي يتسنى لهم الاطلاع على تاريخ طرابلس العريق، بعيداً عن الصورة النمطية السلبية السائدة عنها حالياً»، وفق تدمري.
عرض تدمري صوراً قديمة معظمها بالأسود والأبيض تعكس الواقع العمراني في طرابلس خلال العهد العثماني، وتطرق إلى الحقبة المملوكية التي سبقت العهد العثماني، باعتبار «الحقبتين مترابطتين تاريخياً».
يقول تدمري إن «بناء طرابلس الحالية يعود إلى أكثر من 700 سنة، عندما حرّر المماليك المدينة من الصليبيين في 26 نيسان 1289»، وأن المماليك «عندما بنوا طرابلس، لم يشيدوا سوراً حولها لحمايتها، بل بنوها على شكل قلعة كبيرة لجهة تلاصق البيوت وارتفاعها طبقتين عن الأرض، وتميزها بضيق أزقتها وتعرّجها، كما بنوا مآذن مساجدها على شكل أبراج عسكرية للمراقبة، كانت مربعة الشكل، كما هي حال مئذنة الجامع المنصوري الكبير، الفريدة من نوعها في العالم الإسلامي».
ويضيف تدمري أن «المماليك بنوا أيضاً أبراجاً للمراقبة داخل أزقة مدينة طرابلس القديمة كانت مخفية عن الأنظار، كما جعلوا لها 12 باباً كانت تغلق عند غروب شمس كل يوم، وقد سميت أحياء بأكملها بأسماء هذه البوابات، وأشهرها أحياء باب التبانة، باب الحديد، باب الرمل وباب المهاترة وسواها».
وفي ما يخص الميناء بعد التدمير الذي تعرض له أثناء تحريره من الصليبيين، فإن المماليك بنوا فيه 7 أبراج لمراقبة البحر، أشهرها «برج الأمير المملوكي برسباي»، الذي يعرف حالياً باسم «برج السباع».
بعد وصول العثمانيين إلى المنطقة، إثر معركة مرج دابق عام 1516، أكملوا وفق تدمري «مخطط بناء وتوسعة المدينة عمرانياً، مع بعض الخصائص والمميزات، وخصوصاً أن البيوت العمرانية العثمانية تشبه البيوت العربية».
لم يكتف العثمانيون بالاهتمام بطرابلس القديمة، التي يبلغ طولها نحو 3 كيلومترات، وعرضها كيلومتر ونصف كيلومتر تقريباً، إنما «قاموا بتوسعتها لأسباب بيئية وصحية وبسبب التكاثر السكاني».
أول ما قام به العثمانيون عمرانياً، وفق تدمري، هو «توسعة بعض أحياء المدينة القديمة، مثل أحياء الحدادين وباب التبانة وباب الرمل، وصولاً إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع بداية عصر التنظيمات العثماني الذي تأثر عمرانياً بالنمط العمراني الأوروبي».
أبرز شاهد على النمط العمراني الجديد، حسب تدمري، هو ساحة التل التي «خططت لتكون ساحة رئيسية في المدينة، وبنيت في محيطها الأبنية الحكومية الرسمية، كالسرايا العثمانية التي هدمت أوائل ستينات القرن العشرين، ومصارف ومقاه وفنادق ودور لهو، وقصور وفيلات فخمة لأثرياء وأعيان طرابلس، أبرزها قصور نوفل وكرامي وعريضة وسواها».
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أيضاً، يوضح تدمري أن طرابلس «توسعت باتجاه أحياء الزاهرية والقبة والحدادين وشارع العجم ومحيط مقهى موسى في باب الرمل، كما شقت طرقات وشوارع الحديثة مثل شارع عزمي، وشيدت سكك الحديد». ومن أبرز فنون العمارة التي شيدت خلال العهد العثماني خان الصابون، الذي يقول تدمري إنه «جرت توسعته خلال عهد السلطان سليمان القانوني، الذي أوصت زوجته «حُرُم سلطان» (أو السلطانة هيام كما أوردها مسلسل حريم السلطان التركي الشهير) بأن يُخصّص ريعه للحرم المكي الشريف، وبرج ساعة التل (وهو واحد من خمسة أبراج بنيت خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني، في خمس مدن كانت تابعة للسلطنة العثمانية لأنها كانت مؤيدة لها)، والجامع الحميدي في طرابلس والميناء، وخان العسكر (أكبر خانات طرابلس الذي رُمم أخيراً)، وجامع محمود بك، والبوابة الرئيسية للقلعة، والتكية المولوية وسواها».
وكدلالة على أهمية ما تركه العثمانيون خلفهم من فنون العمارة في طرابلس، وما يجعلها «أهم مدينة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط لجهة غناها بالأماكن والمواقع الأثرية والتراثية» على حد تعبير تدمري، «تشييدهم360 مسجداً وجامعاً ومدرسة وزاوية وتكيّة، على عدد أيام السنة، تدرّس فيها العلوم الدينية والدنيوية، ما جعل طرابلس تحمل منذ ذلك الحين، بامتياز، لقب «مدينة العلم والعلماء».