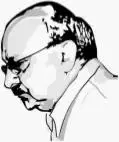ما لم نتعلّمه من غسّان كنفاني

أدرك الموساد الإسرائيلي باكراً كم كان وجود غسان كنفاني (9 نيسان/ أبريل 1936 ــــ 8 تموز/ يوليو 1972) في إطار القيادة السياسية للعمل الثوري الفلسطيني خطراً فادحاً على الكيان العبري.
لذلك، لم يتوان عن تصفيته في بيروت في عمليّة معقدة، ولم يكن حينها قد تجاوز الستة والثلاثين عاماً من العمر. التقييم الإسرائيلي الدقيق لخطورة صاحب «عائد إلى حيفا» والمستند إلى رصد منهجي مكثف، لم توازه في أي مرحلة استفادة فلسطينية/ عربيّة من إسهاماته النظريّة المتقدمة. بل انشغل الناس بشهادته المبكرة المؤلمة، ومنتجه الأدبي (ثلاث مجموعات قصصية، وأربع روايات، وثلاث مسرحيات، كما عدد من اللوحات الفنية)، أو ركنوا إلى حملة التشويه المتعمد لشخصه عبر نشر مراسلاته الغراميّة مع كاتبة سورية عديمة الموهبة.
لكنّ غسان المفكّر والمنظّر كان أكبر بكثير من صورة الشهيد المغدور أو الأديب الموهوب أو العاشق/ الزوج الخائن. لعلّ إعادة قراءة معاصرة لمقاربته لثلاث قضايا أساسيّة في العمل الثوري الفلسطيني تكشف عن قدرة متجدّدة لأفكاره على تجاوز دور النصوص التأسيسية التاريخيّ إلى مكانة الأداة الثوريّة الماديّة الخلاقة في أيدي الجماهير العربيّة الفلسطينية.
أولى تلك المقاربات كانت بشأن دور المثقف والعمل الثقافي (بأشكاله) في الصراع السياسيّ (أنظر كتابيه: «أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966» و«الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948»)، إذ أشار إلى مركزية مساهمة الأدباء والشعراء والصحافيين والمترجمين قبل حرب 1948 في جعل فلسطين «مركزاً ثقافياً عربياً مهماً» ورفع قيمة المقاومة والتوعية بطبيعة المعركة مع العدو بين الكتل الشعبيّة رغم الجهد المنظم المتراكم للعثمانيين ومن بعدهم الإنكليز في تجهيل الشعب الفلسطيني ومعاندة محاولات نشر المعارف العصرية والوعي القومي بين أبنائه.
كما التقط تلك الصلة الجدلية ما بين الثقافة والسياسة، وقدّر أن ولادة الصهيونية السياسية كانت بدرجة ما «نتيجة لإرهاصات أدبية صهيونية مبكرة ما لبثت أن اندفعت، بعد ولادة الصهيونية السياسية، لتصير جزءاً أساسياً منها» (انظر كتابه «في الأدب الصهيوني»).
المقاربة الأخرى هي توظيف التحليل المادي والاجتماعي لتقييم الحدث التاريخي واستخلاص العبر منه في إطار حتميّة تطوير العملية الثوريّة إن كان لها أن تقود إلى التحرير. ولعل النصّ القصير الذي كتبه في ثورة 1936-1939 يمثل واحداً من أقوى الأعمال التي درست تلك اللحظة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وكانت أقرب نقطة وصلها الفلسطينيون من النصر.
وكانت في الوقت عينه المنعطف/ الهزيمة القاسية التي استندت إلى نتائجها العصابات اليهوديّة في فرض ولادة كيانها السياسي بعد أقل من عقد.
لقد بيّن كنفاني أن الفلسطينيين خسروا ثورتهم رغم نضالاتهم الهائلة فيها بسبب خيانة القيادات المرجعية الفلسطينية وقصر نظرها، لا سيما جناح الخارج (وكان يقيم وقتها في دمشق)، وتواطؤ الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين، ووحدة حال الحلف الإمبريالي ــ الصهيوني.
المقاربة الثالثة تتعلق بموقف غسان النقدي الثاقب من مسألة التطبيع مع الكيان العبري. إذ أكد في عدد من مقالاته الصحافيّة أنّ الفلسطينيين «في حالة حرب مع هذا العدو»، وأنّ مقاطعتهم له «ليست نابعة من موقف وجداني، لكنها متأتية من طبيعة المواجهة التي نعيشها ضده، وهذه المقاطعة هي بحدّ ذاتها وجهة نظر، وموقف، وشكل من أشكال الصدام»، منبهاً من أنّ «أجهزة الإعلام البرجوازية تستخدم مثل تلك (الأنشطة التطبيعيّة بمختلف أشكالها) للإمعان في لعبتها التي تحقق لها في نهاية الأمر سطوةً أشد على عقول جمهورها وتسهل استدخال الهزيمة».
اللافت أنّ هذه الدروس التي لم نتعلمها من كنفاني، استوعبها الإسرائيلي جيداً، ففكّك طبقة المثقفين الفلسطينيين وحوّلها بالمال الخليجي/ الأوروبيّ من ضمير الشعب وقادة وعيه إلى جزء من شبكة العرب الجدد، مهمتها الترويج لاستدخال الهزيمة، وتسخيف العمل المقاوم.
كما درس بتعمّق وتجرد ـــ بحدود ما يمكن أن يتقبّله العقل الصهيوني المتزمت ـــ أشكال المقاومة الفلسطينية بما فيها ثورة 1936-1939، محللاً إياها إلى عواملها الأساسية ومستخلصاً نتائج بُنيت عليها إستراتيجيات مكّنت الدولة العبرية من تحقيق انتصارات متلاحقة في صراعات تالية. وكذلك استقصد سحب سلاح المقاطعة من يد العمل الثوري المنظّم ونقله إلى أيدي نشطاء هواة من ساكني الغرب، ما أفرغه من معناه، وحدّ من تأثيره، وأفقده قيمته الرفيعة في تشبيك الجماهير الفلسطينية والعربيّة، وحتى الغربيّة، مع المقاومة.