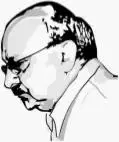آلموت: عن تراثنا الباطني
تمكّنت أخيراً من قراءة رواية «آلموت» لفلاديمير بارتول، وقد كنت أسعى للحصول عليها من زمنٍ لأنني أعرف أن أكثر خرافات المخيلة الشعبية في الغرب (وبالتالي عندنا) عن الإسماعيلية النزارية و«فرقة الحشاشين» مصدرها هذه الرواية بالتحديد. المشكلة هي أنّ الرواية تمرّ، منذ صدورها في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، في «أطوار»: يصعد الاهتمام بها وبأبطالها بسبب أحداثٍ أو ظروفٍ سياسية معيّنة، فتصدر كتابات عنها ومراجعات وطبعات جديدة، ثمّ «تُنسى» لسنوات حتّى تكاد نسخها وترجماتها تُفقد. والمرّة الأولى التي حاولت فيها الحصول على الرواية، قبل عشرين سنة في مكتبة جامعية كبيرة، تبيّن أن لديها منها نسخة واحدة قديمة، وعليّ الانتظار أيّاماً لكي ترسلها من مخزنٍ خارجي، وحين وصلت أخيراً اكتشفت أنها باللغة السلوفينية.
لحسن الحظّ، نحن نمرّ منذ سنواتٍ في طور اهتمامٍ متجدّد بأسطورة «الحشاشين»، وقد صدرت ترجماتٌ جديدة للرواية -بالعربية وغيرها- ومسلسلٌ موّلته الإمارات أثار نقاشاً واهتماماً (بل إن هناك لعبة فيديو شهيرة، أصبحت سلسلة ناجحة، استوحت موضوعها من «الحشاشين» و«شيخ الجبل»). المهمّ هو أنّه أصبح من السهل الحصول على نسخة مقرصنة من «آلموت» بأيّ لغة، وتكتشف بسرعةٍ وأنت تقرأها كم أنّ أمين معلوف قد استوحى منها في روايته «سمرقند»، وتحديداً في الجزء الأوّل -المثير- منها، وأنّ إضافته فعلياً تتمثّل في القسم الثاني، البليد والوعظيّ. هذا مصداق جديد على مقولة، أعتقد أنها لألبرت حوراني، عن أنّ «اللبناني هو غالباً ليس سوى مقلّد، وليس حتّى مقلّداً جيّداً، لأنّ التقليد المتقن يحتاج إلى بعض الأصالة».

لا أريد أن أُفهم خطأ: أنا لا أحقد على أمين معلوف، على العكس تماماً، المشكلة هي أنّي كنت أحبّه. وقد قرأت رواياته الأولى كلّها، حين كنت غرّاً وساذجاً، بإعجابٍ ونهم، وهي كانت مدخلي للرواية التاريخية. ولكن، حين لا تعود غرّاً وساذجاً، تفهم مقدار السياسة والذاتية و«الكلام إلى مَن هم أعلى» في مسيرة معلوف، حتّى في أعماله الأدبيّة، بل وتحديداً فيها. علينا أن نتذكّر هنا أن معلوف كان صحافياً، وعمل في «جون أفريك» (أي إنّه مؤدلج، ويعرف تماماً ما يفعله)، ومع ذلك فإنّ مساره مفهوم: مَن مِن مثقّفي الجنوب لا يحلم باعترافٍ من الغرب على هذا المستوى؟ وأن يتمّ تعيينه في دور الشرقيّ الجيّد هناك، وتصبح مرافقاً للرئيس في رحلاته الخارجية، وتذهب إلى جزيرة جميلة، حين تريد الكتابة، من أجل المزاج؟ ثمّ، بعد هذا كلّه، تبتسم بفخرٍ ورضى في زيّك التنكّريّ المضحك وأنت تصبح عضواً في الأكاديمية الفرنسية؟ هذه، بالمقاييس اللبنانية، قصّة النجاح القصوى (أعود دوماً إلى موضوع لباس معلوف في الحفل، مع أنّه ظاهراً تفصيلٌ صغير، وذلك لسبب هو أنني اكتشفت أنّه كان في وسعك أن تذهب إلى الأكاديمية في ثيابك العاديّة، كالناس الطبيعيين، وسيجري انتسابك والاحتفاء بك بالطريقة ذاتها. ولكنّ لديك أيضاً خياراً -وهو ما فعله معلوف- بأن تحوّل الأمر إلى حفلة تنكّرية، وستدفع هنا من جيبك عشرات آلاف اليوروهات حتى تظهر باللباس التاريخي والسيف وعلبة السعوط - وهذه الأمور عندي تقول الكثير عن شخصية المرء). نعود للقول بأنّ مسار معلوف وخياراته هي «عقلانية»، بل و«نموذجية»، باعتبار خلفيته وسياقه ومؤسّسته، وهذا تحديداً هو ما يصنع بيني وبينه مسافة جذرية.
كنت أنوي، لو توفّرت لي أيّام إضافية في شمال إيران، أن أزور بقايا قلعة آلموت، وهي على مسافة ساعات قليلة من طهران عبر مدينة قزوين. ولكن لَم يتبقَّ شيءٌ تقريباً من الحصن، والناس يزورون أساساً لاستكشاف الموقع الجغرافي الجميل والفريد في جبال «ألبرز»: القمّة المشرفة المهيبة وتحتها يمتدّ وادٍ صغير منبسط، تحفّه الجبال من كلّ جوانبه وفي وسطه قرية وحيدة. رواية بارتول، بالمناسبة، أفضل من «سمرقند» على أكثر من مستوى: السّرد، تعدّد الشخصيات وغناها، القصّة داخل القصّة...، على الأقلّ هناك إلى اليوم اختلافات ومذاهب في تحليل مقصد بارتول من روايته: التفسير الغالب هو أنها كانت تحذيراً من الفاشية الصاعدة في أوروبا وسحر الأيديولوجيا ومشعوذيها، البعض الآخر - على العكس تماماً - يقرأها كرسالة للشعوب الخاضعة (كالسلوفينيين أيّامها) عن كيفية التنظيم ومقاومة المحتلّ، وهناك أيضاً مَن يقول إن بارتول كان يكتب، ببساطةٍ، عملاً أدبياً خيالياً ورواية مثيرة عن البشر وحالاتهم. هذا النوع من النقاش لا يمكن أن يدور حول «سمرقند».
التاريخ المفقود
المسألة الأساس هنا ليست أدبية ولا تتعلّق بالروايات، بل هي اهتمامٌ قديمٌ لديّ، ونظريّة لي تقول إن التراث الإسماعيلي الفاطمي هو بمثابة «ثقب أسود» في التاريخ الإسلامي، وذلك بمعنيين: أوّلاً، بمعنى أن معرفتنا به قليلة وناقصة، وهو تاريخٌ قد «طُمس» مع نصوصه وأدبياته إلى حدٍّ بعيد، وثانياً، بمعنى أنّك لا يمكن أن تبني سردية متّصلة ومتكاملة ومفهومة عن التاريخ الإسلامي من غير أن تفهم مكان الدعوة الإسماعيلية فيه. هناك مفارقة في كمّ الآثار الفاطمية التي لا تزال حولنا، من مدينة القاهرة نفسها إلى مؤسساتٍ عُمّرت إلى اليوم كالأزهر والزيتونة، فيما الذاكرة التاريخية عن الفاطميين ضعيفة وملتبسة. بل ينسى كثيرون اليوم أنّه، لفترة طويلة في التاريخ الإسلامي، كان تعبير «شيعي» يحيل غالباً إلى الإسماعيلي أو الزيدي، وليس إلى الإمامي، إذ كانوا هم الأكثرية والبارزين وذوي السلالات الحاكمة. هذا الجهل له أسباب: الإسماعيليون لم يكونوا يكشفون عن عقائدهم الحقيقية في الكتابات التي تُنشر للعموم، وقد قام أعداؤهم، في الوقت نفسه، بمنع وإتلاف الكثير من آثارهم. وقد مرّ المذهب نفسه بعدّة أطوارٍ وانقسامات، حتى إن المدارس الإسماعيلية السائدة اليوم ليست نفسها الإسماعيلية الفاطمية «القديمة» التي كانت أيّام المعزّ والحاكم والمستنصر. الكثير من أعمال الإسماعيليين الأوائل قد فُقدت، ونحن لا نعرفها إلا عبر كتابات خصومها. تخيّل أن تتعرّف إلى فيلسوفٍ أو فقيهٍ حصراً عبر النصوص التي تهاجمه، إذ لم يصلك منه نصٌّ واحد في صيغته الأصلية، ومعروفٌ كم كان النقاش بين الفرق أيّامها حادّاً وشرساً، والجميع يحاول تشويه الخصم بأي طريقة والتشنيع عليه. حتّى في الأكاديميا، لم نبدأ بدراسة الإسماعيلية جدياً حتى أوائل القرن الماضي، حين فُتحت مكتباتٌ عائلية ودينيّة للإسماعيليين في الهند وسوريا وغيرهما (نزارية ودرزية ومستعلية) وتمكّن الباحثون، للمرّة الأولى، من الكتابة عن الإسماعيليين عبر أدبياتهم هم. وفي العقود الماضية، أغدق متموّلو الطائفة وأثرياؤها على دعم الدراسات الإسماعيلية في الجامعات الغربية، وبخاصة في بريطانيا، فأصبحت تصدر أخيراً كتبٌ جديدة، بانتظام، عن الإمبراطورية الفاطمية والمذهب والجماعات الإسماعيلية - وإن كان النقص لا يزال كبيراً (لو أنّي أريد أن أدرس الإسلاميات في بريطانيا اليوم، لاخترت بلا تردّد موضوعاً له علاقة بالإسماعيلية، اذ لن ينقصك التمويل).
على الهامش: تعلّمنا الكثير عن الإسماعيلية القديمة وتحليل نصوصها بالاعتماد على المذاهب الحالية. موضوع النّسب مثال، إذ تجد في الكتابات الإسماعيلية أن «فلان ابن فلان»، فيما الأوّل عربي والثاني أعجمي، ويستحيل أن يكون والده، وهو ما كان يحيّر المؤرّخين. إلى أن فهمنا في القرن الأخير، عبر الدروز، أن النّسب عند الإسماعيليين يمكن أن يكون مادياً أو روحياً، بمعنى أنّ من يدرس على يديك ويتلقّى علمك هو أيضاً ابنك، ويمكن أن ينتسب إليك ويرث اسمك وموقعك (وتجد صدىً لذلك في «رسائل إخوان الصفا»، حيث توصي الرسائل الأستاذ بأن ينفق على تلميذه من دون أن يعتبر ذلك صدقة أو يحمّله منّة، تماماً كحال الأب مع ابنه).
فلنعد إلى «نقطة بداية»، القرنيْن الهجرييْن الثالث والرابع. هي مرحلة تكوّن الإسماعيلية وأكثر الفرق في الإسلام، وكان قسمٌ كبيرٌ من هذا المخاض الفكري والسياسي يدور تحديداً في بغداد. خلق الوضع «الإمبراطوري» الجديد جملةً من الإشكاليات والتناقضات في المجتمع العبّاسي: أصبحت بغداد عاصمة «عالميّة»، تتركّز فيها الثروات وبجوارها جموع الفقراء، اختلط العرب والموالي بعضهم ببعض، وظهرت أسئلة جديدة بين الناس والنخب عن شرعية الحكم والحاكم ومصدر القانون ومفهوم العدل... كما يقول برنارد لويس في كتابٍِ قديمٍ له من الستينيات عن «الحشاشين»، فإنّ الدعوة الإسماعيلية قد تمكنت من تقديم ما يشبه «إجابة متكاملة»، روحيّة وسياسيّة واجتماعيّة، تجاه هذه القضايا (والإسماعيلية ذاتها قد نشأت عن التحام أكثر من تيّارٍ وجماعة، وإن كان يبدو أن «الخطّابية» كان لها الأثر الأكبر في تكوينها الفلسفي، ممتزجةً بجذرية أتباع إسماعيل. يزعم بعض الباحثين أنّ كلّ المفاهيم الباطنية تقريباً - الحلول، المعنى الباطن للشرع... - تجد جذورها في الخطّابية المبكرة؛ وهي نسبةً إلى أبي الخطّاب، الذي كان أحد تلامذة الإمام جعفر الصادق قبل أن ينفصل عنه ويؤسّس جماعته الخاصّة).
في الوقت نفسه، كانت الدعوة مشروعاً سياسياً يخطّط على المدى البعيد، وهدفه النهائي استبدال خلافة بغداد بدولة الإمام العادل، وله استراتيجية وتنظيم تراتبي معقّد من الدعاة المحترفين لنشر المذهب في النواحي والأقاليم. هذا المزيج بين العقيدة والتنظيم كان، بمعنى ما، متفوّقاً على كلّ ما حوله، كأنك استدخلت نظاماً حديثاً على منافسةٍ من عصرٍ سابق. وهو سرّ النجاح السريع للإسماعيلية في القرنين التاسع والعاشر، حيث تحوّلت دعوة عقائدية بحت (لا عصبية مقاتلة ترفدها أو كيان سياسي)، خلال أقلّ من قرن، إلى إمبراطوريةٍ تحكم شمال أفريقيا ومصر وسوريا، وتتهيّأ لوراثة العباسيين. كتب الباحث الجزائري عبدالله بن عمارة سلسلة مقالات قيّمة عن صعود الدولة الفاطمية وانحدارها، وأهمّ ما فيها العديد من الإحالات «الباطنة»، عبر سطور السرد التاريخي، إلى إشكاليات عصرنا الحالي وتحدّياته - وهي لن تخفى على القارئ الفطن.
كان هناك دعاةٌ اختصاصهم نشر بذور المذهب في مجتمعٍ غريبٍ عليه، ولديهم منهجيّة تدرّبوا عليها للعمل في مثل هذا السياق. أمّا حين يصل عدد المؤيدين إلى حدٍّ يسمح بالتحرّك العلني، فأنت تستبدل الداعية بآخر من مستوىً أعلى مُهيَّأ لتلك المهمّة، وهكذا. وهناك خطابٌ موجّهٌ إلى الخاصّة والمثقفين، ووسائل أخرى للوصول إلى العامّة والجمهور. هكذا تمكّنت الدعوة من الانتشار وبناء «قواعد» لها تحوّلت إلى دول وتوسّعت: في اليمن بدايةً، ثم المغرب الأوسط، فتونس فمصر. في رواية «آلموت» مقاطع طريفة يتمّ فيها تعليم الدعاة فنون المُحاجَّة واجتذاب المريدين: «اجعله يشعر أنك تكترث لرأيه وأن أفكاره مهمّة... إن كان فارسياً يعاني من نير السلاجقة فأخبره بأنّ الإمام سوف يخلصه من احتلال التّرك، وإن كان أجنبياً ظلمه أهل البلد فقل له إنّ خليفة القاهرة سوف يستردّ له حقّه وينتقم من الظالمين». في الوقت نفسه، الدولة يقودها الإمام، وهو موجودٌ أو متجلٍّ بيننا، فمسألة الشرعيّة محسومة. والإمام، في النظريّة، ليس حاكماً مطلقاً، بل هو «الأساس»: يقود في القاهرة ما يشبه «مجلس حكم» تتمثّل فيه السلطة الدينية والعسكرية والإدارية وهم يشكّلون، مجتمعين، ما يشبه «عقل الأمّة»، الكيان الذي يحفظ المبادئ الأساسية للدعوة ويسير عليها. هذا كان «النموذج»، على الأقلّ، في المرحلة الذهبية للدولة الفاطمية، قبل أن يجري عليهم ما جرى على بني العبّاس، فيصبح الخليفة صورياً والمركز ضعيفاً والعسكر يحكمون، وتبدأ رحلة الانحدار.
حديقة الفردوس وخيط السماء
عندي أيضاً ما يشبه «فرضية»، لا أدلّة حقيقية عليها، مفادها أن المدرسة الأصولية عند الشيعة وتطوّر الحوزة في القرون الماضية قد استوحت، بشكلٍ مقصودٍ أو غير مقصود، عناصر من التجربة الإسماعيلية (على الهامش: كانت للإمام الطوسي، الأب الروحي للمدرسة الأصولية، كتابات إيجابية عن الدعوة الإسماعيلية - بحسب بول ووكر في كتابه عن الفلسفة الشيعية المبكرة). وبول ووكر، في كتابه الذي يشرح فكر الفيلسوف السجستاني، يقدّم لنا نظرة نادرة عن كوزمولوجيا الإسماعيليين وتأثرها بالأفلوطينية المحدثة. في منظومة السجستاني مثلاً أربع مراتب تمثّل منابع الحقيقة: أولاً «الناطق»، وهو النبي الذي يعطيك الشّرع، ثمّ «الأساس»، أي الإمام الذي يفهم الشّرع ويفسّره، وبعده «اللواحق» و«الأجنحة»، وهي مراتب الدعاة والمفكرين. هنا لا يجب أن ننسى أنّ الإمام ليس مجرّد قائدٍ سياسي، والإمامة ليست منصباً وراثياً. بل إنّ قداسة الإمام، قبل أيّ شيء آخر، هي في أنّه يفهم المعنى العميق للدين، الذي توارثه الأنبياء والرّسل عبر العصور، ويحفظه؛ ولذلك هو القادر على أن يشرح لك مفاهيم القانون والحقّ والعدل، وهنا تكمن العصمة.
ما أريد الوصول إليه هو أنّ الصورة عن الإسماعيلية التي دخلت المخيال الاستشراقي، آلموت ومصياف و«شيخ الجبل»، تمثّل مرحلةً متأخّرة، بعد أواسط القرن الحادي عشر، كان قلب الحركة الإسماعيلية فيه قد بدأ يخبو. هي كانت مرحلة ضعفٍ وانحدار مقارنةً بالماضي، وقد بدأت الانشقاقات تضعف المذهب، ويظهر فيه أكثر من إمام يختلف عليهم الأتباع. حتى الإنتاج الفكري في إيران وسوريا، يقول برنارد لويس، كان أضعف بكثير مقارنة بالمراحل الإسماعيلية السابقة، إذ لم تعد الدعوة موجهةً إلى النخبة والمفكرين وعلية القوم (بعد مرحلةٍ كان فيها بعض أبرز المفكرين والفلاسفة المسلمين إسماعيليين بدرجةٍ أو أخرى).
الطابع السرّي للحركة في إيران وسوريا، وتراث الاغتيالات، لم يكن مقصوداً بل جاء عن اضطرار. في بداية الدعوة في إيران، مثلاً، تمكّن أحد الدعاة الكبار من تحويل أغلب البلاط الساماني في كرمان إلى المذهب، وكان الهدف ببساطة هو الاستيلاء على السلطة علناً، كما في اليمن وشمال أفريقيا ومصر. ولكنّ نكبةً حلّت بهم إثر وفاة الحاكم نزحوا بعدها إلى الأطراف والجبال الحصينة. وفي سوريا، بالمثل، كانت قاعدة الدعوة النزارية بدايةً في حلب ثمّ دمشق، وهناك أيضاً حصلت ضدّهم عمليات «اجتثاث» قاسية أبعدتهم عن مراكز السلطة ودفعتهم إلى السرّيّة. شهد هذا السياق الجديد تطرّفات عقائدية وسط هذه الجماعات المنعزلة، كمثل موجة «تعليق القانون» عند بعض المريدين لاقتناعهم بأن الإمام قد ظهر وأعفاهم من الشعائر والحدود. وفي هذا السياق أيضاً أصبح الاغتيال أداةً برع فيها النزاريون وفي بناء سمعةٍ ترهب الأعداء، حتى أصبحت بمثابة «رأسمال سياسي» في حوزتهم. من الروايات المبكرة عن «الحشاشين» في الوثائق الأوروبية نصٌّ لرحّالةٌ غربي وصل إلى كاراكورم - عاصمة الخان في منغوليا - في أواسط القرن الثالث عشر، ليجد أنّ الخان الأكبر مختفٍ منذ مدّة لا يظهر لأحد، والسبب هو أنّه قد نُمي إليه بأنّ سيّد آلموت قد أرسل لا أقلّ من أربعين فدائياً لاقتناص روحه. والسفارة الوحيدة الموثّقة بين حسن الصبّاح والأوروبيين كانت لوفدٍ وصل إلى أوروبا من آلموت في الفترة ذاتها ليعرض تحالفاً ضدّ الهجمة المغولية (وهي، كما نعرف، انتهت باجتثاث مراكز الإسماعيليين وقلاعهم في إيران). وقد ظلّ قادة النزارية، ورثة الصبّاح، مقيمين في إيران حتى عهدٍ حديث نسبياً، أوائل القرن التاسع عشر، حين تورّطوا في مؤامرةٍ فاشلة ضدّ الشاه انتقل بعدها الآغا خان إلى الهند البريطانية وأعاد تأسيس جماعته في بومباي.
ختاماً، عندي تعليقٌ عن مفهوم «حديقة الحشاشين» وفكرة اصطناع الفردوس على الأرض ومحاكاته. فكرة أنّ زعيم الطائفة كان يخدع المريدين ويوهمهم بأنهم في الجنّة هي بالطبع خرافة، ولكنها لا تخلو من بذرة حقيقية. في الشّرق، تاريخياً، كانت الحدائق والقصور تُبنى، بشكلٍ قصدي، كتمثيلٍ لمفهومنا عن الفردوس. هذه ليست نزعة كونيّة. حين ازدهر فنّ تصميم الحدائق في أوروبا في القرن السابع عشر، مثلاً، كان يتمّ تصفيف الأشجار والنباتات ضمن أشكالٍ هندسيّة - مربّعات ومستطيلات ودوائر - لا تجدها في الطبيعة؛ والقصد هنا كان تجسيد سطوة الإنسان وسيطرته على الطبيعة، وليس النظر إلى ما خلفها. جنّة الفردوس، في الديانات الشرقية القديمة، هي أعلى مراتب الطبيعة الدنيوية في اكتمالها وجمالها، وصورتها في عالمنا هي الرياض والجنائن.
تعبير «الفردوس» أصلاً هو كلمة إيرانية قديمة تعني الحديقة، والكلمة جذرها أكادي استخدمها البابليون والآشوريون في صيغة «باراديسو»، وهي للدقّة تحيل إلى مفهوم «الحديقة المغلقة»، المكان المسوّر والتجربة الحصريّة التي لا ينالها إلّا الخواص. أجمل الحدائق في إيران تجدها في مدنٍ صحراوية كانت محطّات على طرق التجارة، كاشان ويزد وكرمان، بحيث تصل القوافل بعد سفرٍ طويلٍ في البوادي لتجد نفسها، فجأةً، في بستانٍ أخضر يفيض بالماء، وقنوات وبرك وأكشاك مزخرفة للاستراحة، وقد جلبت الأشجار من مختلف الأقاليم. حديقة «فين» في كاشان، وهي اليوم على لائحة «اليونيسكو»، أرادها الشاه لتكون استراحة له وسط الطريق الصحراوي الطويل بين أصفهان وطهران، مكانٌ يستبدل فيه الحرّ والغبار بـ«جنينة» خضراء. وهذه الحدائق كانت محاطةً بأسوارٍ تحميها من الرمال والجوّ المحيط، لتعطيك انطباعاً مع دخولها بأنّك قد انتقلت إلى عالمٍ آخر، حتى المناخ والهواء فيه يختلفان، ناهيك عن المشهد والألوان. الحديقة، إذاً، في تراثنا، تحمل معنىً يتجاوز المظهر الخارجي البرّاني، بل هي أيضاً سعيٌ للإنسان -قديم- في أن يفارق عالمه الظاهر، بقصوره وباطله وتعبه، وأن يفتح عينيه على السماء.
* كاتب من أسرة «الأخبار»