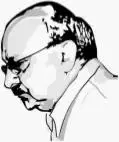إيران للمبتدئين: أسئلة الاستثناء
الفكرة هي أنّه، حتى بالنسبة إلى من كبر في بلدٍ وعاش فيه ويعرف لغته، فهو لن يعرف ويعاشر إلا شريحةً محدودة من الناس والمجتمع، فكيف بالزائر الغريب؟ هذا مع العلم بأنّ الأفراد في العادة يستسهلون الكلام باسم بعضهم البعض. قليلٌ من الناس سيقدّم انحيازاته قائلاً «هذا رأيي ورأي أصدقائي ومحيطي»، بل هو سيضمن لك أنّه ينقل صوت «الشعب اللبناني» أو غيره (أو «صوت 80% من الناس»، حين يتواضع). بالمعنى المعرفي، التجربة المباشرة محدودة بطبعها، بل هي تصبح في حالاتٍ غشاءً وسدّاً.
فلنتكلّم قليلاً عن مفهومٍ مثل «شمال طهران». كيف توصّف هذا الجزء من المدينة؟ الانطباع الذي كنت أحمله عن أنّه «الحي الثري» أو «الجزء الراقي» من طهران ليس دقيقاً، فهو أكبر من ذلك بكثير. وهو أيضاً ليس «مجمع أثرياءٍ» مستحدثاً ومغلقاً، على طريقة الكومباوندات والمدن الجديدة في مصر وغيرها. قد يكون التوصيف الأدق أنّ منطقة شمال طهران هي «مدينة ضمن مدينة»، جزءٌ أصيل من العاصمة ولكنّه - في الوقت ذاته - له عالمه الخاص. عليك، حتى تفهم معيار القياس، أن تتخيّل أحد الأجزاء «الفخمة» من بيروت، أحياء الأثرياء في الأشرفية أو رأس بيروت مثلاً، ثمّ تضاعفه وتمدّده على كامل مساحة العاصمة اللبنانية. في وسعك أن تسير لعشرين كيلومتراً أو أكثر، من مجمع قصور سعد آباد مثلاً إلى مجمع قصور نيافاران، وأنت لا تزال داخل «شمال طهران». هنا لا توجد طبقيّة، الكلّ برجوازي فما فوق: شوارع هادئة تظلّلها الأشجار، تعبرها سيارات أجنبية لا تراها عادةً في إيران، مع مبانٍ سكنية فخمة على الجانبين. على النواصي والتقاطعات تنتشر المطاعم والمقاهي التي تتنافس على جذب الطبقة المرفهة، ومولات «بوتيك» صغيرة تحتضن المتاجر الغالية التي يرتادها هؤلاء. المساحات الخاصّة والمنازل والحدائق محميّة بحرصٍ عن أعين الغرباء، تمنعك من استراق النظر إلى أيّ شيءٍ في الداخل (لقد حاولت). وعلى طريقة حيّ جورجتاون الثري في مدينة واشنطن، فإنّ مترو الأنفاق الذي يغطّي غالبية المدينة بكثافة لا يمرّ بعد في شمال طهران (في جورجتاون رفض السكان وصل حيّهم بنظام المترو لكي لا يسهّل مجيء «الغرباء» إلى منطقتهم، وفي طهران هناك خطط مستقبلية لخط مترو يعبر الأحياء الشمالية من الغرب إلى الشرق، ولكنه لم ينفذ بعد).
في الأساس، فإنّ المرتفعات التي تشكّل «شمال طهران» اليوم كانت تعتبر، بوضوح، خارج الحدود التقليدية للمدينة. حتّى حيّ تجريش الذي يعتبر فاصلاً بين وسط طهران وشمالها كان أساساً بلدةً مستقلّة خارج العاصمة (ولهذا لديه بازاره الخاص). أمّا سعد آباد والزعفرانية وغيرها، فقد كانت بلدات اصطيافٍ للطهرانيين لوقوعها على سفح جبل دمفاند المهيب. على ذكر سعد آباد ومجمع القصور الملكية فيه، منها ما بناه القاجار ومنها ما أضافه آل بهلوي، فإنّ «القصر الأخضر» (وهو في الأساس لأرستقراطي قاجاري أراده بيتاً صيفياً له وسط الغابات والجداول هناك)، قد يكون من أصغر القصور الملكية في إيران ولكن لعلّه من أجملها: بني من حجرٍ أخضر نادرٍ جيء به من منجمٍ في زنجان، يخلط تصميمه بين الأوروبي والشرقي، ومن الواضح أنّه لم يبنَ للبهرجة والاستقبال بل لمتعة أصحابه (ولكنّ رضا شاه الأب، حين مكث فيه لسنةٍ واحدة في بدايات حكمه، كان لا يزال يصرّ - على عادته أيّام العسكرية - على النّوم في غرفة الشاه الوثيرة أرضاً بجانب السرير).
عودةً إلى موضوعنا، حين تمرّ أمامي الكتل السكنية في شمال طهران، فإن السؤال الأوّل الذي ينتابني هو: مَن، تحديداً، يسكن في كلّ هذه الشقق؟ أقصد أي فئات اجتماعية تتمثّل هنا: أرستقراطية قديمة؟ تجّار؟ أثرياء جدد؟ أطرح السؤال على صديقي، وهو أستاذٌ في جامعة طهران، فيقول لي إنّه مزيج: «لديك نخب من قبل الثورة، ولديك نخب من بعد الثورة. لديك العائلات القديمة بالطبع، ولديك التجّار. وهناك أيضاً الصناعيون والمدراء في الشركات الكبرى، وستجد الكثير من المحترفين الناجحين الذين يخدمون كلّ هؤلاء، أطباء، مهندسون، الخ». السؤال هنا ليس بديهياً أو بسيطاً، وهذا له سبب: في دول الجنوب عامّةً، فأنت حين تمرّ في مثل هذه الأحياء، من السهل عادةً أن تتنبّأ بهوية سكّانها ومنابتهم، وهم أساساً الطبقات الأكثر اتصالاً برأس المال الدولي: المستوردون مثلاً، وكيل «غوتشي» و«مرسيدس» و«ماكدونالدز»، الموظفون في الشركات الأجنبية، المغتربون الأثرياء، أصحاب المصارف والعقارات، والطبقات الفاسدة في السلطة التي ترتبط بهؤلاء. ولكن في مكانٍ مثل إيران، حيث البنية الاقتصادية «استثنائية»، والعلاقة مع رأس المال الدولي صراعيّة، والكثير من القطاعات التي تكون مألوفةً ومهيمنة في دول الجنوب هي هنا ضعيفة أو حتّى متوارية، فإن الحالة خاصّة، وعليك أن تفهمها عبر شروطها، وهذه القاعدة لا تنطبق فقط على تركيبة الرأسمالية الإيرانية.
عالمٌ خارج العولمة
المسألة هي أنّك حين تنظر إلى إيران حصراً عبر ثيمات الإعلام السائد واهتمامات «الأمن القومي الأميركي» (صواريخ، حرس ثوري، محافظون وإصلاحيون، غطاء الرأس، ولاية الفقيه)، فقد تغفل عن جوانب كثيرة من «استثنائية إيران». في إيران، مثلاً، تجد نفسك في إحدى الدول الأخيرة في العالم التي لا تزال تعيش على نمط «الاكتفاء الذاتي» والصناعة الوطنية. كأنك عدت إلى الستينيات وزمن سياسات التصنيع واستبدال الواردات. كلّ شيءٍ تقريباً مصنوعٌ محليّاً. حتّى الماركات الغالية الموجّهة إلى الأثرياء، التي تجدها في المولات الفخمة شمالي طهران، هي ماركات إيرانيّة. وإيران اليوم، موضوعياً، بلدٌ صناعيٌّ بامتياز، بمعنى أنّ أكثر من ثلث اليد العاملة تشتغل في القطاع، وهي من النسب المرتفعة جداً على مستوى العالم. أينما كنت هناك، ستجد حولك شخصاً يعمل في مصنع الصلب أو المصفاة أو شركة السيارات. أساساً، فإن البنية السعرية في السّوق، والفارق في قوة العملة بين الداخل والخارج، يجعل من شراء أي منتجٍ أجنبيّ تقريباً (باستثناء الهواتف) طرحاً غير منطقيٍّ - حتى للميسورين. على مستوى الاستهلاك الفردي، ستجد مقابلاً محليّاً لأيّ سلعةٍ رائجة في السوق الدولي، وتقليداً أميناً لكلّ ماركةٍ شهيرة أو تصميم عالمي أو سلسلة مطاعم. هناك كتابٌ يستحقّ أن يكتب عن مفارقة أن تكون بلداً محاصراً معاقباً ولكن، بالمقابل، ليس على شركاتك الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على الإطلاق (سيكون عليك، في بعض الحالات، بأن تقبل بكاتشاب اسمه Henz بدلاً من Heinz، ولكن كل شيء آخر فيه يشبه المنتج الأميركي إلى درجة التطابق).
هذه «حالة استثناء» لا ينتبه إليها أيضاً الكثير ممّن هم في الداخل وقد اعتادوا المشهد ويعتبرونه بديهياً. في أصفهان، حين يكون الطقس مناسباً، تخرج المدينة بأكملها إلى الساحات وضفاف النهر وبولفار المشاة الطويل (الذي كان يوماً الشارع الرئيسي في المدينة، بناه القاجار على الطريقة الأوروبية وهو اليوم بمثابة متنزّهٍ تحفّه الأشجار وقنوات الماء). أين تجد في العالم اليوم شارعاً تتراصف على جانبيه، لكيلومترات، مئات مطاعم الوجبات السريعة، ولكن ليس بينها اسمٌ أجنبيٌّ واحد؟ تخيّل اختلاف المشهد لو أنّ السياسة لم تمنع «كي اف سي» و«برغر كينغ» وأخواتها من الدخول إلى البلد واستيطانه (كان الميسور، على الأرجح، لا يأكل إلّا فيها، والفقير يوفّر ويقتصد لكي يرتادها حين يخرج). والإيرانيون - على الهامش - لديهم تقليدٌ مثيرٌ في الوجبات السريعة؛ هم - كاللبنانيين - يأخذون الأطباق العالمية ثمّ يقومون، بثقة ووقاحة، بتعديلها على هواهم وإخراج نسختهم الخاصة منها. وفي محلّات الفلافل المنتشرة قد تتمكّن من الكلام مع البائع بالعربية، فصاحبه غالباً أهوازي.
على ذكر العلاقة المقطوعة مع أغلب السوق الدولي، فإنّ أشدّ المعارضين الذين ستجدهم في إيران هم تحديداً تلك الفئات التي ترتبط بهذا السوق وبالتبادل معه بشكلٍ وثيق، وقد ضربت العقوبات موقعها بشكلٍ كامل (مادّياً واجتماعياً وسياسياً). حين أتكلّم عن «معارضين» هنا، فأنا لا أقصد مَن يصوّت للإصلاحيين وينتقد الدولة، بل أقصد فئة تعارض النظام بالكامل ومن أساسه. وهي موجودة، وأكثرها لا يشارك أصلاً في السياسة العامة والانتخابات (أو يقول لك إن المرة الأخيرة التي صوّت فيها كانت لخاتمي). تخيّل أن تكون دليلاً سياحياً مثلاً، وقد عرفت حياتك سنوات دعةٍ ورخاء، وأجانب كثر يدفعون بالدولار، ثم جاءت العقوبات وقضت على «نمط إنتاجك». «كانت هناك طائرة أسبوعية من فيينا»، يقول لي الرجل في شيراز، «ليس إلى طهران، إلى شيراز مباشرة!». وكانت كلّ طائرة تأتي بمئتي سائح أوروبي، ينزلون جميعاً في الفندق الذي يعمل به، ويحصل منهم وحدهم على عدّة جولاتٍ مجزية كلّ أسبوع. أمّا اليوم، فهو يبحث على تطبيق «سناب» («أوبر» الإيراني) عن زبائن محليين يوصلهم إلى مقصدهم بنصف دولار، ويتحيّن الزائر الأجنبي النادر من لبنان أو العراق. لو كنتَ مكانه فأنت، لأسبابٍ واضحة وبديهية، لن يهمّك شيءٌ في العالم وفي السياسة إلّا أن تعود الطائرة النمساوية إلى شيراز، وبأيّ شكل.
تعليقٌ في شأن السياحة: يدور بيننا، منذ زمنٍ، نقاشٌ مستمرّ مع صديقٍ جزائري، له نظرية كاملة في العداء للسياحة الأجنبية، وهو يعارض المبالغة في تشجيعها في بلادنا. حجته هنا معقدة بعض الشيء، تحيل إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسياحة، وكيف تغيّر أخلاقيات العمل عند الناس، وما يريده الأوروبيون حقّاً حين يزورون دول العالم الثالث الفقيرة. ولكني تذكرته هناك حين فهمت ميزة أن تزور بلداً ليس فيه فعلياً قطاعٌ سياحيّ خارجي، فتكون طوال وقتك بين إيرانيين، تفعل ما يفعلونه وترتاد أماكنهم (ولم أزر في حياتي بلداً كنت فيه غريباً، لا أعرف اللغة، وكان الناس فيه معي بهذا اللطف والكرم؛ وهذا في كلّ مكان، سواء في العاصمة أو في مدينة صغيرة مثل قاشان – وأنا لست ألطف إنسانٍ في العالم. لدرجة أنّه، أكثر من مرّة، كان سائق التاكسي يرفض أخذ الأجرة حين ينتبه أنّنا غرباء). خلال إقامتي في إيران، بالمناسبة، فإنّ الوحيد الذي «نصب» عليّ، بأي معنى وبأي قيمة، كان بائع العملات في المطار، أي الذي يعتاش على التعامل مع السيّاح والأجانب.
السياسة في الحقيقة
قد يكون من أسوأ أنماط الاختزال أن تنظر إلى السياسة الشعبية في إيران حصراً عبر الأيديولوجيا «الرسمية»: محافظون وإصلاحيون، متشددون وليبراليون، الخ. فهذا ليس سوى مستوىً واحد من طبقات السياسة المتعدّدة في البلد. سأشرح: نحن هنا، أوّلاً، لسنا في «دولة أمّة» بالمعنى الأوروبي الحديث. هذا كيان شبه-إمبراطوري لم يفكّكه التاريخ، متعدّد الإثنيات والقوميات واللغات، وبأقاليم لم تكن دوماً متّصلة أو تشكّل «سوقاً وطنيةً» موحّدة. انسوا كل الاختلافات الإثنية واللغوية، هل تعرفون - مثلاً - عن قوّة المناطقية في إيران؟ تبيّن لي، مثلاً، أنّ هناك «حرباً أهلية» حقيقية، غير معلنة، قائمةٌ بلا هوادة بين شيراز وأصفهان. انسوا التنافس بين دمشق وحلب، انسوا تعالي الموصل على من حولها، لن تصدّقوا مقدار الكراهية والحقد. حين يعرفون في شيراز أنّك ستذهب إلى أصفهان يجعلونك تشعر وكأنّك ذاهبٌ إلى إسرائيل: «لا تشترِ منهم شيئاً. سوف يبيعونك بأضعاف السّعر الحقيقي ويغشّون الزعفران بالعقدة الصفراء». «هل ترى هذه النباتات الملونة في الحقول هناك (يشير بيده من السيارة)، هذا هو الزعفران الذي سوف تشتريه في أصفهان!».
«إنهم شياطين. لو عرف صاحب المتجر أنّك صينيّ، ستجده فجأة يحدّثك بالمندارين بطلاقة ويتلو حكماً كونفوشيوسية، فقط لكي يبيعك. لقد رأيت ذلك بعينيّ». «هم يعيشون فقط من أجل العمل والمال. يجمعون ولا ينفقون. لا يعرفون معنى الحياة الجميلة الهادئة، هم ليسوا مثلنا في شيراز، نحن أبناء حافظ وسعدي». ولكن المسألة، للأمانة، هي أنّك حين تصل إلى أصفهان وتكتشف مساجدها وأوابدها المدهشة، ومساحاتها العامة، ومتاجرها وحرفييها، و«الجوّ الخاص» الذي تمتاز به المدينة، تفهم هنا لماذا هم مكروهون ومحسودون، ولماذا هم معتدّون بأنفسهم ومدينتهم، ولو أنّي مكانهم لكنت أسوأ منهم. جديرٌ بالذكر أنّ مسجد الشاه وغيره من علامات أصفهان الصفوية قد بنيت في وقتٍ مقاربٍ لقيام سنان بتصميم مساجده وعماراته، وكان هناك تنافسٌ واعٍ ومقصود بين الدولتين، ومع أسلوبين مختلفين في العمارة (الزخرفة الصفوية الكثيفة والفسيفساء التي تولد عالماً من الألوان والأشكال، مقابل العمارة السلجوقية الرشيقة و«الخفيفة»)؛ ولا يجب أن تنقضي حياتك قبل أن تزور الاثنين.
السبب على الأرجح أنّ إيران، تاريخياً، بلد واحاتٍ وبقعٍ مدينية معزولةٍ عن بعضها البعض، تفصل بينها مئات الكيلومترات من الصحاري والجبال. شرحت في مقالٍ سابق كيف أنّ كل مدينة إيرانية كبيرة كانت تشكّل، مع محيطها، «عالماً اقتصادياً» خاصّاً بها، له عملته الخاصة التي تستخدم محلياً. وستتطوّر هنا، بطبيعة الحال، ثقافة خاصة بكلٍّ من هذه المدن/الأقاليم وهوية محليّة عميقة وقويّة. ولكن بعيداً عن نوادر التعصّب الجهوري، تخيّل لو أردنا أن نستكشف ميادين الإثنيات، والطبقات، والدين والمذهب، الخ. على المستوى الفردي، لكلّ إنسانٍ في إيران قصّته الخاصّة: الكردي له قصته، وللعربي قصة مختلفة، والآذري، والبلوشي، الخ. كان السائق الأهوازي يشرح لي تاريخ قومه ومظلوميتهم، وكيف لم ينصفهم العرب والفرس معاً. هو أصلاً من عبادان ولكنه هاجر إلى طهران منذ عقود ويعمل فيها سائق تاكسي، ويشتكي من أنّ أولاده الذين ولدوا في العاصمة لم يتعلّموا العربيّة و«أصبحوا فرساً» في اللغة والطباع. استمعت إليه ثم «استدرجته» بسؤال: «ألا يكون من الأفضل، إذاً، لو استقليتم وأصبح النفط لكم وحدكم؟». هنا لمعت عيناه، ثمّ وضع فكّه على المقود مستغرقاً في الحلم: «الله! نصبح مثل الكويت! تخيّل». بعدها بدقيقتين كان يشتكي لي من أن الفارسي لا يثق به (لا أدري لماذا). هذا عدا عن الكمّ الهائل من نظريات المؤامرة التي تفسّر «من يحكم البلد حقّاً» خلف الكواليس (نظرية «المؤامرة العربيّة»، مثلاً، وهي غير نظرية «المؤامرة التركية»).
كيف تحكم بلداً بهذا الاتساع والتنوّع وتحافظ على السّلم الاجتماعي فيه؟ هذا ليس بلداً، قلت لصديقي الطهراني بعد أسابيع في إيران، هذه... فلنسمّها «حديقة ورود» (شرح لي صديقي أن التشبيه الأصلي الذي اخترته قد يُفهم خطأ). وكل «فصيلة» لها ظروفها وقصتها. في إيران، مثلاً، ليس في وسعك أن «تستسهل» وتسير على درب صدّام، أو تتخلص ببساطة من الفئة الإشكالية لأنّك، إن ابتدأت على هذا الطريق، فلن يتبقّى أحد. النتيجة الوحيدة التي وصلت إليها هي عن وجود «نظرية حكمٍ» ما، فلسفة سياسية أكثر تعقيداً ممّا يبدو في الظاهر، وأنت لن تجدها في الكتب الغربية عن إيران، بل عليك أن تذهب إليها وتتكلم معهم وتستمع؛ وهنا فعلياً السؤال المثير. قد أفعل ذلك تحديداً، لم لا؟ أقضي أشهراً أو سنةً في إيران وأتعلّم بعض الفارسية، وهي أيضاً موقعٌ مثيرٌ لكي تراقب منه - هذه الأيام - المنطقة والعالم.
خاتمة: أسئلة المستقبل
«حسنٌ»، أخبرت صديقي الأكاديمي في نهاية الزيارة، «أفهم وجود دعامتين كبيرتين على الأقلّ للحكم في البلد». من ناحية، لديك طبقات شعبية كبيرة تستفيد بشكلٍ جوهري من السياسات الاجتماعية والخدمات وأنظمة الدعم والتوزيع. هؤلاء وإن انتقدوا الدولة، فهم لا يريدون لهذا النظام أن يزول، بل يطلبون المزيد من الخدمات والتنمية. من جهةٍ أخرى، فإن أكثر البرجوازية العليا أيضاً - تلك التي تقطن شمال طهران - تعتمد بشكلٍ أساسي على الدولة في وجودها وازدهارها. حتى لو كان أفراد هذه الطبقة - على المستوى الشخصي - إصلاحيين أو ليبراليين فهم يفهمون جيداً أن صناعاتهم تقوم على عددٍ كبير من أشكال الدعم المضمر (implicit subsidies) الذي تؤمّنه الدولة لهم: غاز رخيص، طاقة رخيصة، يد عاملة رخيصة... هذا إضافة إلى السوق الداخلي الكبير الذي تسوّره الدولة لصالحك، ولولاه لما كنت. ومن الصعب أن يسقط نظامٌ طالما أن هاتين الفئتين لهما مصلحة جوهريّة في استمراره. ولكن، من جهةٍ أخرى، تظلّ لديك الطبقات الوسطى، وهي - لأسباب مادية وموضوعية يطول شرحها - من الصعب أن تجذبها شعارات من نمط «الجمهورية الإسلامية» و«اقتصاد المقاومة»، فماذا تفعل؟
لدى صديقي الطهراني رأيٌ مختلف. هو كتب منذ أشهر قليلة أن هناك انطباعاً سائداً في الخارج وسرديّة منتشرة عن شعبٍ إيرانيّ تقدّمي وليبرالي إجمالاً، تحكمه قيادة ثيوقراطية ورجعية. بينما هو يعتبر أن المعادلة معكوسةٌ تقريباً، بمعنى أن السياسات الاجتماعية والتضامن مع قضايا الجنوب والتنمية الذاتية وباقي السياسات «التقدمية» هي أساساً من فعل نخبةٍ ثورية صغيرة، ملتزمة أيديولوجياً بمبادىء الثورة. فيما أكثر البرجوازية في المجتمع التي تعتبر نفسها «أخلاقية» و«عميقة»، يضيف الصديق، هي في الحقيقة «فردانية أنانية قصيرة النظر، تخلط بين الانبهار بالغرب وبين الثقافة، ليبراليتها سطحية بنت القرن التاسع عشر، وأغلب آرائها السياسية عبارة عن نظريات مؤامرة». ثمّ يضيف أن هؤلاء الناس، بطبيعة الحال، سيصلون إلى مناصب في المؤسسة، وسيمسكون بمواقع قيادية. قد تحدّ عوامل كثيرة من تأثيرهم غير أن الحال سيبقى كما هو: نخبة ثورية تواجه ثقافة عامّة من الأنانيّة وانعدام الثقة بالنفس، سواء بين صفوفها أو في خارجها، والنتيجة - يختم الأكاديمي الإيراني - «هي المشاكل التي تواجهها إيران اليوم».
* كاتب من أسرة «الأخبار»