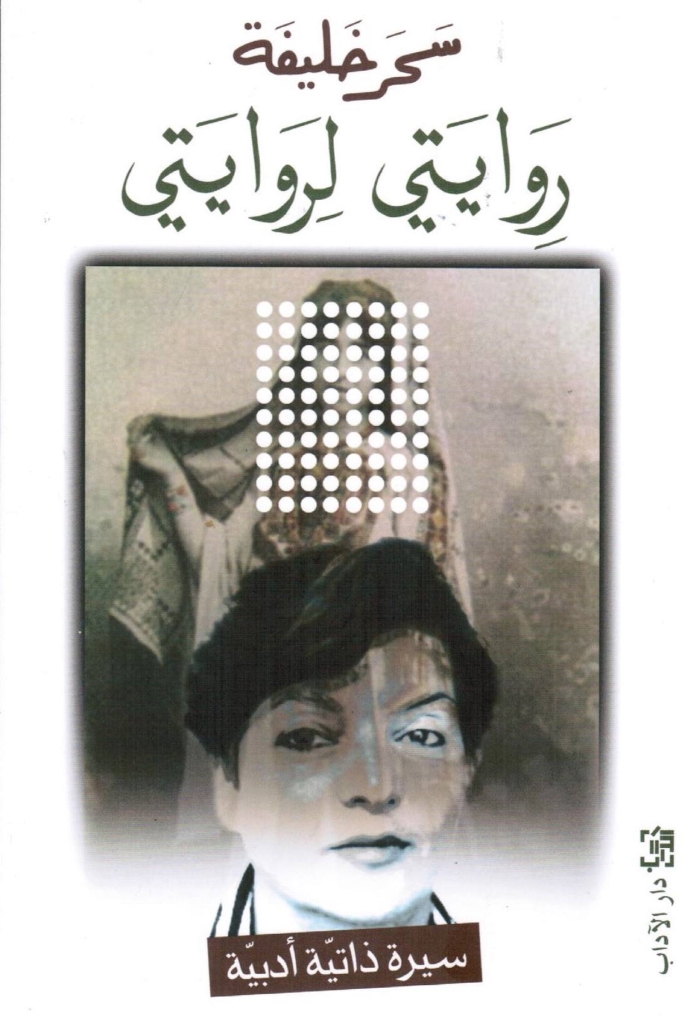
تستهلُّ خليفة سيرتها الأدبيَّة من حادثة طلاقها، التي كتبت لها عمراً جديداً. فقد عانت الروائية الأمرَّين من زوج مقامر لم يتوان عن تعنيفها، وخرجت من سنوات الزواج الثلاث عشرة، وفي عمر الثلاثين، بابنتين ومستقبل مبهم. زواج مدبَّر عرفت خلاله معنى قهر الرجل، ووصلت إلى خلاصات غير ممنهجة عن التربية البطريركيَّة، حيث العائلات «تتعطر ببول الذكر»، وتوليه الأهميَّة القصوى، وتُدلِّله وتقنعه أنَّه الأرفع شأناً، وتقوم بكلِّ الأعمال بدلاً منه، وتوليه صغيراً حكم أخوته البنات.
خليفة سليلة أب وجيه وثري من نابلس كدَّ في عمل الميكانيكا، وتزوَّج امرأة ثانية في عمر بناته، وأم «مقموعة» لأن بطنها لم تنتج سوى البنات (ثماني بنات عاشت من بينهن ستّ). وحين جاءها الذكر، ومن فرط التدليل، أُصيب في نخاعه الشوكي نتيجة حادث سيَّارة فشلَّ، وأمسى قعيد كرسي مدولب.
تكنُّ الروائية الامتنان لرجلين أثَّرا في مسيرتها الأدبيَّة: التشكيلي الفلسطيني الراحل اسماعيل شموط، الذي أُعجب برسومها (كانت تمتهن الرسم الحر خلال مراهقتها، ثمَّ تخلت عن الأمر بعدما حطَّم زوجها الكانفاس مراراً أثناء مشاجراتهما، فلجأت إلى كتابة الشعر فالرواية، حيث أن إخفاء نتاجها الأدبي أسهل وأوفر ماديّاً). وبعدما استمزجت رأيه في كتاباتها، نصحها شموط بالبحث عن «ظرف خاص يساعدها في الإنتاج والإبداع وتكوين بوصلة توجهها، حتَّى لا تقع في المحظور وتكرِّر عادات الجو العام وممارساته». والثاني هو حلمي مراد «مكتشفها» وناشر روايتها الأولى «لم نعد جواري لكم» (1974). وقتها، أرسلت المخطوطة له، حين كانت لا تزال متزوجة، تسكن في ليبيا مع زوجها، فتنبأ لها بأنَّها ستمسي «فرخة بكشك»، أي روائية نجمة. علماً أن للروائية عملاً كتبته أثناء سجنها الزوجي في ليبيا وسمَّته «بعد الهزيمة» لم يبصر النور، إذ صادره الحاجز الإسرائيلي أثناء محاولتها نشره في عكا.
بعد الرواية الأولى (والطلاق)، تسجَّلت في جامعة بيرزيت التي كانت تشهد غلياناً طلابيّاً. هناك كتبت «الصبَّار» (1976) التي تناولت فيها مسألة العاملين الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية، بعدما استصدرت تصريح عمل إسرائيلياً، وتخفَّت في ملابس عاملة لتعاين الواقع عن كثب. ثمَّ كرَّت سبحة الروايات، من «مذكرات امرأة غير واقعية» و«عباد الشمس» وتوظَّفت في جامعة بيرزيت، قبل أن تسافر إلى أميركا وتنال الدكتوراه، وتتعرَّف إلى حياة الأميركيين العرب، ممَّا ألهمها روايتها «الميراث».
تُشرِّح روايات خليفة العلاقات بمشرح سوسيولوجي: علاقة المرأة بالرجل، والمرأة بالمرأة، والفلسطينيين بالاحتلال، مع خلاصات لا تتبنَّى أي وصفة جاهزة، ولا تتوانى حتَّى عن تفصيص أفكار اليسار التقدُّمية، التي كانت وفي سبيل ترتيب أولويات النضال، تضع حقوق المرأة في مرتبة أدنى من التحرير من الاحتلال الإسرائيلي. تفيد بطلات روايات خليفة بأنَّ قلَّة من النساء مستعدَّة أن تعرف شظف العيش في سبيل التحرُّر من علاقاتها الزوجيَّة الفاشلة. وفي الروايات أيضاً، هناك نقل لـ«استخفاف» المرأة البروليتارية (سعدية في «عباد الشمس») بالمناضلة النسوية المنتمية إلى البورجوازية الصغيرة أو المتوسطة (رفيف). فالأولى قد تصل إلى الهزء بالثانية، وتصوير لزيف المثقفين الذين لا يعرفون من تحرير المرأة سوى الحرية الجنسية (عادل الكرمي في «عباد الشمس»). وفي الرواية المذكورة التي عرفت نجاحاً، إضاءة على «الشرف» الأنثوي الذي يتحكم بمجتمعاتنا، وكيف أن الغالبية ما زالت تضحي بالشرف الوطني في سبيل الحفاظ على الشرف الأنثوي.
دقَّ قلب الروائية للحب ثانيةً، بعد الطلاق، ممَّا ألهمها «مذكرات امرأة غير واقعية» التي أبصرت النور في 1986، بعدما كتبتها سنة 1980، وقد تأخر صدورها جراء صعود نجم الإسلاميين في جامعة بيرزيت، فكان الواقع غير متاح لطروحاتها التي تتحدى المجتمع. إذ أثارت حكاية امرأة من الطبقة المتوسطة، ذات تعليم متوسط، تعاني انفصاماً بين ما يقال وما يفعل، وبين ما ترجوه من حرية اختيار الزوج في الوقت المناسب والحياة التي يطلبها المجتمع منها.
تُشرِّح رواياتها العلاقات بمشرح سوسيولوجي
في الفصل الأخير من «روايتي لروايتي»، تجربة خليفة في الجنوب الأميركي، حيث لبَّت دعوة برنامج الكتاب العالمي المنبثق عن «جامعة أيوا» قبل أن تتابع دراساتها العليا في «جامعة شابل هيل» الأميركية، وتتعرَّف إلى الحلم الأميركي ببريقه وزيفه، وتترك طوعاً هذه البلاد التي ألهمتها «الميراث» عن الرجل العربي الذي يعرف الترقي الاجتماعي والعلمي والانخراط في المجتمع الأميركي، من دون أن يتخلَّى عن التربية الأولى، فالعودة إلى شرنقتها فلسطين مع الانتفاضة الأولى (1987).
جريئة خليفة في الحديث عن تجربتها الزوجية الفاشلة، ووقوعها في الحبِّ ثانية، وتشكيكها الدائم في نفسها كروائية. هي تضرب على أوتار حسَّاسة حين تقول إنَّ المرأة ــ وحتَّى يحسب لها الحساب ـــ عليها أن تهمل مظهرها، وأن تتخلى عن الكثير. هي واضحة في تعويلها على البورجوازية (ثبت أنَّ المرأة من أصول بورجوازية صغيرة أو متوسطة، وبسبب حصولها على مستوى تعليمي معقول، هي السباقة إلى الوعي بدونيَّة وضعها، والتمييز ضدَّها بسبب أنوثتها)، وداحضة بالبراهين كل الاتهامات لها بتبنّي الأفكار الليبرالية الغربية الخاصة بتحرير المرأة. صدمة هزيمة 1967 شكَّلت وعيها، حين احتكَّت بعشرات الألوف من المهجرين الفلسطينيين، وعاينت عن كثب وضع المرأة ومهانتها وكسلها وسوء تقديرها وتبلدها الناتج من ظروفها، التي تعتقد (أي المرأة) أنَّها غير قابلة للتحسُّن، كما وضع الرجل المثقف الذي يكتفي بالتنظير، من دون أي تصرُّف مادي يُعوَّل عليه أثناء المحن. وكلمة حق في الزعيم جمال عبد الناصر الذي «كان الأنبل والأخلص، على الرغم من خطئه المغفور لأنه اجتهد ولم يفلح».. في انتظار صدور الجزء الثاني من «روايتي لروايتي»، هذه سيرة أدبية جديرة بالاحتفاظ بها في المكتبة.


