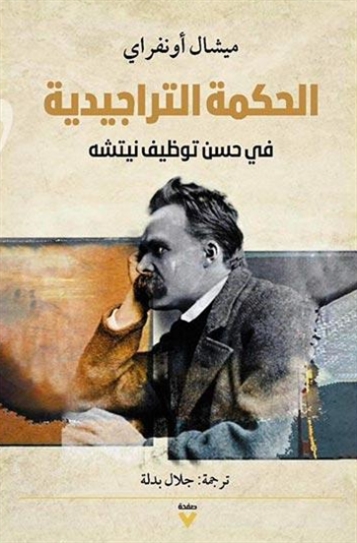
يقدّم أونفراي في كتاب «الحكمة التراجيدية في حسن توظيف نيتشه» الذي صدر أخيراً بترجمة بديعة لجلال بدلة (دار صفحة 7) قراءةً مخلصةً للفيلسوف الألماني، حيث فهم الفلسفة المدروسة لا يتمّ، بالنسبة إليه، إلا بالنظر إلى الفيلسوف وسياقه، معاكساً بذلك المناهج الأخرى التي تفصل بين العمل ومؤلّفه كالبنيويين. بالنسبة إلى أونفراي، فإنّ نيتشه «هشّ، يحب النساء لكن لا يعلم كيف يعبّر لهن عن ذلك... هو على الورق يطلق العنان لأحصنته، ويسمع دوي مدافعه، وأزيز رصاصه، ولأنّه مفكر كبير كشاعر كبير، فهذه الميزة المزدوجة تتسبب في ضلال كلّ من يفتقر إلى واحدة من هاتين المهارتين».
وقع نيتشه ضحيةَ هذا الفهم المضلّل، وأسهمت في هذه الخطيئة شقيقته، وحربان عالميتان، وتحريفات إيديولوجية، ومواعظ أخلاقية جعلت منه ومن إنسانه الأعلى رمزاً للإرهاب. يأخذ ميشال أونفراي على عاتقه مهمة إنقاذ نيتشه والنيتشوية من سيطرة الأعداء. وهو لم يخفِ منذ الصفحات الأولى أنّ كتابه «فنّ من فنون الحرب، هذا الكتاب محصّلة معركة». سيتفرّغ في هذه المعركة لقراءة تأويلية حصيفة لنيتشه، منقذاً إياه من براثن المحرّفين الذين استفردوا به طويلاً، لكن قبل ذلك سينقضّ على معاصريه. على هذا النحو، متمرّساً بعتاد نيتشويّ، يهاجم أونفراي فلاسفة زمن «الإلحاد الهادئ»، هؤلاء الذين ينتهجون الإنسانوية في حين أنهم «المؤمنون الجدد»، أمثال أندري كونت سبونتفيل وميشال سيريس، وأولئك الحداثيين أيضاً، أمثال جاك دريدا وجان لوك نانسي، حيث فلسفة التيارين ـــ كما يرى أونفراي ـــ متواطئة مع الفضاء الديني والإلهي، إذ إنّها تتحرّك تحته ومنسجمة مع وجوده، لا تستفزّ ولا تهدّد حضورَ هذا الفضاء ولا جوهره. على أنّ هذا الفضاء بالتنويعات الفكرية التي تنضوي تحته كافة، يزعم أنّه من ترسّبات الحداثة، فالإنسانويون والتفكيكيون وغيرهم هم أحفاد الأنوار، بيد أنّهم ضد الأنوار الجديدة، فالتاريخ القديم ما زال راهناً، وهذا يعني أنّ الحداثة، كما يرى أونفراي، لم تتأسّس بعد، فالأنوار الحقيقية لا تضيء من دون نيتشه.
لا تاريخ بل صيرورة دائمة لا غاية لها سوى ذاتها، لا تعرف الإرهاق وتُعيد وتتكرّر. إنّها العود الأبدي حيث «الماضي والحاضر شيء واحد». صيرورة تتكرّر بلا نهاية لماهيتها: إرادة القوة تلك التي تُنتج الواقعي. لذلك، فقد شهد العالم تحوّلات عدّة اقتصرت على الشكل، في حين أنّ الإيمان وجوهر الإلهي استقرّا. يرصد أونفراي تلك المحطات ويتوقف عند التحوّلات الطارئة. يقتبس من نيتشه ويطالع بدايات التحوّل ولحظة استقراره: بدأ حين تبنّى العقل فكرةَ المثال الأعلى والعدول عن الحياة من الأفلاطونية، التي تحوّلت بعد ذلك إلى دين، فأخذت شكل المسيحية، لتنتهي مع الاشتراكية آخذةً من السياسة شكلها.
ثمة لحظة فاصلة قد تبدو أشبه بأبوكاليبس: الفلسفة قبل نيتشه ليست كما بعده. الانعطافة تبدأ معه، ولو أن الطريق الجديد لم يرَ النور بعد. يجنح أونفراي أسلوبياً ويكتب «إن نيتشه يبطل رمزانية النور أو الأنوار، لتشرع معه ألفية من الأنوار الجديدة: إشعاعات باردة ومطهّرة تتساقط من الشواش البدئي، وتغمر بصقيعها التبلورات المؤقتة». العالم كان زاخراً بتفسيراتٍ مقدّسة ومكسوّاً بالأساطير، إلى أن جاء الفيلسوف الألماني وهدّم بمطرقته الطبقات الزائفة التي حوّلت العالم إلى رقعةٍ واهية شوّهت الوجود وكبحت طاقاته. يشير أونفراي إلى الأثر المزلزل الذي أحدثه نيتشه على صعيد النظام والانسجام الذي ساد لقرونٍ عدّة وقضى على حقيقة أبدية حركة العالم. مع نيتشه، هناك تقويض للثنائيات، على رأسها تلك التي تعترف بفصل الروح عن الجسد واحتقار الثاني بذريعة الأخلاق والمثل العليا. وهناك تجريد للمقدّس الذي حكم طويلاً وأوهم الإنسان بأنّه حرٌّ وأنّه بذاته مركز الكون. يسلّط أونفراي الضوء على نيتشه الناقد، ويشدّ على هذا الجانب كمن يكزّ على أسنانه. ثمّة عدمية لا مفرّ من تقبُّل وجودها، لأنّه وجب إعدام مرحلة كانت باذخة في الأساطير، وقد جعلت المرءَ زائغاً أو كالجمل الذي أنهكته الحمولة الزائدة، إزاء خديعة الضمير وحيل الأخلاق. غير أنّ تلك العدمية ليست غايةً بحد ذاتها، كما أنّها ليست على الإطلاق مشروع الفيلسوف، لكنّ مهمة بناء عالمٍ جديد تشترط تدنيس القائم وتهشيمه. يشدّد أونفراي على مستوى الهدم؛ يرسم بأسلوب أدبي بليغ جوّاً قاتماً، هو شكل الدمار الذي لحق بعمارة العالم بعد ضربات كالها بمطرقته. والإنسان ليس بعيداً عن هذه الصدمات، وسيلتحق بدوره بهذا الحطام. يعيد أونفراي التذكير بنظرة نيتشه إلى الإنسان، تلك النظرة المتأثرة بشوبنهاور، حيث الإنسان ليس حراً بل مجرّد كسرة، محكوم بالقوى وتدفّقات القوى وإرادة القوى، غير أنّه في الآن عينه احتمالٌ لزرادشت مرجوّ، أي للإنسان الأعلى، في حال فهم وجوده وتقبّل العالم الذي يعيش فيه وسعى إلى تجاوزه. يبقى أنّ كل ذلك منوط بتلك الإرادة التي تقبل إرادة القوة. الولادة الجديدة تشترط موتاً، بل عملية اغتيال.
المطرقة إذاً هي الوسيط الذي من دونه لا يمكن التحرّر من وجودٍ مثقل بالأوهام. المطرقة بالتالي، تفتح قبر العالم القديم، وتؤدّي وظيفة المحراث الذي يفتح طريق العبور نحو جغرافيا جديدة. ذلك أنّ الطريق إلى الحداثة كما رسمه نيتشه طوبوغرافياً تنطلق من الإلحاد وفقاً لما يؤكده أونفراي: التخلّص من الإله وسطوته، ومعرفة أن العالم مقاد من إرادة القوة. كان العالم حلماً ثم موضوع وصف، اختلف الأمر مع نيتشه وصار العالم عارياً؛ قد يبدو أنّه قارة جليدية يغمرها الصقيع بسبب انتزاع الطابع المقدّس عنه، لكن العالم مليء بالتدفّقات والحركة، ولنفهمه ونعيش به علينا النظر في البداهة؛ أي في الواقعي بوصفه حقيقياً، وعلى المرء الإمساك بالشدّة الصارمة للإرادة. إنّها الحكمة التراجيدية التي تنصّ على القطيعة التامّة مع ميتافيزيقيا أرست نفسها لقرون، جعلت الإنسان صاغراً ومخدّراً بالأوهام، وبالتحلّي بهذه الحكمة التراجيدية كما يؤكد أونفراي. ينطفئ الضوء عن الأنوار الخادعة التي تشبه ظلال كهف أفلاطون. لكنّ هذه النظرةَ المرعبة والسوداء (انهار العالم القديم كما انهار معه وصفه البشري الشكل المرافق له - الواقعية القديمة البائدة - لمصلحة تجريد جديد غنائي) ليس فيها من اليأس شيء، فهذه التراجيديا ليست مأساةً، إنما هي اختبار للإنسان بأن يتفوّق على نفسه، ويعدو نحو الإنسان الأعلى أولاً، ثم إنها تمهيدٌ لفجر جديد، هو في رأي أونفراي الحداثة نفسها.
يعيد التذكير بنظرة نيتشه إلى الإنسان المتأثرة بشوبنهاور
غير أنّ الإنسان الأعلى هنا ليس جندياً منتسباً إلى الحزب النازيّ، مثلما أنّ استعانة نيتشه بالحرب لم تكن سوى استعارة، ولغة نيتشه حادّة كالنصل، بل الإنسان الأعلى هو البعيد عن الانفعالات، وعن ردود الفعل الارتكاسية، وهذا إذا دلّ على شيء، فهو على احتقار السياسة والابتعاد عن مشاغلها. فالإنسان الأعلى هو ذاك الذي يتميّز بالكبرياء، يعلم كيفية ضبط النفس، لا يسود الآخرين بل يسود نفسه، وهو صار على هذا المستوى ليس لأنّه جرماني من عرق آريّ بل عن استحقاق؛ فقد أصغى إلى نداء الإرادة بداخله وأطلق العنان لها، متوغّلاً في مسار قدره. يعيد أونفراي التعريف بأخلاق الإنسان الأعلى كما حددها نيتشه، لكنها أخلاق لا تعرف قيَم التزهّد والضغينة التي تستّرت وراءها أنساقٌ ميتافيزيقية وإيديولوجية صوّرت الأرض مكاناً موبوءاً، والجسد آفة والحياة بؤرة ملوثة. إنّ همَّ الإنسان الأعلى أن نكون شعراء حياتنا، أن نمارس الضحك، والرقص، والتحلّي بالنسيان وحبّ القدر. يبدع ميشال أونفراي في قراءة الفيلسوف الألماني الذي رافقه منذ أن كان مراهقاً. يبرع في رسم ملامحه من دون إجراء عمليات تجميل من شأنها أن تجمّل أو تشوّه وجه نيتشه. يُظهره كما هو «رمز للتجوال الأبدي، ومفكر المنازل المتبدلة، والطواف غير التائب»، في كتابة متدفّقة، متفجّرة كالديناميت، تتخطّى نفسها، كأنها تمرين على الإجابة: كيف يكون المرء نيتشوياً؟






