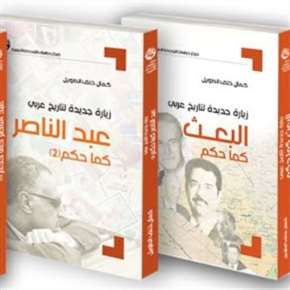لماذا تدخّل حزب الله لمساندة المقاومة في فلسطين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ فما هي التهديدات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة بعد «طوفان الأقصى»؟ وكيف يمكن لتدخل حزب الله بهذا الشكل أن يعزّز موقف المقاومة في غزة ولبنان؟ هي أسئلة يتم طرحها إما كجزء طبيعي من نقاش مرتبط بحرب مصيرية ستساهم في رسم توازنات المنطقة لسنوات طويلة، وإما كجزء من حملة معلومات معادية لزرع الشك والتوهين بجدوى عمليات حزب الله العسكرية ولنزع المشروعية عنها. تناقش هذه المقالة كيفية تصوّر حزب الله للتهديد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وأهداف فتحه لجبهة المساندة، وتستبق ذلك بمقدّمات ضرورية مستخلصة من دراسات الحرب حول المواجهة بين جيوش نظامية وقوى مقاومة وتحرر وطني وهي تنطبق على جبهتَي غزة وجنوب لبنان.
أولاً: معضلات جيش العدو في مواجهة المقاومة
1. غالباً ما يحقق الجيش النظامي إنجازات تكتيكية في وجه حركة المقاومة، لكن نادراً ما تمكّن من تحويلها إلى انتصار استراتيجي. السبب الرئيسي في ذلك أن مثل هذا صراع يكون مرتبطاً بالمشروعية بين جيش نظامي يظهر كقوة احتلال وقوة غير نظامية تظهر على أنها حركة تحرر وطني. فالمهم هنا ليس ميزان القوى فقط بل ميزان المصالح وطبيعة الوضع القائم، فما دام الوضع القائم لا يعكس المصالح التي تمثّلها حركة التحرر فستكون قادرة على مواصلة القتال دون أن يسحقها الجيش النظامي ولا أن يكسر إرادتها القتالية. هذه المعضلة يقر بها الصهاينة في غزة خلال الأسابيع الأخيرة وتتمثّل في تحقيق الجيش لمنجزات عملانية مهمة لكن دون تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة ودون القدرة على ربطها بسياق سياسي نتيجة إحجام حكومة العدو عن تقديم رؤية سياسية للحرب.
2. للعنف ذروة، حينما يتجاوزها يبدأ بتوليد آثار عكسية، فكل عنف إضافي لا يعني إنجازات إضافية بل عند مستوى محدد ينقلب إلى عبء على الجيش النظامي. بعد الذروة تكون حركة التحرر قد دفعت الثمن الأقصى ولن يزيد العنف الإضافي من العبء الذي ترتّب سلفاً وهكذا تصبح أكثر قدرة على احتمال المخاطرة، كما أن العنف العشوائي المفرط يزيد من التعبئة الشعبية لصالحها. في المقابل، يضع العنف الإضافي الجيش النظامي أمام معضلة الوضع الإنساني وصورة الإخفاق في تحقيق الأهداف السياسية. فبعد الذروة يتحوّل العنف إلى مجرد قوة عارية تقتل وتدمّر لمجرد القتل والتدمير. وغالباً ما يقع الجيش النظامي في هذا المأزق إما نتيجة العجز عن تحقيق الأهداف العسكرية وإما لعجز المستوى السياسي عن صياغة أهداف سياسية واضحة للحرب. وهذا ما تحقّق في غزة منذ نهاية معركة شمال القطاع تقريباً، وهو ما أتاح لحركة «حماس» تغيير نمطها القتالي من ناحية والتشدد في الموقف التفاوضي من ناحية ثانية.
3. من غير الممكن تحقيق حسم عسكري ضد قوى التحرر وذلك نظراً إلى طبيعتها غير النظامية والجوهر السياسي للحرب. ولذا تركّز الجيوش على تحقيق الردع التراكمي، وهو ردع بحاجة إلى شحن متواصل ما دامت حركة المقاومة لا تجد الوضع القائم مقبولاً بدرجة كافية. تراهن الجيوش النظامية على إطالة أمد الهدوء عبر الردع لتوظّف خلال ذلك أدوات عسكرية دون الحرب وإجراءات متنوعة سياسية ومعلوماتية واقتصادية حتى تفقد قوى التحرر إرادة القتال وتخضع لمساومة انهزامية. لكنّ التجارب أثبتت أن الردع لعبة غير موثوقة لأن قوى التحرر المشحونة إيديولوجياً وشعبياً ستجد دائماً طرقاً للتعلم والمناورة على نقاط قوة العدو ومباغتته والإضرار بإرادة القتال لديه. مما يدل على هذا الاستعصاء ربطُ الصهاينة هدف النصر الحاسم في حربهم الحالية على غزة بانتصار الحلفاء على ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وهي مقارنة باطلة تماماً.
4. في مقابل اللاتماثل في القوة المادية لصالح الجيش النظامي بوجه قوة التحرر الوطني، هناك أفضلية للطرف الثاني في ما يمكن تسميته اللاتماثل في الثمن، أي إن قوى التحرر لديها قدرة أعلى بكثير على احتمال أثمان الحرب، سواء لناحية الخسائر البشرية والمادية أو طول أمد الحرب. ولذلك يشير سجلّ الحروب إلى أن الجيوش النظامية عادة ما تفتتح حروبها ضد قوى غير نظامية بإنجازات لكنها تبدأ بالتلاشي بمرور الوقت. فقوة التحرر الوطني المحتضنة شعبياً والمشحونة إيديولوجياً مضطرة وقادرة على احتمال خسائر مادية عالية نظراً إلى قدرتها على تجديد قواتها وتأكيد صوابية موقفها وجدواه. في حين أن الجيوش النظامية، ولا سيما في أنظمة ليبرالية، حساسة جداً لخسارة جنودها لما تثيره من خلافات سياسية في مجال عام مفتوح وتنافسي. وهذا ما يترك تأثيره على تحمّل مدة الحرب، فكلما طالت الحرب زادت الأعباء البشرية والاقتصادية على الجيش النظامي وعلى صورة ومكانة الدولة التي ينتمي إليها ولا سيما إن كان واقعاً في حالة مراوحة واستنزاف.
ثانياً: تصوّرات التهديد بعد 7 أكتوبر
أفرزت عملية «طوفان الأقصى» فرصاً استراتيجية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية (مع كل ما يحتمله من أثمان) ولكل قوى التحرر والاستقلال في المنطقة، وهي ستظهر تباعاً لسنوات مقبلة. وفي الموازاة، أنتج القرار الإسرائيلي بالتعامل مع العملية، وفق مقولة «النصر الساحق» ضد المقاومة في غزة وإعادة تشكيل البيئة الإقليمية، جملة من التهديدات بوجه لبنان ومقاومته. هذه التهديدات مستقلة تماماً عن خيار حزب الله بفتح جبهة جنوب لبنان، وذلك بفعل الوقائع القاسية لهذا الصراع وحقائق الجغرافيا السياسية وتداعيات 7 أكتوبر لناحية الانفلات القياسي لعدوانية الكيان واضطراب تصوراته الأمنية. وعليه، هناك مصدران أساسيان للتهديدات التي استجدت:
أولاً، تهديد تغيير ميزان القوى في الصراع داخل فلسطين وتالياً انعكاس ذلك على مصير القضية الفلسطينية وعلى ميزان القوى الأعلى بين محور المقاومة وكيان العدو. هذا التغيير، إن حصل، يتيح لتل أبيب أن تصبح أكثر عدائية وهجوماً تجاه الجبهة النشطة الأخيرة في دول الطوق، أي لبنان، حيث التهديد الاستراتيجي الثاني المندمج في التهديد الأول، أي إيران، وكذلك أقدر على تصفية القضية الفلسطينية بوزنها القيمي عربياً وإسلامياً ولها أيضاً مخاطر استراتيجية على الأمن الوطني لكل دول المشرق العربي ولا سيما لبنان.
ثانياً، تهديد التغيّر في «عدسة الأمن والدفاع»، بحسب التعبيرات الإسرائيلية، أي إن الكيان قرّر إعادة النظر في مفاهيمه الأمنية والاستراتيجية لإدارة الصراع مع قوى المقاومة كنتيجة تلقائية لـ«طوفان الأقصى». فقد تأكّد للصهاينة بعد 7 أكتوبر أنه يمكن لقوى المقاومة أن تمثّل تهديداً وجودياً – وهو أمر كان خاصاً فقط بالجيوش النظامية العربية الكبيرة ولا سيما قبل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية - بسبب قربها الجغرافي من حدود الكيان الذي لا يمتلك عمقاً استراتيجياً، وامتلاكها قدرات استراتيجية من صواريخ دقيقة ومُسيّرات وتميزها بحالة تعبئة دائمة وحافزية عالية ومرونة عملانية. وفي العقيدة الأمنية الإسرائيلية يمكن لهزيمة عملانية كبيرة أن تؤدي إلى إزالة الكيان. هذا التهديد أدى إلى مراجعة إسرائيلية في مسألتين خطيرتين على لبنان ومقاومته:
1. على مستوى الأمن الحدودي، حيث بدأت قيادات العدو وخبراؤه بالحديث عن ضرورة تغيير الوضع القائم على الحدود مع لبنان حتى لا يتكرر ما جرى في قطاع غزة. منطلق ذلك أن الافتراض بكون حزب الله مردوعاً، وهو لديه قدرات أعلى بكثير من «حماس»، لمّا يعد كافياً لضمان أمن المستوطنات وللتأكد من أنه لن يكون هناك 7 أكتوبر لبناني لاحقاً. ولذا بدأت تظهر مقولات أنه بعد الانتهاء من غزة يأتي دور لبنان لدفع حزب الله بعيداً عن الحدود (مع تباين في تعريف ذلك خوفاً من الالتزام بمعايير يصعب تحقيقها لاحقاً)، مع التستر بمقولة تطبيق القرار الدولي 1701. تباينت المقولات من المطالبة بابتعاد قوات «الرضوان» عدة كيلومترات عن الحدود إلى المطالبة بإخراج كل مقاتلي الحزب وقدراته العسكرية من منطقة جنوب الليطاني. وقد صدرت آراء دعت إلى احتلال كامل منطقة جنوب الليطاني لتكون على شاكلة حزام أمني شبيه لذلك الذي تجري إقامته في غزة، كما نادت بعض الأصوات بتهجير القرى الجنوبية الحدودية. إنّ ميزان القوى هو ما سيحدّد سقف المطالب الإسرائيلية الحدودية، فكلما بدا موقف لبنان ومقاومته ضعيفاً ستكون المطالب الإسرائيلية أكثر انتهاكاً للسيادة اللبنانية ومصالح لبنان الأمنية.
2. على مستوى الأمن الاستراتيجي، حيث انطلقت مُحاجَّات إسرائيلية أنه يجب القضاء على تهديد حزب الله في لبنان ولا سيما قدراته الاستراتيجية من صواريخ ومُسيّرات والتي هي أخطر من قوة «الرضوان» عند الحدود. ولذلك، لا بد من تغيير كامل الوضع في لبنان من خلال حرب شاملة بالاستفادة مما حصل في 7 أكتوبر.
ثالثاً: غايات تفعيل الجبهة الجنوبية
بناءً على ما تقدّم، كان قرار حزب الله في تفعيل جبهة المساندة في جنوب لبنان بهدف احتواء هذه التهديدات ليبقى ميزان الفرص راجحاً، فلسطينياً ولبنانياً. لذا كان لا بد من تفعيل الجبهة الجنوبية لتحقيق الآتي:
1. تعقيد الحرب الإسرائيلية في غزة من خلال تشتيت قوة الجيش الإسرائيلي البرية بما يعرقل قيام العدو باجتياح بري متزامن لكامل لقطاع، ووضع قيادة العدو تحت ضغط مستوطني الشمال الفارين (وفرار المستوطنين مسألة شديدة الحساسية في العقل الصهيوني)، ورفع مستوى المخاطر الإقليمية للحرب في غزة بما يرفع الضغوط على الإدارة الأميركية. وهكذا طال أمد المعركة في غزة بدون حسم كافٍ، فيما كان الوقت يصبح ضاغطاً على إدارة بايدن، وهو ما جرى التعبير عنه إسرائيلياً بمقولة «فارق الساعات الرملية الأميركية والإسرائيلية»، وهكذا يصبح للوقت ثمنٌ ثقيل على العدو.
2. حماية مفهوم المحور/وحدة الساحات. كان من شأن عدم مساندة محور المقاومة لغزة أن يزرع الشك في أصل المفهوم ويضعف جدوى الانتساب إلى المحور ويقوّض مشروعيته. إنّ مساندة المحور للمقاومة في غزة قدّمت نموذجاً ملهماً لانسجام المصالح ووحدة المصير لشعوب المنطقة وأثبتت المفاعيل الاستراتيجية لوجود المحور وقدرته على المبادرة حتى في ظل أعلى مستويات التحشيد الأميركي والإسرائيلي. وكما أن مساندة حزب الله، مع ما استلزمته من ثمن عزيز في المنطقة الحدودية، عزّزت من قوة الموقف الفلسطيني المقاوم (باعتراف الصهاينة أنفسهم)، فإنّ حزب الله يعزز من خلال تأكيد فاعلية المحور ردع المقاومة في لبنان (تُسمى التحالفات المعزّزة للردع) كأن يكون قادراً على رفع خيار الحرب الإقليمية الذي له أثر وازن في حسابات صانعي القرار الأميركيين والصهاينة.
3. إعادة شحن الردع: في ظل العدوانية الإسرائيلية المتجددة والتعبئة المجتمعية في الكيان واستنفار الجيش لتحقيق منجزات حاسمة لمحو آثار 7 أكتوبر، وتدفقات السلاح الأميركي إلى الكيان، كان على حزب الله أن يظهر للصهاينة عن بعض قدراته وجرأته بما يؤثر في حساباتهم لتغيير الواقع الحدودي والاستراتيجي في لبنان، وهذا ما تحققه عمليات المقاومة منذ 8 أكتوبر. وعلى خلاف مقولات بعض خصوم حزب الله في الداخل، تقول التقديرات الأميركية والإسرائيلية إن حزب الله اختار ما يسمّى في الدراسات الأمنية «النطاق الذهبي» حيث شنّ معركة قوية إلى درجة كافية لتحقيق المساندة والردع لكن دون أن تصل إلى مستوى إحداث حرب واسعة. ففيما كان يريد الصهاينة تأديب حزب الله باستعراض القوة والإجرام في غزة (الردع بالمثال)، طبّق الحزب نظاماً ردعياً ذا عناصر صلبة (قدرات عسكرية وكفاءة عملانية وتكتيكية) وناعمة (مرتبطة بالوعي والمشروعية) مصمماً بدقة للتأثير في حسابات العدو بما يتلاءم مع ثقافته وتصوراته للتهديد وقيمه الاستراتيجية، مثل التهديد باستهداف المستوطنين والمدن الرئيسية وتعريض أصول العدو الاستراتيجية للاستهداف. وفي هذا السياق أظهر الحزب مرونة عالية أمام قدرات الهجوم الإسرائيلية حيث قلّص نقاط الضعف القابلة للاستهداف وكان قادراً على احتمال استهدافها والتكيّف مع ذلك، وهو ما انعكس في استمرار المقاومة في القتال بفعالية لعدة أشهر انطلاقاً من حزام حدودي ضيق جداً تعرّض لعدة آلاف من الغارات الجوية والقصف المدفعي بأسلحة محرّمة دولياً.
4. منع العدو من الهيمنة على التصعيد. بهدف التمكن من إنجاز الأهداف الثلاثة أعلاه كان على الحزب أن يتمكن من فرض معادلات وقواعد تواكب مجريات القتال بحيث لا يمسك العدو بسلّم التصعيد فيفرض أثماناً عالية لدرجة لا تعود فيها المقاومة قادرة على المبادرة. وعلى هذا الأساس نجح الحزب في تحديد وتثبيت «عتبات التصعيد» التي في حال تجاوزها العدو سيتعرض لعقاب رادع، مثل استهداف المدنيين أو العاصمة أو منشآت مدنية حيوية. والمعادلة هنا ليست حسابية، فإن قام العدو بالتصعيد بعدة درجات قد تكفي مجاراته بدرجة تصعيدية واحدة، لأن حسابات الثمن والخسارة مختلفة. لطالما حقّقت قوى المقاومة منجزات استراتيجية على الرغم من تفوّق العدو وفق المنطق الحسابي البسيط.
في المحصّلة، يعمل حزب الله على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية وفق خطة عملانية مرنة بلحاظ طبيعة المعركة (تحدّد الأهداف العسكرية والمحاذير وكيفية إدارة القتال...) تندرج فيها أفعال تكتيكية (أنواع السلاح وطبيعة الأهداف وآليات العمل...). ما دام الحزب قادراً على تحقيق هذه الأهداف وفق أكلاف وأثمان (بشرية ومادية وسياسية) يمكن احتمالها والتكيف معها، فسيكون قادراً على تقديم رواية نصر متماسكة.
* نص من محاضرة ألقيت في الجامعة الأميركية في بيروت بدعوة من النادي الثقافي الجنوبي بتاريخ 4 آذار 2024
** أستاذ جامعي
0 تعليق
تم إرسال تعليقك بنجاح، بانتظار المراجعة.
يبدو أن هنالك مشكلة، يرجى المحاولة مرة أخرى.