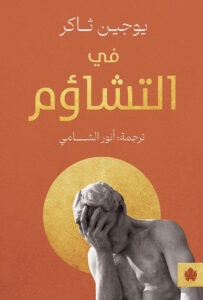
في نثر أخّاذ يلامس الشعر، يكتب يوجين ثاكر شذرات منضبطة ومكثّفة، ما يسمح له بإزالة الضباب عن التشاؤم حتى تنكشف لنا الرؤية شيئاً فشيئاً: التشاؤم نشيد جنائزي طويل يرثي العالم بقدر ما يرثي صاحبه، وهذا الرثاء قادرٌ على فكّ السحر عن العالم لأنّ المتشائم على يقين بأن الوجود، في نهاية المطاف، منذور للعدم، فلا الأساطير، ولا القداسة، ولا البطولة تشفع لتغيير هذه الحقيقة أو تجميلها. فالمتشائم يعلم أن لا عزاء لتعاسته الوجودية، وبذلك فإنه متسلّح بتشاؤمه الذي يسمح له بتقبّل هذا الوجود المضني والإذعان لمساراته. التشاؤم إذاً هو «حب القدر». هكذا يحبّ المتشائم قدره، لكن بطريقته الخاصة، هو منصاع لمصيره، لا يضع آمالاً مثلما لا يأبه بالمآلات القادمة. قائمته المعيارية بيضاء، لا تعريف عنده لما هو الأسوأ ولا يمتلك ملامح لما هو الأفضل، جلّ ما يطمح إليه هو السكون عوضاً عن الضوضاء التي تدفعه غالباً نحو اللجوء إلى كهفه، أو الغوص وحيداً في تذمره، أو الغرق في السأم. والتشاؤم عند ثاكر هو نفيٌ تام، وبالدرجة الأولى نفيٌ للقائم، أي للبداهة، لحالة الأمور كما «هي عليه»، مثلما هو رفض مطلق للتفكير بطريقةٍ أخرى، ملتوية، تتمثل بسؤال: «ماذا لو كان الأمر على هذا المنوال؟»، ذلك أن العالم مليء بالاحتمالات السلبية، وكل محاولة للتجاوز قد تُعرّض صاحبها إلى الوقوع في مأزقٍ تراجيدي جديد، يفوق بتراجيديته الموقف الذي سبقه. ليس للفشل علاقة هنا. العلاقة السببية غامضة أساساً، إذ غالباً ما تبرز النتيجة في حين يبقى السبب مخبوءاً. إنّ المتشائم يدرك «جوهرانية» الفشل، أي حقيقة وجوده، واشتغاله الخفيّ، وفي حال حدث وفشل المرء، فالمتشائم لا يتساءل عن السبب إنما عن التوقيت. هكذا يتيح التشاؤم لصاحبه أنّ يقرّ إقراراً جلياً أنّ الحياة مجبولة بالقساوة، وأن اللااكتمال هو الشكل الذي تتخذه الأشياء المحكومة بنظامٍ مبهمٍ، وما من خيار أمام المتشائم سوى المضي قدماً متمسكاً بذريعة تلخّص بالتالي: على الأقل لقد حاولت. وهذا ليس تمسكاً بريئاً بالأمل فقط كما يستخلص الكاتب، إنما هو التفاؤل بعينه.
ينزع ثاكر الطابع السطحي الذي اتّسم بالتشاؤم، ويقرر أن يكون نداً للتاريخ الذي أمعن في هجاء المتشائمين، وغريماً للإرث الطويل من الرفض الذي لحق بالتشاؤم وطرده بعيداً عن مواضيع التفكير. في كتاب «في التشاؤم»، يهشّم ثاكر تلك الدلالة (التشاؤم/ المتشائم) التي خنقتها وظيفة الوصف؛ بعدما صار التشاؤم ملازماً لتوصيف المزاج السيّئ والطباع المعكّرة والنظرة المضطربة السوداوية. يصقل المؤلف في المقابل معنى التشاؤم باعتباره حالة البداءة، والحقيقة الوحيدة المغمّسة بالمرارة التي لا مفرّ إلا عبر النظر من عدستها. ستتيح هذه العودة إلى التشاؤم عند ثاكر قراءة الوجود والعالم من جديد، في تنظير لا يخفي انحيازه، ينبثق من ذاتية فاقعة تنزلق أحياناً نحو الاعتباطية، كانطلاقة صاحبها من مسلماتٍ ليست بالمبدأ سوى خلاصات تخصّه، حتى بدا كتابه المعنون «في التشاؤم»، الذي يشير إلى تفحّص هذه المسألة، أقرب ما يكون إلى مديح التشاؤم، ويُخيّل إلينا أن المتشائم هذا لهو نسخة معاصرة لأبيقوريّ نزق التبست عليه الأمور حتى بات غارقاً في العدمية.
يقطع يوجين ثاكر شوطاً جديداً في هذا الملعب؛ في الجزء الثاني المعنون بـ«قديسو التشاؤم»، يغوص في سيَر «الآباء»؛ فلاسفة اشتهروا بتشاؤمهم أكثر من رواج فلسفتهم. لكن التشاؤم في الشوط الثاني يبدو أكثر ليونة، مثلما يبدو المؤلف أكثر خفة على مستوى أسلوب الكتابة وجوهر المعالجة. يقع القارئ للوهلة الأولى أمام تناقض صارخ، لكن جذاب. فالعنوان كمن يزوّد بوصفة ترمي إلى خلط الزيت مع الماء، فالقداسة والتشاؤم يبدوان إلى حدٍّ بعيدٍ نقيضين، إذ مهما تشبّث من يروم القداسة بالزهد والتنسّك، يبقى أنّ تمسكه بالإله يحول أمام التشاؤم الذي هو حالة أرضية مفرطة في واقعيّتها. يبدّد ثاكر في مقدمته الأثر الغائم الذي يتركه العنوان. عندما كان «للفلسفة قديسون، ولكن حكايتهم ليست بالحكايات السعيدة، هناك مثلاً القديسة كاثرين الاسكندرانية أو كاثرين ذات العجلة، حيث كُنيت بأداة التعذيب التي عذبت بها»، يذهب ثاكر إلى تدوين سيرة فلاسفة كانوا أشدّ المتشائمين مغالاة. وما دام التشاؤم، كما أخبرنا في الجزء الأول («في التشاؤم»)، ليست له فلسفة بل العكس، حيث ليس من فلسفة للتشاؤم بل هناك متشائمون كانوا فلاسفةً، يأخذ ثاكر على عاتقه تدوين سيرة هؤلاء. لسنا أمام سيَر ذاتية، حيث غرض الكتابة التوثيق والتأريخ، بل أمام لحظاتٍ لها طابع استثنائي بأنها حوادث غريبة حصلت في حياة هؤلاء المتشائمين. ما يهم ثاكر في «قديسو التشاؤم» هو الالتواء الذي حصل، ما جعل الشخص/ الفيلسوف ينعطف عن مساره المعهود. ثاكر معنيٌّ بالحبكة وغير معني بتتبع المراحل، وتعقّبها، والإسهاب في كتابتها. هكذا لا يعود السرد فضفاضاً بل محصور في نطاقٍ محدد، وقد برّر خطوته بحجة لامعة «إن سير القديسين غالباً ما تتضمّن روايات لا تعبئ العين بالتحقق أو الإثبات». ومن بين كثيرين يمكن الكتابة عنهم، اختار ثاكر بشكلٍ تعسفي، كما اعترف، قلّةً لتدوين سيرتهم. بنظرة سريعة لتاريخ الأدب المتمثل برواية «آلام فيرتر»، أو «أناشيد مالدورور» أو مسرح أنطونين أرتو، يجيز حضور التشاؤم أو ربما نستنتج أن التشاؤم في الشوط الأخير هو عرّاب الأدب، لكن ثاكر يترك الأدب جانباً ويتمسّك عوضاً عن ذلك بالفلسفة. هناك خيط رفيع يفصل بين التشاؤم والتفاؤل في الفلسفة حتى يكاد التمييز بينهما في حالات كثيرةٍ يكون مستحيلاً.
يشرّح التشاؤم بوصفه علّة أنطولوجية وليس مجرد غواية تجذب محبّي التذمر
كان كارل ياسبرز قد ركّز في فلسفته على ما سمّاه «المواقف الحديّة»، وهي المواقف التي تدفع المرء إلى الحافة ويجد نفسه مقيداً بما يحدث فيها. على النحو نفسهِ، يرصد ثاكر الحالات القصوى التي حصلت في حيوات الفلاسفة الذين اختاروا تدوين سيرتهم، ما سيتيح لنا قراءتهم بوصفهم أشخاصاً يمارسون الفلسفة في بحثهم لأنفسهم عن أبواب خلفية، عن باحات كبيرة تسمح لهم بالركض بحرية، ذلك أنّ الانفلات من هذا التشاؤم لا يحصل سوى بالتوجّه صوبه والانصهار فيه. نحن إذاً نقرأ شكلاً من أشكال الفلسفة التي سمّاها ثاكر «فلسفة صغرى»، حيث الفلاسفة في صدد تطبيق فلسفتهم وليس فقط الانشغال النظري بها كما هو حالها كـ«فلسفة كبرى». وحيثما «في سير القديسين يُكنى القدّيسون عادةً باسم مكانٍ ما»، سيُعير ثاكر اهتماماً للمكان كفضاء جغرافيّ. هكذا سنقرأ عن مكتبة كيركغارد الضخمة، وقاعة شوبنهاور الفارغة من المستمعين، وسنتخيل غرفة بليز باسكال حيث حدثت «رؤياه»، كما سنتخيل عزلة نيتشه وهو منهمك في كتابة رسائله المجنونة. ورغم أنّ التشاؤم في نظر ثاكر خلل أنطولوجي في الأصل، ولا أحد ينجو منه، غير أنه في كتابه الثاني يظهر لنا أنه دواءٌ بقدر ما هو داء. سنجد أن الأمراض المستعصية المزمنة هي سمات يشترك فيها جميع من كتبت سيَرهم، كذلك لا انتماؤهم لعصرهم كما الإحساس بالاعتلال حيال الوجود والنظرة السقيمة تجاه العالم، إلا أن كل هذه الأمراض ستجد لها في الكتابة و«البحث عن الحقيقة» -حقيقتها - ترياقاً. والحال، أننا سنعثر على الأهم، سنجد «محبّة القدر» تلك، حيث الإذعان للقدر هو الشرط الأساسيّ الذي يتوجّب على المحبّ قدرَه التحلي به. ففي هذا الإذعان، كما سنكتشف، انصهار المريض مع مرضه، وبالنسبة إلى ثاكر هذا ما يشكل مفتاح الشفاء.
حين تصل إلى الضوء الكامن في نهاية النفق المظلم، لن ترى أنّ النفق مظلم من الأساس. لعلّ هذه هي القناعة التي تُتيحها الفلسفة عندما تفكّر في التشاؤم، كأنّ الفلسفة عند يوجين ثاكر هي المخرج الوحيد من هذا الشقاء، ومهمّتها تقتضي الحفر عميقاً في جذور العلّة وليس مجرّد الوصف والمحاكاة أو التخمين والتخييل كما يشتغل الأدب وكما تفرض طبيعته عليه. أنّ تسير وسط العتمة كمن يرى. أن تعترف أن البصر يجترح نفسه من العماء. لا يتخيّل يوجين ثاكر سيزيف سعيداً وعلى الأرجح أنه لا يبتغي ذلك، بيد أنّ جلّ ما يريده هو تصوّر كيف يمكن للعيش أن يكون ممكناً.






