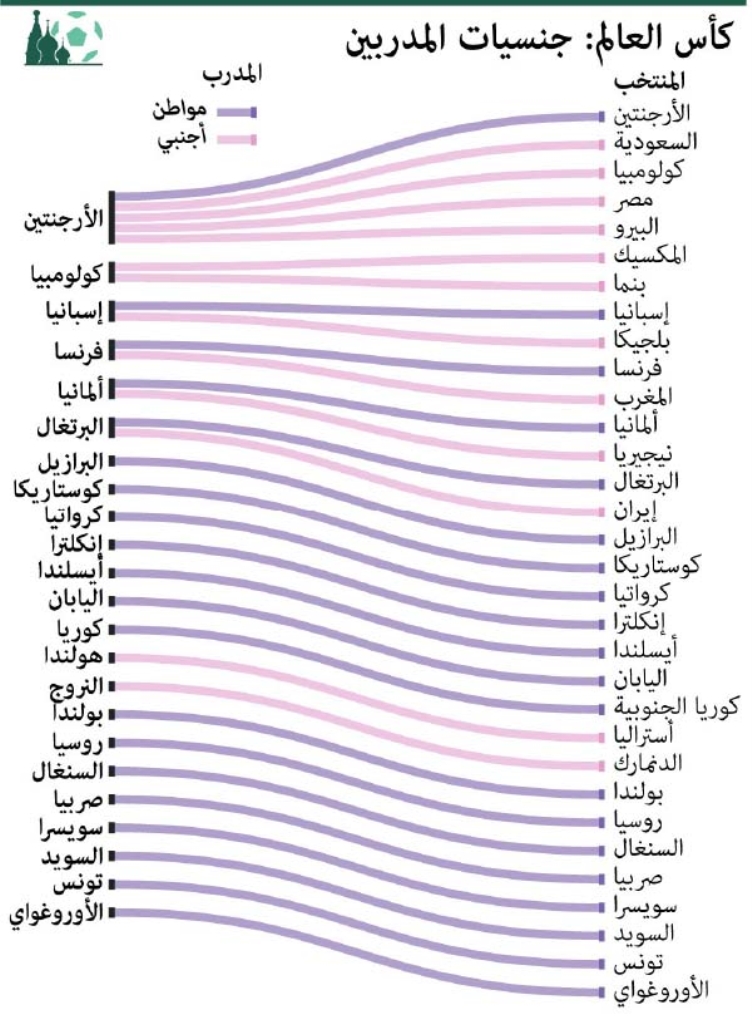
البداية لا بد أن تكون من منتخب الأرجنتين باعتبار أنه أكثر مَن تثار حوله علامات الاستفهام والشكوك حالياً بين المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب المونديال. مدرب المنتخب حالياً هو خورخي سامباولي. بعد تجربة إدغاردو باوزا الفاشلة تماماً والتي لم تدم سوى 8 مباريات رسمية في تصفيات المونديال، واصلت الأرجنتين تقليدها بالاعتماد على المدرب الوطني. في السابق، حققت «بلاد التانغو» المجد مع مدربين وطنيين هما الأنجح في تاريخها حتى الآن والحديث هنا عن سيزار لويس مينوتي الذي قاد «ألبيسيليستي» للقب مونديال 1978 في جيل ماريو كيمبيس، وكارلوس بيلاردو الذي قاده للقب مونديال 1986 ونهائي مونديال 1990 في جيل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، علماً أن غوييرمو ستابيلي هو المدرب الأطول فترة مع الأرجنتين لمدة 21 عاماً منذ 1939 حتى 1960. وقع الخيار على خورخي سامباولي الذي كان قد حقق نتائج لافتة مع منتخب تشيلي وقاده لدور الـ 16 في مونديال 2014 وكان قريباً من الإطاحة بالمضيف البرازيل لولا ركلات الترجيح وإلى لقب «كوبا أميركا» في 2015. في الأرجنيتن، كما في جارتها البرازيل، ثمة مسألتان مهمتان في الركون إلى المدرب الوطني إذ فضلاً عن الأسباب السالفة، فإن من المستحيل أن يكون المدرب من أوروبا أو أن يكون مثلاً برازيلياً للأرجنتين وأرجنتينياً للبرازيل. لكن في بلاد مارادونا، حالياً، ثمة مسألة مهمة أخرى وهي وجود النجم ليونيل ميسي. إذ ليس خافياً أن اختيار سامباولي كان سببه بالدرجة الأولى إيجاد التوليفة المتجانسة والجماعية بقيادة «ليو» لا أن يكون كل شيء على عاتق نجم برشلونة. حتى الآن يبدو واضحاً أن سامباولي لم ينجح في المهمة وفقاً لما أظهرته النتائج، تحديداً عند غياب ميسي، كما حصل في الخسارة الودية الفادحة أمام إسبانيا 1-6، إذ لا يزال سامباولي غير قادر على تكرار تجربة بيلاردو مع مارادونا عندما أوجد تشكيلة متجانسة ومساعِدة إلى جانبه كما حصل في مونديال 86 بوجود خورخي بوروتشاغا وخورخي فالدانو، أو في مونديال 90 بثنائيته مع كلاوديو كانيجيا. سامباولي لا يزال يسابق الوقت لإيجاد الحلّ قبل المونديال.
الأندية أولاً
ما يُمكن ملاحظته، بنسبة كبيرة، حالياً، أن المدربين النجوم في العديد من البلدان الكبرى كروياً ليسوا على رأس الإدارة الفنية لمنتخبات بلادهم مثل جوسيب غوارديولا في إسبانيا وزين الدين زيدان في فرنسا وماوريسيو بوكيتينو في الأرجنتين وجوزيه مورينيو في البرتغال، وهذا له أسبابه الكثيرة وفي مقدمها طبعاً تفضيل هؤلاء تدريب الأندية.
بالانتقال إلى الجارة البرازيل. فإن الوضع يبدو مشابهاً. الكلمة الأولى، تاريخياً، هي للمدرب الوطني. أسماء برازيلية كبيرة أشرفت على «السيليساو» يأتي في مقدمها ماريو زاغالو الذي قاد المنتخب التاريخي بوجود الأسطورة بيليه وجيرزينيو وتوستاو وغيرهم للتتويج بلقب مونديال 1970 ثم ساهم كمساعد لكارلوس ألبيرتو بيريرا في التتويج بلقب مونديال 1994، فضلاً عن تتويج المنتخب بلقب مونديال 1958 مع فيتشينتي فيولا ولقب مونديال 1962 مع أيموري موريرا ولقب مونديال 2002 مع لويز فيليبي سكولاري. الإصرار ظل على المدرب الوطني رغم التراجع منذ مونديال 2006، وتحديداً بعد كارثة مونديال 2014 بقيادة سكولاري حيث عاد كارلوس دونغا لتدريب «السيليساو»، لكنه، مجدداً، لقي الفشل كما في فترته الأولى. لكن على خلاف الأرجنتين، عثرت البرازيل على مدربها الأمثل وهو تيتي الذي قلب الأمور رأساً على عقب وأعاد «السيليساو» إلى الواجهة كأبرز المنتخبات في العالم بعد أن تمكن من إيجاد مجموعة متجانسة لا تعتمد فقط على النجم نيمار، وهو ما لم ينجح فيه، حتى الآن، سامباولي مع «أرجنتين ميسي».
أوروبياً، وعند الحديث عن المدرب الوطني، فإن الأنظار تتّجه مباشرة إلى دول كبيرة، مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا. من بين الحاضرين في كأس العالم حالياً، «المانشافت» هو الأكثر استقراراً بين المنتخبات العالمية مع المدرب الوطني. يكفي القول إن 11 مدرباً محلياً فقط أشرفوا على المنتخب الألماني في تاريخه. الميزة في ألمانيا، بصفة عامة، أن المدرب «يعمّر» طويلاً. مدربون عظماء قدّمهم «المانشافت» بينهم سيب هيربرغر الذي قاده للقب مونديال 1954 بعد «معجزة بيرن» الشهيرة أمام المجر والذي استمر في صفوفه لفترتين من 1936 حتى 1942 ومن 1950 حتى 1964، وهيلموت شون الذي قاده للقب مونديال 1974 وبقي في صفوفه 14 عاماً من 1964 إلى 1978 والأسطورة فرانتس بكنباور الذي قاده للقب مونديال 1990 ونهائي مونديال 1986، حيث يمكن القول إن الفترة السيئة الوحيدة أو «الخيار الأسوأ» للألمان كان اعتمادهم على إيريك ريبيك الذي قاد المنتخب لعامين فقط.
يواكيم لوف هو امتداد لهذه المدرسة الألمانية في التدريب، لا بل يمكن القول إنه أحد أساتذتها. مضى على وجود «يوغي» مع المانشافت 12 عاماً، يمكن وصفها بالناجحة بامتياز إذ على صعيد المونديال فإنه قاده إلى المركز الثالث في كأس العالم 2010 والتتويج بلقب كأس العالم 2014 بعد نتائج باهرة فضلاً عن المركز الثالث في كأس العالم 2006 كمساعد ليورغن كلينسمان. لوف بات، بالتالي، أول مدرب أوروبي في التاريخ يحرز لقب كأس العالم في قارة أميركا الجنوبية. هو الذي كان مجهولاً للجميع عندما كان إلى جانب كلينسمان ليتحوّل في السنوات الأخيرة إلى واحد من أفضل المدربين في العالم واستطاع رفع المنتخب الألماني إلى مرتبة متقدمة جداً، وحتى أنه تخطى أسلافه إذ إنه المدرب الأكثر فوزاً مع «المانشافت» في 106 مباراة بنسبة 66,2 % والأكثر إشرافاً عليه في 160 مباراة... والرحلة لا تزال مستمرة.
عند الحديث عن المدرب الوطني فإن الأنظار تتّجه مباشرة إلى دول كبيرة مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا
في إسبانيا، الأولية، أيضاً، للمدرب الوطني. هذا الاتجاه تاريخي منذ انطلاق مسيرة «الماتادور» وقد ساهم في ترسيخه قيادة خوسيه فيلالونغا المنتخب للتتويج باللقب الأول للبلاد في كأس أوروبا عام 1964 ثم كان اللقب الثاني في كأس أوروبا أيضاً عام 2008 مع لويس أراغونيس. لكن الفترة الذهبية للمنتخب كانت مع القدير فيسنتي دل بوسكي الذي قاد «لا روخا» للقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2012. في إسبانيا، هناك مسألتان تعزّزان فكرة المدرب الوطني وهي وجود أهم اللاعبين الإسبان في «الليغا»، فضلاً عن مسألة مهمة وهي المنافسة التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة وأهمية وجود مدرب محلي يستطيع إيجاد التناغم في صفوف المنتخب خصوصاً عندما تحتدم المنافسة بين هؤلاء خارجه. كذلك، فقد برزت في السنوات الأخيرة مسألة انفصال كاتالونيا، وما تعنيه، حيث يصعب طبعاً على مدرب أجنبي التعامل مع الذيول التي تنشأ في كل مرة من هذه المسألة والتي يتأثّر بها المنتخب، وهذا، كله، ما نجح فيه دل بوسكي. خولن لوبيتيغي يواصل المهمة، بنجاح، حالياً بعد أن أُوكلت إليه المهمة خلفاً لدل بوسكي. إذ رغم أنه لا يحمل اسماً تدريبياً كبيراً، إلا أن لوبيتيغي استطاع أن يعيد، سريعاً، «الماتادور» إلى الواجهة بعد التجربتين المريرتين في كأس العالم 2014 وكأس أوروبا 2016 ليصبح الآن بين المرشحين الأبرز للقب المونديال الروسي.
فرنسا، من جهتها، عرفت مرة واحدة مدرباً أجنبياً. كان ذلك بين عامي 1973 و1975 عندما أصبح الروماني ستيفان كوفاش أول (وآخر) مدرّب أجنبي في تاريخ «الديوك». لكن تلك التجربة كانت فاشلة بامتياز. بالعودة إلى أرشيف الكرة الفرنسية فإن كوفاش قام خلال تلك الفترة القصيرة باستدعاء 70 لاعباً للمنتخب الفرنسي ولم يحقق أي شيء، ليخلفه مساعده ميشال هيدالغو الذي أسّس لمرحلة جديدة في تاريخ «لي بلو» عندما أشرف على أحد أفضل المنتخبات الفرنسية بقيادة ميشال بلاتيني وأحرز معه أول ألقابه في كأس أوروبا عام 1984. الفترة الثانية الأهم للمنتخب الفرنسي كانت مع مدربين وطنيين آخرين هما إيميه جاكيه المتوَّج بلقب مونديال 1998 وروجيه لومير المتوَّج بلقب كأس أوروبا 2000. وفي 2012، اختارت فرنسا أحد نجوم التتويج بآخر لقبَيها. ديدييه ديشان هو الآن مدرب «الديوك». شخصيته القيادية سابقاً سواء مع المنتخب أو يوفنتوس الإيطالي جعلتا منه المدرب المثالي للمنتخب في الوقت الحالي. وبالفعل، فإنه تمكن من قيادته إلى ربع نهائي مونديال 2014 وخسر بصعوبة أمام ألمانيا 0-1 وإلى نهائي كأس أوروبا 2016. الفرنسيون ينتظرون من ديشان أن يعيدهم إلى منصات التتويج عبر المونديال المقبل.
فلننتظر ما في جعبة الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا
أخيراً فإن إنكلترا سارت تاريخياً مع المدرب الوطني. كان لقبها الوحيد بقيادة مدرب محلي هو آلف رامسي في مونديال 1966. لكن في عام 2001 وبعد سلسلة إخفاقات وجد الإنكليز أن لا بد من كسر التقليد والاعتماد على المدرب الأجنبي. شهد ذلك العام وصول أول مدرب أجنبي في تاريخ منتخب إنكلترا هو السويدي سفين – غوران إيريكسون. لكن التجربة لم تنجح رغم وجود جيل مايكل أوين وديفيد بيكهام وستيف ماكمانمان وغيرهم. ثم كرّر الإنكليز التجربة مع اسم أهمّ هو الإيطالي فابيو كابيلو، لكن الفشل كان أيضاً حليف الإنكليز رغم جيل واين روني وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد وجون تيري وغيرهم. سرعان ما عاد هؤلاء إلى المدرب الوطني. لكن التجربة حالياً مع غاريث ساوثغايت تبدو مختلفة. إذ إن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اختار مدرباً وطنياً على عكس أسلافه بعد تجربته مع منتخب الناشئين خصوصاً في ظل العديد من المواهب حالياً، وحتى أن ساوثغايت لم يخف بأنه يريد السير على خطى التجربة الألمانية في السنوات الأخيرة. ما هو متوقّع إذاً، أن يكون لقب المونديال من نصيب مدرب وطني وأن يحظى بالتكريم في بلاده. لكن، مهلاً، فلننتظر ما في جعبة الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا. لا يجدر نسيان بلجيكا.


