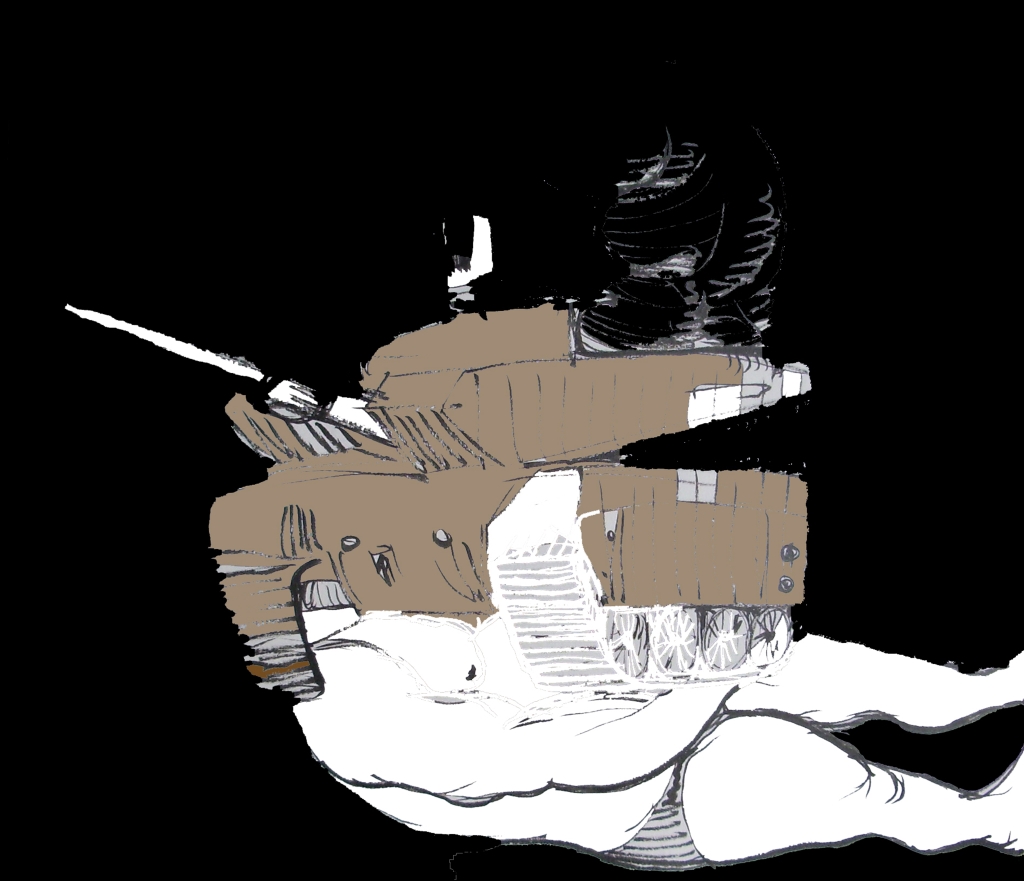
الفنان السوري محمد عمران - 2013/2014
لا مجال سوى للمعجزات في الحرب، هذا ما تنقله لنا روايات الحرب السورية. فليس هناك ما هو عادي، ومألوف، ويحمل الوجهين. وسط بحث المؤلفين عن آخر دمعة يمكن استنزافها من عين كل قارئ، وكأن همّهم هو كسب الجوائز وليس السعي نحو الأدب، أو الكتابة لعرّابي الجوائز وليس الكتابة للقراء، يبدو أن الحرب أسقطت قذيفتها على الرواية الأدبية وقتلتها.
الانتصار للسردية
تغلب على معظم الروايات التي تكتب عن الحرب في عالمنا العربي، رغبة جامحة عند المؤلف في الانتصار لسردية معيّنة، ولو اضطر أن يغلفها بهيئة إنسانية، كما تجري العادة. روايته ليست حكاية الناس الذين يعيشون الحرب، إنما هي حكاية تُخضِع «ناس الحرب» إلى التأطير. على هذا المنوال، يصوّر الروائيون «الناس» في كتاباتهم على أنهم أفواج من البائسين الذين لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم. بائسون يفتكون ببعضهم البعض وينتظرون مخلصاً لينتشلهم من واقعهم.
يتعامل أولئك مع الرواية بفظاظة تشبه بذاءة الصحافيين الذين ينقلون مجازر الحرب بأدق تفاصيلها ويبثون صور الجثث علناً بلا تردد. روايات الحرب هذه، لا تحمل ثقلاً، أو موضوعات أخرى أعمق وأبعد من الحدث المرئي الذي يطوف على الوجه، أي الحرب. تبدو هذه الروايات وكأنها تدور حول ذاتها، تبدأ من الحرب وتعود إليها، وهي، بلا شكٍ، تمر فيها. فلا شيء يجول في ذهن المؤلف غير تصوير الحرب والإسراف في وصفها. يكتب عن المدافع، عن الجثث، عن الانتصارات وعن الآلام. الطيبون والأشرار واضحون تماماً بالنسبة إليه، هم شخصياته الروائية: الطيّب هو الضحية والشرير هو الجلاد. بيد أن الطرفين ما هما سوى نسخٍ مرسومة بناءً على صور المتحاربين في حكاية الواقع، وما البطل سوى اللسان السياسي للمؤلف. تغدو روايات الحرب هذه، مجرّدة من طابعها الأدبي وأقرب ما تكون إلى بروباغندا سياسية إذ إنها تعيد إنتاج الأخبار ومقالات الصحف في سياق ينشغل المؤلف فيه بالمرافعة وإلقاء التهم، في رواية تحولت إلى محكمة.
فعلى عكس تجربة جورج أورويل مثلاً، الذي شارك في الصراع الإسباني ضمن صفوف الأناركيين وحكى مشاهداته في الحرب وتجربته في روايته/سيرته الذاتية «الحنين إلى كتالونيا»، فأولئك المؤلفون، انحازوا إلى السردية التي يتمنونها، وأعلوا من شأنها على حساب الرواية، فيما أورويل انتصر للأدب وبقي مجاهراً في آرائه.
بحثاً عن الخلاص
يقول الفيلسوف والروائي جان بول سارتر في كتابه «ما الأدب»: «كل كتاب يقدّم خلاصاً ملموساً انطلاقاً من استلاب خاص». راهن سارتر على تفاعل الحريّات بين كل من المؤلف والكاتب، لكن النقطة الأهم تكمن في أن سارتر كان مراهناً على التناقض بين الـ «أنا» و«الآخر»، بحيث أن الخلاص لا يأتي مجّاناً إنما على حساب «شيء» أو «أحد». ما ينتجه يسمى(زوراً) بـ «الأدب» الآن هو أنماط محدّدة من الاستهلاك التي لها دلالات عديدة. والدلالة الأكثر سطوعاً تتعلق بالاستلاب والتغريب اللذين تمارسهما الروايات الجديدة عن الحرب، وليس بالخلاص، ولو كان هناك استثناءات قليلة. هناك حاجة ماسّة إلى الأدب، وهي حاجة فردية وجماعية، قوامها اللعب مع الواقع والتماهي معه. استغلال حاجة القارئ ورميها في خانة الاستهلاك، لا تقلّل من شأن الأدب كما أنها لا تعني أن هذه الحاجات ليست حقيقية، بل على العكس، فالحاجة إلى اللعب مع الواقع والتماهي معه شكّلا تاريخ الأدب بأسره. لطالما كان الأدب، والرواية تحديداً، ملاذاً للقراء لأنه يؤمن لهم عوالم أفضل من التي يعيشون فيها، أو يهديهم رؤية ثاقبة بدلاً من العماء الذي يصيبهم به واقعهم المأساوي. إن قراءة أعمال كتّاب مثل خالد حسيني تفتح مجالاً للغوص في نص يتيح لقارئه التماهي العاطفي والإسقاط النفسي بما يساهم في عملية «التطهير» التي يرجوها القارئ عندما يلج في عالم الأدب. قراءة الحسيني هي غوص في نص يشكّل لقارئه خلاصاً مؤقتاً. نصّ يشعر قارئه بأنه على قيد الحياة. لنصّه القوّة الكافية لإنقاذ القارئ من شعور الوحدة حيث يظهر له أن وجعه الحقيقي هو أخفّ وطأة من أوجاع الآخرين، ومصائبه أقل من مصائب الأبطال والشخصيات التي يقرأ عنهم. هو إذاً، لا يسمح بهذه المقارنة فحسب، بين الحقيقي والخيالي بل يثيرها ويتوق إليها أيضاً. قراءة الحسيني هي تجربة تؤكد هذا التفاعل بين الحريات، كما أن القارئ يحوز على ما أراد الحصول عليه أثناء قراره (الحر) عندما قرر قراءة نصوصه، فالقارئ سينال خلاصه بعدما يتعرض «الآخر» (الشخصيات) للاستلاب.
تقويض المسار
تُراوح دوافع كتابة الحرب بين مؤلفٍ وآخر. بدءاً من البحث عن تفسير للفوضى العارمة، وصولاً إلى إقحام الكاتب لذاتيته داخل الحرب بشكلٍ خيالي ليكون طرفاً مشاركاً في السردية القائمة خارج الأدب، أي في الواقع الخارجي. نفهم حاجات القارئ من الأدب، كما أننا نعلم أن للكاتب حاجاته أيضاً، ولو أنه لا يبوح بها علناً تاركاً إيانا نكتشف ضمورها وحدنا في السّر. فكتّاب رواية الحرب السورية مثلاً، لم ينجحوا في إضافة أي جديد أسلوبياً، أي بطريقةٍ بعيدة من المشهدية الديستوبيّة، كما أنهم لم يتعاملوا مع موضوع الحرب كحدث له اعتبارات وجوديةٍ، إنما اختزلت أعمالهم في بروباغندا سياسية وقلبوا معادلة سارتر حتى أصبح خلاص الشخصية مقروناً باستلاب القارئ. يبقى أن الحرب، بالرغم من وحشيّتها ومآسيها، تحوي على الكثير من الأفراد الذي يحاولون النجاة كل يوم. أفراد عاديون، مألوفون، لا ضحايا ولا جلادون وربما الاثنين معاً، يعيشون قصصاً عديدة، ويفكرون كثيراً، ويستنتجون خلاصات ثمينة. ربما علينا أن نبدأ بالكتابة عن هؤلاء، علينا أن نصغي إليهم.


