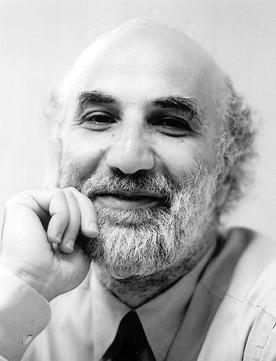
الكتاب الذي بين أيدينا صادِم لقُرّاء العربيّة ومُبهِر لقُرّاء الإنكليزيّة بين الصهاينة. هذا رجل تحرّرَ من مشاعر الرأي العام العربي وأحاسيسه في سنّ مبكرة. القضايا العربيّة لم تعنه يوماً. قضيّة فؤاد عجمي هي الخروج من سجن الفقر في حي الكرنتينا حيث نشأ وعاش تحت سقف من الزنك إلى عالم حفلات كبار القوم في واشنطن ونيويورك. معركته معركة شخصيّة: تسلّق السلّم الطبقي والتنصّل من ماضٍ أثقله بفقره ومعاناته وحرمانه. عجمي هو العربي الوحيد الذي انقطع لنحو عقد من الزمن عن زيارة بلده بعد وصوله إلى أميركا بهدف الدراسة في «كليّة شرق أوريغون». وأسلوب عجمي الفائق الميلودراميّة يملأ صفحات الكتاب ويفيض بالتنميط الاستشراقي عن بني جلدته. تعميمات غير علميّة عن ملايين من البشر، لكن هذا تماماً ما أحبّه فيه المستشرقون والسياسيّون الصهاينة في أميركا (هو ظاهرة أميركيّة محض، ولم تنتقل إلى أوروبا أو غيرها من البلدان، مع أن دولاً خليجيّة بدأت باكتشافه قبل وفاته حيث دعيَ لحضور مؤتمرات). صهاينة واشنطن ونيويورك اكتشفوه. إنه الملوّن الذي لا يتورّع عن ذمّ اللونيْن الأسود والأسمر وتبجيل اللون الأبيض. كم يحب العنصريّون البيض سماع ذلك.
تبدأ سردية السيرة الذاتيّة لعجمي بحكاية عن فتاة اسمها «دلال» (أضع الاسم بين مزدوجين لأنني أشكّك في الرواية من أساسها كما سيظهر أدناه). وقعت «دلال» ضحيّة «جريمة شرف»، هو يقول. و«جرائم الشرف» ليست حكراً على المجتمعات العربيّة والإسلاميّة كما روّج مستشرقون، عرب وغربيّون. جرمين تيليون كتبت كتاب «جمهوريّة أولاد العم: قمع النساء في المتوسّط»، وأهميّة الكتاب الذي لم ينل قسطاً من الاهتمام أنه استعمل معياراً بحثياً يشمل الغرب والشرق معاً، وهذا غير مألوف أبداً في الدراسات المتعلّقة بالمرأة. الكاتبة تمرّدت على فرضيّات البحث الغربي عن المرأة لتُظهر صفات ثقافيّة واجتماعيّة مُشتركة بين دول في جنوب المتوسّط ودول في شماله. لكنّ عجمي يصرّ حتى رمقه الأخير على الاستعانة بالاستشراق المبتذل ليرضي مخيّلة الرجل الغربي الأبيض (لا يكتب عجمي للنساء. لغته بالإنكليزية فائقة الذكوريّة وخاصّة بالرجال، وكل كلامه عن الرجال فقط). يحكي عجمي قصّة «دلال»، التي أشكِّك فيها وأميل إلى فكرة أن عجمي اختلقها لإبهار الرجل الغربي. الموسيقي اللبناني ربيع أبو خليل في ألمانيا لا يصنع موسيقى عربيّة في الغرب: هو يصنع موسيقى تتطابق مع الخيال الغربي التقليدي عمّا يجب أن تكون عليه الموسيقى العربيّة (هذا شبيه بشعبيّة موسيقى وأغاني «مشروع ليلى» بين المراسلين والأكاديميّين الغربيّين). وعجمي يصنع كتابات ليست عن العالم العربي بقدر ما هي عن عالم عربي متخيّل، أي أقرب إلى ما يريد الغربي أن يسمعه عن العالم العربي.
أنا لم أسمع في كل حياتي عن قصّة «جريمة شرف» في جنوب لبنان. لكنّ عجمي يفتتح كتاب سيرته الذاتيّة عن سنواته في لبنان بقصّة عن «جريمة شرف» (الجريمة جريمة، وصفة «الشرف» تهدف إلى التخفيف من الجرم، وكانت قوانين في الشرق والغرب تلحظ أسباباً تخفيفيّة في حالاتها). والجرائم ضد النساء في أميركا من أعلى نسب الجرائم ضد النساء في العالم، لكنّ «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» لا تكرّس صفحاتهما الأولى لقصة عن جريمة ضد المرأة إلا إذا جرت في باكستان أو الهند أو في بلد عربي. وينثر عجمي حول وفي المقالة الاستشهاد بالأمثال الشعبيّة التي ترسّخ النظرة الغربيّة إلى العربي: إن العربي محتال ونصّاب وكاذب ومنافق. هذا أسلوب المستشرق الإسرائيلي، رفائيل باتاي، في كتابه «العقل العربي»، والكتاب منبوذ في علم الاجتماع الغربي لكنّ الصحافي الأميركي، سيمور هرش، فضح الحكومة الأميركيّة في مقالة في «نيويوركر» في عام 2004، وقال إن القادة العسكريّين والمدنيّين اعتمدوا على الكتاب العنصري كدليل، أو «إنجيل المحافظين الجدد» بحسب وصف هرش. الكتاب يقول عن العرب إنهم يمتنعون عن القيام بأعمال يمكن «أن توسخ الأيدي» ويقول إن «الهوس الكلي بالجنس في العقل العربي يتجلّى» أو إن العربي عندما يُستثار «يصبح خارج السيطرة وعدائيّاً». هذا هو نفس نمط عجمي في الحديث عن العرب.
لا يمكن لأيّ عربي أو غربي أن يقحم في كتاباته إشارة إلى الشائعات، لكنّ ضوابط ومعايير علم الاجتماع والكتابة الغربيّيْن تتساهل مع الخبير المحلّي
يستشهد عجمي بأقوال شعبيّة مثل «الحيط بالحيط» ويقول إنه يعبّر عن الخوف من عالم قديم (ص. 8) أو «قَبِّل اليد التي لا تستطيع أن تواجهها» (والواضح أن معلومات عجمي من طفولته باتت مشوّهة فهو يغيّر من الأمثال ويعيد صياغتها من ذاكرته). وكان عالم الاجتماع السوري، حليم بركات، قد فنّد منهج باتاي وغيره من العنصريّين في كتابه عن «المجتمع العربي المعاصر»، عندما أوضح أن الثقافة العربيّة الشعبيّة غنيّة إلى درجة أنه لكلّ مثل عربي هناك مثل آخر يعارضه ويدحضه. هل «الأقارب عقارب» مثلاً، أم «أنا وأخي على ابن عمّي وأنا وابن عمّي على الغريب»؟ (والمثل الأخير هو لازمة في الكتابات الاستشراقيّة التنميطيّة عن العرب). ويتحدّث عجمي عن الخوف المستشري من المجهول، مع أن أهل لبنان، من جبله إلى جنوبه، سافروا واستكشفوا عوالم جديدة في أكثر من قارّة. والثقافة العربيّة تحمل مضمون «اطلبوا العلم ولو في الصين» (ويقول البيهقي عن الحديث النبوي هذا إن «متنه مشهور وأسانيده ضعيفة»).
وجعل عجمي من شخصيّة «دلال» نموذجاً أنثويّاً (من دون أن يدري على الأرجح) عن شخصيّة خليل الكافر لجبران خليل جبران في «الأرواح المتمرّدة». «دلال» ثائرة أكثر من ثوّار بوليفيا و«الرينغ» في بيروت. «دلال»، حسب وصف فؤاد عجمي، متمرّدة لكن من دون قضيّة واضحة. يقول عنها في التمهيد السردي لمقتلها على يد أمّها إنها لم تحبّ نساء عائلتها وقريتها، وإنها تذمّرت من «أوشامهم ومن تجاعيدهم ومن وجوههم بأسنانها المفقودة، ومن صلواتهم ومن وضوئهم التي تسبق الصلاة. وأكثر من ذلك كلّه، تذمّرت من الروائح التي التصقت بالعجائز من النساء. كانت تعتقد أنه كانت لديهنّ رائحة خاصّة» (ص. 9). لو أن كاتباً أسود كتب ذلك عن النساء السود، لكانت هناك اعتراضات ولكانت دور النشر، حتى تلك التي لم أسمع بها، قد تمنّعت عن النشر. لكن ما قصّة «دلال» وما أسباب شكواها؟ حسب خيال عجمي، هي كانت تعترض على الروائح الكريهة لنسوة الجنوب اللبناني في الوقت الذي كانت تعترض أيضاً على اغتسالهنّ للوضوء. ماذا كانت تريد «دلال» من نسوة الجنوب؟ حتى تجاعيد وجوه النسوة العجائز ضايقتها؟ وهل يريد منا أن نصدّق أن شكواها كانت سبب قتلها بالإضافة إلى تلميحات عن سلوكها من قبل مخيال عجمي الذكوري؟ لا، ويزعم عجمي أن «دلال» كانت تعترض عندما كانت النسوة يقتربن منها لتقبيلها. ثم ينسب عجمي قصّته عن «دلال» إلى قريبة لها، بعد أن يصف القريبة بأنها «غير مغتسلة». وعندما اقتُرح على «دلال» أن تتزوج بابن صديق لأمها سارعت إلى وصفه بالمغفّل. هذا ما يريدنا عجمي أن نصدّقه، لا بل هو لا يكترث لتصديقنا. كل ما يكترث له هو تصديق الرجل الأبيض لتعميماته وتنميطاته الاستشراقيّة، وأيضاً لنتاج خياله العنصري عن نسوة الجنوب، وعن العرب أجمعين. وفي الوقت الذي يخلص عجمي إلى تصوير خاتمة حياة «دلال» على أنها نتاج تزمّت مَقيت لأهل الجنوب، فإنه لا يتورّع عن القول إن نسوة الجنوب كنَّ يمارسن الجنس خارج زيجاتهن وبكلّ حريّة مطلقة، وكنّ يستعملن «دلال» (فقط، «دلال»، لماذا «دلال»؟) كحجّة للغياب عن المنزل. لكن، إذا كانت هناك هذه الحريّة الجنسيّة في الجنوب، فلماذا كان سلوك «دلال» فضائحيّاً إذاً؟ ويقول عجمي إن «دلال» كانت تضحك لوضع الأزواج المخدوعين. لكن لماذا كانت «دلال» هذه تقبل أن تتورّط في مساعدة تلك النسوة اللاتي كُنّ يُخفين كراهية شديدة نحوهم؟ يصف عمّ «دلال» فيقول عنه إنه كان يزهو بنسائه وإنه أغوى «ليلى» المثيرة جنسيّاً وإنه في ذلك انتصر على منافسيه. كان الجنوب اللبناني في خيال عجمي فيلماً بورنوغرافيّاً. لا، ويقول إن «أم حسن» ذات البشرة الفاتحة مارست «خياراتها» هي أيضاً. (يظن عجمي أن الكنية في الجنوب اللبناني للرجل باسم الابن البكر، لكن كنية الزوجة هي فقط، زوجة فلان، أي أنه لا يعلم أن كنية زوجة أبو حسن هي أم حسن وليس زوجة أبو حسن كما يرد في الكتاب). يقول إن رجليْن اثنيْن، أو ثلاثة (لاحظوا دقّة وصف عالم الاجتماع، فؤاد عجمي الذي نال وساماً في معرفة الشرق الأوسط من جورج دبليو بوش نفسه) كانوا من نصيبها. لا، ويضيف عالم الاجتماع هذا، «وكانت هناك شائعات» (هذا التوثيق العلمي الأكاديمي من مريد لبرنارد لويس) أن أم حسن (أو زوجة أبو حسن، وفق الخبير المحلّي، فؤاد عجمي) كانت تنفق على حريمها، من الرجال. يقول إن «دلال» كانت تعلم أن أبو حسن كان «ديكاً» و«ديوثاً» في نفس الوقت.
يقول إن نساء الجنوب شاهدنَ «دلال» وهي تغادر شققاً مفروشة في شارع الحمراء. يتحدّث عجمي عن لبنان في الأربعينيّات والخمسينيّات، أي قبل أن يصبح شارع الحمراء ما أصبح عليه في أواخر الستينيّات والسبعينيّات. ثم كيف استطاعت نسوة الجنوب القذرات وذوات الروائح النتنة، بحسب وصف الخبير المحلّي المفتتن بالغرب، أن يرين «دلال» وهي تدخل وتغادر شققاً مفروشة في شارع الحمراء (عندما كان الشارع أجردَ). هل استعنّ من منازلهن في الجنوب اللبناني بمنظار «هَبِل» يومها؟ يقول إن «دلال» رفضت ما اتُّهمت به من حياة جنسيّة حرّة. لكنّ الرواية لا تتسق. لماذا اعترض الجنوبيّون على المسلك الجنسي لـ«دلال» وكل أهل الجنوب، حسب وصفه، كانوا مشاركين في حفلة «أورجي» (أو جنس جماعي)؟ وتمّ تزويج «دلال» ستراً للفضيحة وطبعاً، كي يُضفي عجمي على الرواية رونقاً محليّاً شيعيّاً يبهر المستمع الغربي في مقاهي الحكواتيّة في واشنطن ونيويورك، فإن اسم الزوج السعيد هو «علي» (قد يكون عجمي قد احتار بين اسمَيْ علي وحسين قبل أن يستقرّ على اسم علي). وإذا لم يثبت لكم فؤاد عجمي أن الزوج هو شيعي بدليل أن اسمه هو «علي» (كان اسم خال أمّي، البيروتيّة السنيّة، هو علي، ووالد صائب سلام كان «أبو علي») فإنه يضيف دليلاً آخر على شيعيّة الزوج المذكور، إذ يقول: إن «علي» كان «يتحدّث باللكنة الشيعيّة للجنوب» (ص. 11). أي إن للجنوب اللبناني لكنات متعدّدة تتعدّد حسب الطائفة. هذه أوّل مرّة أسمع بلكنة لطائفة لا لجهة أو منطقة. ويضيف أن «علي» عجز أن يتحدّث الفرنسيّة مع لفظ الراء كغين، وأن هذا كان يُعتبر سقطة طبقيّة في المجتمع اللبناني (بالمناسبة، لم يكن كمال جنبلاط يلفظ الراء غيناً). (هذا التمييز في لفظ الفرنسيّة بين أهل لبنان يستقيه عجمي من مقطع لتولوستوي). وفي تدليل على عذاب «علي» وعجزه عن لفظ الراء غيناً بالفرنسيّة، يقول عجمي إنه لم يكن يعرف جاك شارييه أو بريجيت باردو. كيف يمكن تصديق ذلك؟ في الستينيّات من القرن الماضي، زارت بريجيت باردو مدينة صور وأبحرت مع زوجها في البحر وتعطّل الزورق قرب منزل جدّي في مدينة صور قرب المرفأ التاريخي. كان هناك شبه تظاهرة لمشاهدة بريجيت باردو في صور. ويذكر ذلك من كان في سنّي، أو من كان أكبر منّي سناً.
هذا التعميم عن اللغة العربيّة (من قبل وبعد كتاب «العقل العربي» لباتاي) مضحك لأن ليس هناك من سمة جامدة عن اللغة
وخيال عجمي في اختلاق قصة «دلال» يمزج التواريخ أو يتجاهل الاتساق التاريخي. تظن أن القصّة وقعت في زمن طفولة عجمي، أي في الأربعينيّات، لكن «علي» تخرّج في الجامعة اللبنانيّة التي لم تتأسّس قبل عام 1953، ويتحدّث عن رجال يفتحون أزرار قمصانهم ويضعون سلاسل ذهبيّة حول أعناقهم، وهي موضة لم تصل إلينا قبل السبعينيّات. لا، ويقول إن الرجال كانوا يدخّنون سجائر «جيتان» الفرنسيّة يومها. لكن لا همّ، القصّة مشوّقة للخيال الاستشراقي الغربي. طبعاً، كان لـ«علي» أب ظالم وكانت زوجة أبيه ظالمة. (هل شاهد عجمي قصّة «دلال» في فيلم مصري في سينما «روكسي» في طفولته؟) والمبالغة تصل في قصّة «دلال» إلى درجة أن عجمي، في ميله إلى المبالغة الفظيعة في كل الحديث عن العالم العربي وصفات أهله، لا يقول إن «دلال» كانت تمارس الجنس أو إنها كانت تحبّ بحريّة. لا، هذا لا يكفي. هو يقول، للمرّة الثانيّة، إنها كانت «تُشاهَد» وهي تدخل وتخرج من هذا المبنى أو ذاك. لم يكن لـ«دلال» من حياة غير الخروج والدخول إلى المباني. ويقول عجمي إن سبب الوفاة أدرجت انتحاراً. لكن هذا يصعب تصديقه. كيف يمكن لعائلة مسلمة أن تنجو من فضيحة «الشرف» عبر إدراج سبب الوفاة كانتحار، فيما الانتحار لا يزال يُعتبر حتى اليوم مشيناً ومعيباً عند المسلمين (حتى في المدافن هناك تمنّع لقبول جثّة منتحر). لهذه الدرجة يجهل عجمي عادات وقيم أهل الجنوب ولبنان. يتصوّر عجمي أن عائلة تزهو بأن ابنتها ماتت انتحاراً في ذلك الزمن (لا نستطيع التيقّن من الزمن لأن عجمي يوحي بأنها من الأربعينيّات إلى السبعينيّات وقد تكون في زمن غزو العراق).
طبعاً، لا يمكن لأيّ عربي أو غربي أن يقحم في كتاباته إشارة إلى الشائعات، لكنّ ضوابط ومعايير علم الاجتماع والكتابة الغربيّيْن تتساهل مع الخبير المحلّي الذي يُبهر بقصصه السامعين في الغرب، تماماً على طريقة حكواتي شهر رمضان في الأمسيات الرمضانيّة عندما كان يروي قصّة عنترة أو أبي زيد الهلالي. ويقول عجمي إن أم «دلال» جمعت أحذية «دلال» الأنيقة وطفقت تخاطبها، وإنها كانت تريد عودة «دلال» إلى الحياة مع أنها هي القاتلة. أنا وأنتم عشنا في لبنان وسمعنا الكثير من القصص الاجتماعيّة وقرأنا الكثير عن قصص، لكن مَن مِنّا سمع عن أم قتلت ابنتها لأن الناس في الجنوب شاهدوا (من الجنوب، على طريقة مشاهدة رامي عبد الرحمن لأحداث تجري في سوريا من منزله في بريطانيا) «دلال» وهي تدخل وتخرج من شقق في شارع الحمراء؟ ويدخل عامل الدين ويقول عجمي إن أم «دلال» زادت تديّناً بعد قتل الابنة. ويزعم عجمي أن أم «دلال» كانت ترافق أمه في زيارات لـ«السيّدة زينب» في دمشق للتكفير عن فعلتها. يقول عجمي إن أم «دلال» شاركت أمه في السرّ خلال واحدة من الرحلات إلى دمشق. لكن ألم تُطرح تساؤلات من الناس عن سرّ الانتحار؟ ألم يروا الرصاصة أو السكّين عندما انتشلوا جثّة الضحيّة؟ هنا نجد أن عجمي تناسى الحاجة إلى تفاصيل بوليسيّة في قصته. ويقول إن والد «دلال» أصبح خائفاً من تلقّي مصير ابنته، مع أنه لم يحاول الاقتصاص من قاتلة ابنته، ولم يطالب بتحقيق. ولا يروي عجمي، بالرغم من تفاصيل مملّة عن القصّة، أخباراً عن عمليّة القتل أو الوسائل. قد يؤدّي ذلك إلى مزيد من التشكيك من قبل القرّاء، على ألا يكونوا من الغربيّين المتعطّشين إلى المزيد من أخبار «جرائم الشرف» من العالم العربي، وخصوصاً عندما تكون القاتلة والدة الضحيّة. ثم يقول عجمي إنه كان يكتب رسائل أم «دلال» لأقاربها في أفريقيا. لا، يزعم أنه كان يكتب الرسائل من دون أن يقرأ لها ما كتب لأنها كانت تثق بما يكتبه (ص. 14). ولا يفوّت عجمي الفرصة من دون أن يخبر القارئ الغربي عن لغتنا العربيّة، فيقول عنها: «العربيّة، لغة التلميح والمعاني المستورة والأزقّة الدقيقة». وهذا التعميم عن اللغة العربيّة (من قبل وبعد كتاب «العقل العربي» لباتاي) مضحك لأن ليس هناك من سمة جامدة عن اللغة. تستطيع أن تكتب بعلميّة في اللغة العربيّة، كما فعل ابن سينا وابن رشد والبيروني والفارابي من القدماء. وتستطيع أيضاً أن تستعمل اللغة كما استعملها أحمد الشقيري وياسر عرفات للمبالغة والتبجّح والصراخ. العيب في استعمال اللغة ليس عيباً في اللغة، بقدر ما هو عيب في الاستعمال (ويندرج أدونيس هنا من ضمن الذين يعمّمون عن اللغة العربيّة ويخلطون بين استعمال اللغة، أو سوء استعمالها، وبين خواص اللغة نفسها).
(يتبع)
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
asadabukhalil@


