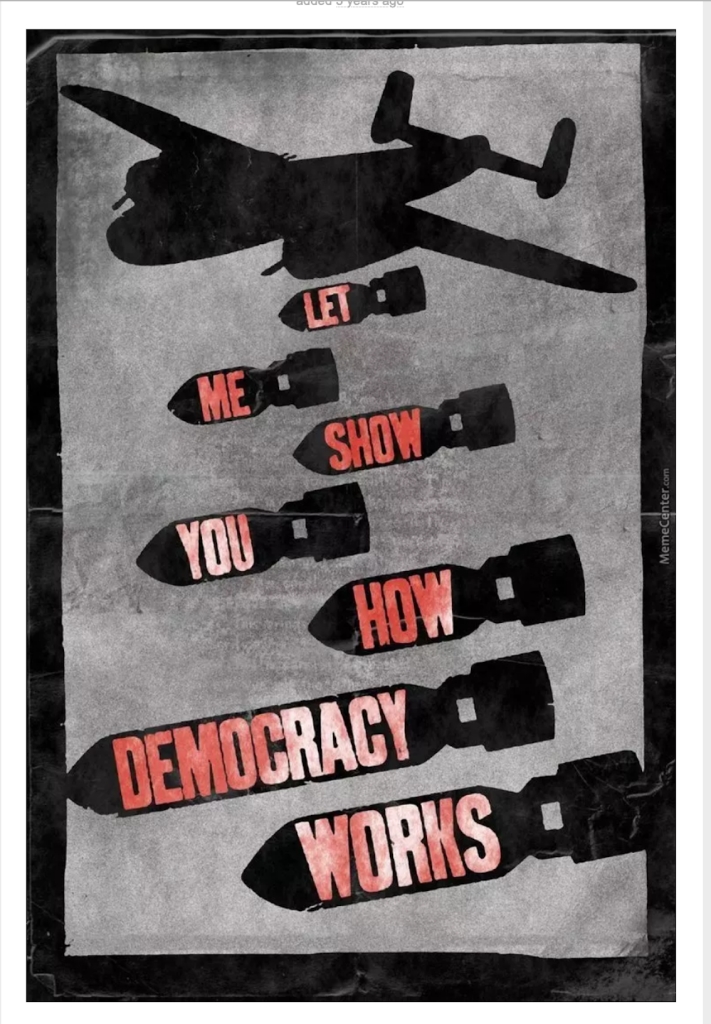
بعض القوى المؤلّفة لها أرادت أن تكون الحكومة منزوعة السلاح ومجرّدة من أدوات الإصلاح والتغيير الفعلي. استجابت الحكومة لقائمة من الشروط كالإفراج عن العميل عامر الفاخوري والسير في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعدم إقالة حاكم مصرف لبنان وآخرها التعيينات الإدارية التي كادت أن تفجّر الحكومة بصورة مهينة. ثم بدأت موجة الاعتراضات في الشارع على خليط من الشعارات الاجتماعية والسياسية، والمستجدّ فيها نزع سلاح المقاومة على خلفية تطورين إقليميين رئيسيين: الأول: مسارعة «الحكومة الإسرائيلية» لطرح مشروع ضم الضفة الغربية إلى أرض «إسرائيل». والثاني: اقتراب موعد تطبيق قانون «قيصر» لمزيد من الإحكام والضغط على سورية.
دلالات التوقيت
يأتي الإعلان عن التظاهرات في مختلف الأراضي اللبنانية بهذا التوقيت خدمةً لأهداف واضحة خارجية وداخلية. في الخارج ترتبط بالوضع الكارثي الذي تأزّم داخل الولايات المتحدة الأميركية بعد تفشي وباء كورونا، وفشل إدارة الرئيس ترامب في التعامل مع أزمة انهيار الاقتصاد من جانب، وغياب استراتيجية موحّدة لمواجهة الجائحة، معطوفة على أزمة الهوية التي برزت مع مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، ما أثار احتجاجات عارمة. ورأى بعض المراقبين أن تصاعد الغضب الشعبي، والصراع مع ممثلي السلطة، قد يؤدّيان إلى احتمال نشوب حرب أهلية جديدة. يأتي ذلك أيضاً في ظل توتر في العلاقة بين أميركا من جهة، وكل من الصين وروسيا وإيران وفنزويلا على خلفيات سياسية واقتصادية حادّة، في حين تبدو السياقات الدولية مفتوحة على المجهول. من جانب آخر تواجه إسرائيل أزمة بنيوية عميقة، فيما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعاني من اهتزازات مجتمعية وسياسية، وضغوط قوية على خلفية خياراته التي تكاد كل مرة تضع الكيان أمام مواجهات مع الفلسطينيين أو مع إيران وحلفائها، غير محسوبة النتائج.
بالنسبة إلى ترامب، فإنّ فتح مواجهة خارجية في المنطقة وتحديداً في لبنان، سيشتِّت في نظره الاهتمام الشعبي بمسؤوليته عن كل الإخفاقات الداخلية، ويضمن من خلال تأييد «إسرائيل» بضم الضفة الغربية، وقوف اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة. والأهم من ذلك بالنسبة إلى ترامب، في علاقته مع اللوبي اليهودي المتشدد، هو تمويل ودعم حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة. يرمي ترامب أيضاً من خلال تقديم هذه المكافأة الكبيرة لإسرائيل، إلى تعديل موقف أميركا وإعادة التوازن والهيبة إلى صورتها القوية التي تراجعت بسبب الضربات التي تلقّتها القوات الأميركية في العراق، بعد استشهاد اللواء قاسم سليماني. أمّا بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، فإن خطة الضم تحتاج إلى توتير دوائر المحيط الجغرافي وإنهاك حزب الله وسورية وإشغالهما بالأزمات الاجتماعية.
في الحقيقة، تمثل خطة الضم و«قانون قيصر»، في حال تطبيقهما، عدواناً يراد من خلالهما دفع المنطقة إلى اهتزاز كبير ينفجر في وجه إيران وحلفائها.
أما من الجهة المحلية، فإنّ الحديث عن سريان «قانون قيصر» بدأ يثير نوعاً من الجدل والتوتر العالي بين القوى المحلية، ويستنفر أدوات أميركا والسعودية والإمارات وتركيا في محاولة لدفع حزب الله إما إلى تليين تصلّبه حتى يقبل بتسوية جديدة، أو دفعه للانكفاء وإرغامه بانتخابات مبكرة وحكومة بديلة برئاسة شخص موالٍ للولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الضغط عليه للقبول بتوسيع دور اليونيفيل جنوباً وشرقاً وشمالاً. في وقت يعي حزب الله تماماً أنّ التطورات المحلية والإقليمية ستعرِّض استقرار لبنان وأمنه لمرحلة عاصفة من الاضطرابات. وحالة الجدل السياسي في الميدان، يتم تعزيزها بالضغوط المالية والتلاعب بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وقد شهدت الساحات والمناطق المختلفة خلال الأيام الماضية هجوماً واضحاً على سلاح المقاومة ومطالبات بنزعه وقطعاً للطرقات من أجل رفع الكلفة عليه وتحميله مسؤولية التدهور الذي وصل إليه البلد، وتعقيد حساباته مع حلفائه ما يضطر بعضهم إلى إعادة تقييم علاقته مع الحزب، وربما البحث عن بدائل أقل كلفة ومخاطرة.
هناك شبه استحالة للوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والنقدي والاجتماعي في ظل الحكومة الحالية
ما ينبغي الالتفات إليه في ضوء هذا المشهد:
أولاً: لجوء بعض القوى المعادية للمقاومة إلى الاستثمار أكثر في تدويل الصراع الداخلي، لإسقاط حكومة حسان دياب، وإيجاد نوع من التوازن الذي خسرته بعد انتخاب العماد عون عام 2016، أو بعد الانتخابات النيابية عام 2018. القوى هذه تسعى ليكون لليونيفيل دور أوسع سواء في تطبيق القرار 1559 أو توسيع مهمّاتها في إطار القرار 1701 لتقييد دور المقاومة وحركتها.
ثانياً: تعتبر بعض القوى المحلية أنّ «قانون قيصر»، وضم الضفة الغربية، سيأتيان بتداعيات استراتيجية وأمنية لن تكون في صالح حزب الله، وأنها (أي هذه القوى) أمام فرصة جديدة تشبه مرحلة اغتيال الرئيس الحريري لتصدّر المشهد من جديد.
ثالثاً: إنّ هذه القوى تراهن على رجحان انهيار الدولة ما يفرض تحضرها لمرحلة مختلفة لجهة التوازنات محلياً وإقليمياً.
وعلى هذا يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: لا يوجد ما يشير، بشكل مباشر، إلى قدرة القوى المعارضة للحكومة على إسقاطها في الوقت الراهن. ولا يبدو أنّ بعض شركاء المقاومة، كتيار «المردة» وحركة «أمل»، الممتعضين من بعض تصرفات الرئيس حسان دياب، ذاهب باتجاه هذا الخيار.
ثانياً: ليس من الصعب رؤية التباين بين شركاء الحكومة. وردود الفعل المتعلقة بالتعيينات الإدارية، والأخرى الخاصة بالمفاوضات مع صندوق النقد، وغيرها من الملفات تمسّ وحدتها وتقدم فرصة للشارع لمواصلة ضغوطه. وبالنظر إلى تواضع الخطوات الإصلاحية، فإنّ حجم التأييد الشعبي سيتناقص وخصوصاً أنّ القوى التقليدية التي عمدت إلى تحركات مشبوهة خلال الأزمة الأخيرة وقبلها، من غير المتوقع أن تُظهر نوايا جادة لمساعدة الحكومة على تجاوز هذه الأزمة الوطنية.
ثالثاً: هناك شبه استحالة للوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والنقدي والاجتماعي في ظل الحكومة الحالية. الخارج سيواصل ضغوطه الاقتصادية وقوى الداخل ستلجأ إلى تجريد الرئيس دياب وحكومته من أدوات الإصلاح الفعلية لحسابات ترتبط بمصالح شخصية وطائفية وغيرها.
رابعاً: الإدارة الأميركية ستتشدّد غالباً في تنفيذ العقوبات على سورية من بوابة «قانون قيصر». وهذا الأمر سيشكّل تكبيلاً وضرباً للاقتصاد اللبناني في ظل عجز واضح لدى الحكومة اللبنانية، سواء لجهة الالتفاف عليها أو الذهاب إلى خيار «التوجّه شرقاً».
خامساً: من الصعب حالياً معرفة كامل تداعيات «قانون قيصر» على لبنان. لكن من غير المستبعد أن يشكل ذلك مدخلاً لانهيار الاقتصاد والمجتمع، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول أميركي سابقاً، إذ يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أنّ هذه الإجراءات القاسية ستدفع حزب الله إلى التراجع والانكفاء.
سادساً: لم تكن دلالات ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة خافية على أحد. إذ لا يوجد شك في تعبيره عن رغبة أميركية بخلق فوضى مذهبية وطائفية لتحميل حزب الله وسلاح المقاومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية. وفي المقابل هناك أدوار بارزة لتركيا التي تريد تأسيس حضور لها على حساب انكفاء اللاعب السعودي. بدا واضحاً، أن ما جرى ليلة السبت 6/ 6/ 2020 وما تلاها، كاد أن يضع البلد في مواجهة عسكرية مباشرة بين شباب من أحياء مختلفة، أو انزلاق البلد إلى فتنة قد تأمّن لها العديد البشري المطلوب. وهذا ما ورد في تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية وأكّدته وسائل إعلام خارجية.
سابعاً: يرى حزب الله أنّ استمرار حكومة الرئيس حسان دياب وحمايتها مصلحة وطنية عليا. وأنّ وقوفه إلى جانبها، بغضّ النظر عن تباينات أعضائها أو الاختلاف معهم في بعض الملفات، هو تثبيت لموازين القوى وتعزيز لمسار الإصلاح في هياكل الدولة، وانحياز إلى طموحات الشعب اللبناني في النهوض بالبلد نحو الأحسن.
رهانات مفتوحة
أولاً: تعتقد الإدارة الأميركية وحلفاؤها أنّ ما حصل في لبنان وما يمكن أن يحصل خلال الأيام والأسابيع القادمة بإمكانهما تغيير قواعد التدافع وموازين القوى الداخلية. ثمة اعتقاد في واشنطن وتل أبيب والرياض تحديداً، بأن الفوضى أصبحت بالفعل جزءاً من المعادلة اللبنانية، وأن خيارات حزب الله محدودة في مواجهة العقوبات والحفاظ على تماسك الحكومة وحتى تموضعات حلفائه الجديدة. وأن الحزب لم يعد قادراً على توفير الحماية لبيئته، وأكبر دليل على ذلك نزول «مناصريه» إلى ساحات التظاهر منددين بالأوضاع المعيشية.
ثانياً: إن الإدارة الأميركية تحتاج إلى ما هو أكثر من النجاح في الفوضى. أي إلى دفع الحكومة الحالية نحو تسوية فعلية، في ما يتعلق بشروط صندوق النقد الدولي. ودفع حلفائها إلى تغيير ميزان القوى بصورة ملموسة، والضغط على حزب الله بصورة متصاعدة باعتباره يشكل مصدر التهديد الرئيس لأمن إسرائيل واستقرار وجودها. وكذلك يريد من حلفائه الضغط لمواجهة تعاظم الدعم الذي تقدمه إيران له لتحقيق مناخ إقليمي معاكس يضمن تخليه عن سياساته في كل من سورية وفلسطين على وجه الخصوص.
ثالثاً: تعتبر الإدارة الأميركية وحلفاؤها أنّ المزيد من تورط حزب الله ضد الجماهير الغاضبة على خلفية المطالب الاجتماعية ودعمه للحكومة الحالية سينجح في إقناع عموم اللبنانيين بمسؤولية الحزب عن تدهور الأوضاع. وهذا الأمر سيدمّر سمعته وسيقوّض حجته ويدحض روايته بأنه حامي الاستقرار الداخلي. فالمطلوب هو خلق ذلك المناخ العام بعدم قدرة اللبنانيين على تحمل تكلفة الخيارات الباهظة التي يعتمدها الحزب داخلياً وخارجياً.
المُقدّر خلال الأشهر المقبلة هو التالي:
1) الأزمات في المنطقة ولبنان أبعد ما تكون عن النهايات القريبة، بل دخلت مرحلة جديدة من التأزيم والتصعيد الخطيرين.
2) الفتنة السنية ـــ الشيعية لا تزال تحظى بجاذبية ورعاية إقليمياً ودولياً.
3) محاولة السلطة الحالية تجاوز المرحلة الحالية من الضغوط بأقل الخسائر. والتركيز على إعادة ترميم الدولة وتقديم الحلول للأزمة بجرعة من الإصلاحات ولو كانت الظروف الخارجية تسير في اتجاه آخر!
4) نحن أمام موجة جديدة من الكراهيات والاصطفافات والاختبارات الأمنية المقبلة.
5) إسرائيل ستُمنح الأولوية لضم الضفة الغربية مع بقاء احتمالات التصعيد على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية قائماً بقوة.
أما في ما يتعلق بحزب الله، فقد خرج الأمين العام في خطابه الأخير بمجموعة من المواقف التي ستضعنا أمام التصورات التالية:
أولاً: إنّ حزب الله سيدفع بقوة لتكريس معادلة ردع اقتصادية تستند إلى دعم كل من الصين وإيران. وهذا يعني أنّ حزب الله لن يقف موقف المتفرج على الانهيار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها واشنطن على لبنان، بل سيفتح عهداً جديداً من الندية والمواجهة والتحدي في مواجهة الغطرسة الأميركية.
ثانياً: إنّ حزب الله لن يقبل أن تُقفل الأبواب مع دمشق. ولن يسمح للحكومة اللبنانية أن تتعهد لواشنطن الالتزام بقانون قيصر. والتأكيد أنّ أي عدوان جديد على سوريا من المدخل الاقتصادي لن يمر.
ثالثاً: إنّ الأمين العام لحزب الله ترك باب التكهنات مفتوحاً في ما يتعلق بالخيار العسكري في وجه إسرائيل. وهذا يؤشر إلى احتمالات تصعيد وحرب قادمة فيما لو واصلت واشنطن مسارات التجويع ضد الشعبين اللبناني والسوري. إنّ من شأن هذا الطرح أن يدفع واشنطن إلى إعادة حساباتها والتخفيف من إجراءاتها مع ما لذلك من نتائج وخيمة على صورتها ومكانتها الدولية، أو أنّه سيدفعها إلى التهور أكثر في المواجهة التي يتحسّب لها حزب الله وحلفاؤه في المنطقة ويعتقد أنّها ستكون فرصة لمراكمة انتصار تاريخي جديد.
رابعاً: إنّ الأمين العام لحزب الله يدفع باتجاه تحصين الحكومة وإعطائها جرعة ثقة تُمكّنها من الذهاب إلى خيارات جريئة على مستوى البدائل الاقتصادية أو على مستوى المتربّصين والفاسدين في الداخل. وهو يريد من الحكومة أن تشنّ حرباً استباقية تحميها من لعبة السقوط في الشارع بفعل التباطؤ في اتخاذ الإجراءات التي تكفل أمن الناس وغذاءهم واستقرار عملتهم المحلية.
خامساً: إنّ حزب الله سيلجأ إلى كل وسيلة تحمي الاستقرار الداخلي وتمنع جرّه إلى فتنة مذهبية أو طائفية. وأنّ الإمعان في لعبة التخريب والفوضى بات مكشوفاً ولن يسمح بأن يأخذ هذ الإمعان مداه. وهذا معناه أنّ يد العابثين بالأمن ليست مبسوطة وأنّه يملك ما يكفي من الشجاعة والتصميم لقطعها.
في المحصّلة، لبنان منجذب إلى كل ما هو جديد وتاريخي. المنطقة تتحضر لزلزال قادم وتحولات على أكثر من صعيد. وإذا كان في لبنان والمنطقة مخلوقات بشرية فاقدة للحس والمسؤولية والشرف، ولا تزال تراهن على تأبيد عجزها وتبعيتها لقوى الهيمنة العالمية، فإنّ خطاب السيد حسن نصر الله الأخير أشبه ما يكون بوضع رواية تاريخية مختلفة عن لبنان والمنطقة. جاء «كزهر اللوز أو أبعد». خطاب ما بعد الواقع. خطاب ما بعد «حرّاء وثور». إلى «نخيل المدينة». إنهّ خطاب التاريخ. إنّه كلمة الله!
* كاتب لبناني، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدولية


