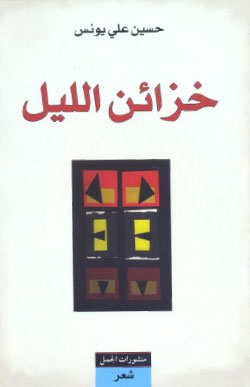إذا كانت هناك ثمة ضحية في العراق في زمن الدكتاتور صدام حسين، فهي الحياة الثقافية والمثقفون الذين يصنعون هذه الحياة. لم ينجُ أحد من ذلك الغبار الذي غطى الجميع وحوّل الناس إلى آلات صماء لا تنتج غير الضجيج. في المقابل، لجأ البعض إلى الصمت وآخرون إلى الصعلكة أو العمل كسائقي أجرة أو حتى بائعي سجائر في «مقهى حسن عجمي» قتلاً للقرف. الشعراء الذين تحولوا إلى صعاليك في ذلك الزمن ولم يغادروا العراق، ماتوا جميعاً. منهم من مات في المقهى، ومنهم من مات على الرصيف أو في فندق متهالك.
لكنْ هناك صعلوك لم يمت وصدرت له أخيراً مجموعة شعرية عن «دار الجمل» بعنوان «خزائن الليل». ولهذه المجموعة قصة يتندر بها الشعراء العراقيون من جيل هذا الشاعر حسين علي يونس أو حسين الصعلوك. القصة تدّعي أنّ يونس هذا رافق الشاعر الصعلوك عقيل علي. وعندما مات هذا الأخير على أحد أرصفة بغداد، حاز حسين علي يونس نصوصه عقيل الشعرية، ونشرها بعدما نسبها إليه. لن ننجر إلى تصديق هذه القصة أو تكذيبها، طالما أنّ المجموعة بين أيدينا الآن، وخصوصاً ونحن نزعم معرفة كبيرة بعملي عقيل علي وحسين علي يونس. إذاً، نحن ننحاز الى القراءة والتحليل والمقارنة وتقديم الأدلة النقدية... ولا يهمنا النتيجة بقدر ما يهمنا العمل الشعري الذي نتناوله.
تتألف المجموعة من تسعين نصاً شعرياً بواقع 176 صفحة معظمها قصيرة إن لم نقل قصيرة للغاية، باستثناء ثلاثة نصوص طويلة بعض الشيء، لكن المفارقة تصدمنا في نص واحد طويل أو هو الأطول في المجموعة، يختلف كلياً عن أجواء الكتاب الى درجة تثير الريبة ببنائه ولغته وتقنيات كتابته ومضمونه. سوف نقارن هذا النص ببقية نصوص المجموعة ونبين أوجه هذا الاختلاف لنظهر لماذا يختلف هذا النص الوحيد عن 89 نصاً هي ما يؤلّف المجموعة الشعرية كلها.
اسم النص هو «مرثية سيف علي» يبلغ طوله خمس صفحات بينما بقية النصوص تتألف من سطرين أو نصف صفحة أو صفحتين على أكثر تقدير. وسوف نختار من هذا النص مقاطع لنحللها ونقارنها بمقاطع أخرى من المجموعة لنبين لماذا يكون هذا النص مختلفاً كلياً عن بقية النصوص رغم عددها الكبير. «ستمر على نهر الفرات محشوراً بين خشبتين/ كما بين دفتي كتاب/ وقد فاتك أن تنظر إلى سريانه الخالد/ إلى الأشنات/ والى المنخفضات المتآكلة على جرفه المتسع./ كثيرون سيسمعون تنفسك/ وسيترنحون عبر البلاد التي انطفأت فيها القناديل/ كثيرون/ سيمددون أرجلهم داخل القبر مثلك/ سيمكثون في الأرض مثلك/ وستشحذ الإشارات صرخاتهم/ ليستمر دوي هذه الحكاية القديمة». سنختار مقطعاً آخر من نص طويل مختلف كي نقارن بين تقنيات الكتابة في النصين ونظهر وجوه الاختلاف.
النص الثاني بعنوان «لقد عدت أخيراً من الموت» حيث يقول حسين علي يونس «لقد عدت أخيراً من الموت: كانت رحلة غريبة استمرت مائة وخمسون عاماً، تغير عبرها مجرى الزمن. كنت في نظر القسم الأعظم من الذين التقيتهم كائناً غريباً وساذجاً. لم أكن ذلك الرجل العظيم المدوي، الذي كنته قبل أن أشد الرحال باتجاه الحياة الأخرى منذ قرن ونصف».
لنبدأ بالمقطع الأول الذي يصوّر بمشهدية عالية رحلة الرجل الميت الذي يتحول التابوت فيه الى كتاب من دون أن يغفل الإشارة إلى مصدر الحياة (الماء) في نهر الفرات وسريانه الخالد في البلاد التي انطفأت فيها القناديل، في إشارة الى موت البلاد. لننظر أيضاً الى توزيع الأبيات والموسيقى الداخلية ومتانة الصورة الشعرية والفخامة اللغوية وعمق المعنى في الميت الذي يسمع تنفسه الآخرون الذين سيمدون أرجلهم في القبر نفسه، مقارنةً بالرجل في المقطع الثاني العائد من الموت بعدما قضى 150 عاماً في الحياة الأخرى.
المقطع الثاني من النص الثاني فيه سذاجة وأخطاء لغوية ونحوية «استمرت مائة وخمسون عاماً»، وفيه نثرية أقرب إلى السردية وهو قص أكثر من كونه شعراً ولا ينطوي على المقومات الشعرية الموجودة في المقطع الأول. ولولا ضيق المساحة، لأوردنا مقاطع أخرى من النص الأصيل وأخرى من النص الدخيل لكي نؤشر إلى الفوارق الكبيرة بين هذا النص والنصوص الأخرى، لكننا نعتقد أن هذا المثال ـــــ رغم قصره ـــــ قد أوضح حجم الاختلاف الكبير في الصور وتقنيات الكتابة واللغة ومضمون القصيدة.
آهات عقيل علي في «خزائن» الصعلوك