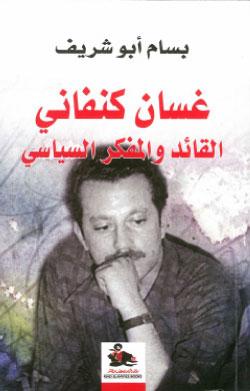ولد غسان كنفاني في عكا في فلسطين عام 1936 ومات في عام 1972 بعبوة انفجرت في سيارته قرب منزله في منطقة «مار تقلا» في بيروت، وكان له من العمر 36 سنة. أما المؤلف، فقد تعرض للموت بعد أسبوعين من رحيل كنفاني، عندما وصل إلى مكاتب مجلة «الهدف» في بيروت طرد باسم بسام أبو شريف، في داخله كتاب. ما أن فتحه «المرسل إليه»، حتى انفجرت في وجهه عبوة أصابته بحروق بليغة، وأفقدته شيئاً من سمعه ومن بصره، وتركت في الوجه واليدين عاهات لا تزال بادية على الرجل حتى اليوم.
نشأ غسان كنفاني، والصراع في فلسطين وعليها على أشده بين العرب واليهود. توفيت والدته وهو طفل صغير، فربته أخته الكبيرة فايزة. انتسب إلى معهد «الفرير» وكانت الفرنسية لغته الأولى في الكتابة. في عام 1948، وعلى أثر اشتداد المعارك، تغادر العائلة إلى لبنان، وبعد أربعين يوماً إلى حلب، ومن ثم إلى دمشق حيث استقرت، وحيث تابع الصبي دروسه الابتدائية، ثم دروسه الثانوية التي أظهر فيها تفوقاً في الأدب العربي والرسم.
لم تغب السنوات الإحدى عشرة التي قضاها كنفاني في فلسطين عن باله. ظل مشدوداً إلى مسقط رأسه بأمراس خفية من الوجد والعشق والحنين، ما حمله وهو صبي يافع على دخول معترك السياسة والانخراط في حركة القوميين العرب، جاعلاً فلسطينه، الموضوع الأساس في قصصه ورواياته، بكل ما فيها من حوادث وذكريات وشخوص.
عام 1955، يسافر الفتى غسان إلى الكويت للتدريس والكتابة في الصحف، وهناك يصدر أولى بواكيره الأدبية «القميص المسروق». في عام 1960، يحضر إلى بيروت للعمل في مجلة «الحرية» ويبدأ الكتابة في جريدة «المحرر» الأسبوعية البيروتية. في 1961، يسافر إلى يوغوسلافيا ليؤكد المشاركة الفلسطينية في مؤتمر طلابي، وهناك يتعرف إلى «آني»، معلمة أطفال دانمركية. تبدي الصبية اهتماماً بقضية الشاب الفلسطيني، ثم تسافر إلى بعض العواصم العربية ومنها بيروت، تلتقي غسان كنفاني مجدداً وتستشيره بأمور تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكان يومها أحد المراجع المهمة في الموضوع. يشرح لها غسان قضية شعبه. يصطحبها إلى المخيمات، فتتأثر بما تشاهد، وترى الصورة مغايرة، لما كانت تبثه الدعاية الصهيونية في بلادها. ينمو حب بين الاثنين. وبعد عشرة أيام من وجودها في بيروت، يطلب غسان يدها للزواج. تكتب إلى أهلها في الدانمرك. يتزوجان في 1961 ويمر عام ويولد فايز، وبعده بخمس سنوات، تولد ليلى.
لم تصرف السياسة والصحافة المناضل «العتيد» عن الأدب، فتظهر روايته «عائد إلى حيفا»، وبعدها «أرض البرتقال الحزين» ثم «رجال في الشمس» وأخيراً «ما تبقى لكم» و»أم سعد»... روايات تستوحي فلسطين وصراع شعبها لاستعادة الأمل المفقود. الذين عرفوا غسان كنفاني، يقولون إنه كان مثقفاً نهماً. يقرأ كل ساعة ويكتب كل ساعة، «كانت عينه ثاقبة وحسه مرهف» كما يقول بسام أبو شريف. كتب المقالات والقصص والفصول وبعضها جمع في كتابه «الرجال والبنادق». في الكويت، كان يوقع مقالاته باسم مستعار، «ابو العز»، وكان من الأوئل الذين صوروا الحياة في الخليج بقصة «موت سرير رقم 12».
يورد المؤلف أنّ المخابرات
الإسرائيلية والأردنية
اغتالت كنفاني
كان كنفاني أول من عرّف بشيء اسمه «شعر المقاومة» و»شعراء المقاومة». أصبحت كتاباته عنهم كما يقول أبو شريف «مرجعاً يقرر في الجامعات ومرجعاً للدارسين». يكتب محمود درويش عن الفترة السابقة لما كان يعرف بشعر المقاومة وشعراء المقاومة في الأرض المحتلة مقالة عنوانها «غزال يبشر ببركان»، فيقول: «الآن نقول: أدب الأرض المحتلة ونسكت! لكن الحالة كانت تختلف عامئذ. كنا مجموعة شباب دون الثلاثين، نفتقر إلى أدنى مقومات الرد العملي على الهزائم التي يعاصرها وعينا وعارنا. كنا نحاول كتابة الشعر، من دون أن نعي أنه شعر. أغلبية المواطنين كانت تسخر منا بالقول إننا مراهقون، وكان بعض المعلمين يقولون: مبتدئون لهم مستقبل. كان الشعر المقبول لدى الناس، هو الشعر المقبول خارج الأرض المحتلة، وكانت النجوم الشعرية الرائجة في العالم العربي ذاتها الرائجة لدى صحف العدو، باستثناءات قليلة. وبقينا مجهولين إلى أن قام غسان كنفاني بعمليته الفدائية الشهيرة: إعلان وجود شعر في الأرض المحتلة. انقلبت العلاقة داخل الأرض المحتلة، ومشى التطرف إلى نقيضه المتطرف: لا شعر إلا في الأرض المحتلة»!.
يضيف محمود درويش في مقالته تلك، فيقول: «غسان كنفاني نقل الحبر إلى مرتبة الشرف، أعطاه قيمة الدم. يقتحمنا دائماً بقوة كلماته التي لا تموت. كم كتب الفلسطينيون وماتوا، لكن حبرهم كان يجف مع دمهم. كتابته هي النادرة التي تصلح للقراءة بعد العودة من جنازة كاتبها، وتاريخ تبلور النثر الفلسطيني لم يبدأ إلا مع غسان كنفاني».
عام 1962، يبدأ الشاب المناضل العمل في مجلة «الحرية» التي كانت تصدرها حركة القوميين العرب. كان في الخامسة والعشرين. في 1965، يتسلم رئاسة تحرير صحيفة «المحرر»، صحيفة الناصريين والقوميين العرب، ويصدر عنها ملحق «فلسطين». في 1967، وبعد هزيمة حزيران، يطلب الناشر والصحافي المخضرم سعيد فريحة إلى غسان كنفاني العمل في جريدة «الأنوار»، فيظهر «ملحق الأنوار» الأسبوعي وينتشر بين الآلاف من القراء . في 1969، يؤسس غسان كنفاني مجلة «الهدف» الأسبوعية، لسان حال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويبقى فيها يكتب ويناضل حتى اليوم الأخير من حياته. عن تلك المرحلة، يكتب أبو شريف: «تلازمنا كتوأمين، وعملنا معاً وسهرنا معاً. جبنا طرقات بيروت وتناولنا الطعام في مطاعمها معاً وجلسنا معاً في مقاهيها الشهيرة، ولم نفترق إلا عندما فرقنا استشهاده». في الكتاب «مقابلة» مع غسان كنفاني جرت عام 1969، وكان يومها رئيساً لتحرير جريدة «الهدف». في المقابلة، يتحدث عن نفسه قائلاً: «غادرت فلسطين وأنا في الحادية عشرة. كان والدي محامياً. أرسلني إلى مدرسة فرنسية تبشيرية. لم أكن متمكناً من العربية، مما سبب لي كثيراً من المتاعب. وطالما هزأ بي أصدقائي لأنني لم أكن أجيد العربية. لكن عندما هجرنا من فلسطين، أصبح أصدقائي من طبقة مختلفة، ولاحظوا فوراً أن لغتي العربية ركيكة وألجأ إلى التعابير الأجنبية في أحاديثي. انصب اهتمامي على اللغة العربية لأعالج مشكلتي هذه. كان ذلك في 1954. أذكر أنني كسرت ساقي ذلك العام، فلزمت الفراش ستة أشهر، وشرعت في المطالعة بالعربية جدياً».
في «المقابلة»، يذكر الراحل شيئاً عن بداية حياته السياسية وهو في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. يقول: «قابلت الدكتور جورج حبش لأول مرة. كنت أعمل يومها مصححاً في مطبعة. لا أذكر من عرّفني إلى الدكتور، لكني انخرطت على الفور في حركة القوميين العرب. هكذا ابتدأت حياتي السياسية. في 1960، طُلب مني الانتقال إلى لبنان للعمل في صحيفة «الحركة». وفي 1967، بدأت العمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فرع فلسطيني لحركة القوميين العرب. وفي 1969، باشرت عملي في صحيفة «الهدف»».
في فصل مؤثر، يحكي غسان كنفاني عن تجربته في التدريس. يقول: «عندما باشرت التدريس، واجهت مصاعب جمة مع الأطفال الذين درّستهم في المخيم. كنت أغضب دائماً لدى مشاهدتي طفلاً نائماً أثناء الصف، وببساطة اكتشف السبب. كان هؤلاء الأولاد يعملون في الليل، يبيعون الحلوى أو العلكة أو ما شابه في دور السينما وعلى الطرقات. كانوا يأتون إلى الصف وهم في غاية التعب. تبيّن لي أن نوم الطفل ليس ناجماً عن استخفافه بي أو عن كرهه بالعلم، ولم يكن للأمر علاقة بكرامتي كمعلم، بل مجرد انعكاس لمشكلة سياسية».
يصف بسام أبو شريف السنوات التي قضاها برفقة غسان كنفاني بأنها الأجمل في حياته: «تعلمت منه الكثير، وكنت معجباً به، واعتبره نموذجاً للتطور والتنور. إقباله على الحياة بشغف وتفاؤل كان يبث في من حوله شعوراً عميقاً بالأمان. كان مكتبه في مجلة «الهدف» قبلة للأجانب القاصدين الشرق، بحثاً عن الحقيقة والمعرفة، وللثوريين الداعين للحرية وحق تقرير المصير للشعوب من كل أنحاء العالم. أحب غسان كنفاني شجرة الصبار لشوكها وزهرها، تتحدى الجفاف وتصارع من أجل البقاء.
كان يجد فيها حركة الحياة الناجمة عن التحدي والصراع والتناقض».
بعد أسبوعين على رحيل
صاحب «رجال في الشمس»، نجا
أبو شريف من طرد مفخخ!
عن مصرع غسان كنفاني صبيحة الثامن من تموز (يوليو) 1972، يكتب أبو شريف «ذلك اليوم دخلت إلى مكتب «الهدف» لأصعق بنبأ اغتيال غسان وتناثر جسده إرباً. انزلقت إلى شق جليدي لا قعر له. تجمدت. أطرافه المتناثرة جمعت ووضعت في نعش. لمحت حذاءه الجلدي الموشح بالورود. سارت جنازة احتشد فيها الألوف من البشر. لم يسيروا بدعوة من أحد. لا يعرفهم التنظيم، ولا يعرفهم أهل الفقيد. كانوا يعرفون من هو الشهيد».
يخبرنا بسام أبو شريف الذي عمل مع الدكتور جورج حبش في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولازم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في ما بعد، وكان أحد مستشاريه، بأن المخابرات الإسرائيلية والأردنية، اغتالت غسان كنفاني. وفي فصل آخر، يقول إن غولدا مئير، رئيسة وزراء إسرائيل في حينه، هي من أمر باغتياله. أما محمود درويش، فقد اكتفى في مقالته المذكورة بالقول إن «الأعداء» اغتالوه، من دون أن يقول لنا من هم هؤلاء «الأعداء».
قد يجد قارئ كتاب «غسان كنفاني- القائد والمفكر السياسي» جنوحاً في العاطفة وتكراراً لمقاطع، وسرداً كان يمكن اختصاره بعدد أقل من الفصول. لكن طراوة أسلوب المؤلف تجعلنا نغض النظر عن هذه الهنات. أما الجنوح في العاطفة، والميل إلى الاستعارات الوردية، فلهما ما يبررهما، إذا أدركنا حجم الصلة الحميمة التي كانت بين المؤلف والمناضل المغدور. هذه الصلة طبعت السرد بعنصر غالب، يشفع للمؤلف أي عيب قد يجده قارئ أو ناقد. إنه نوع من الوفاء النادر أظهره المؤلف لصديقه الراحل، ويجعلنا نقول من دون تردد، إن بسام أبو شريف كان كاتباً صادقاً، وكتابه يستحق منا كل ثناء وتقدير.