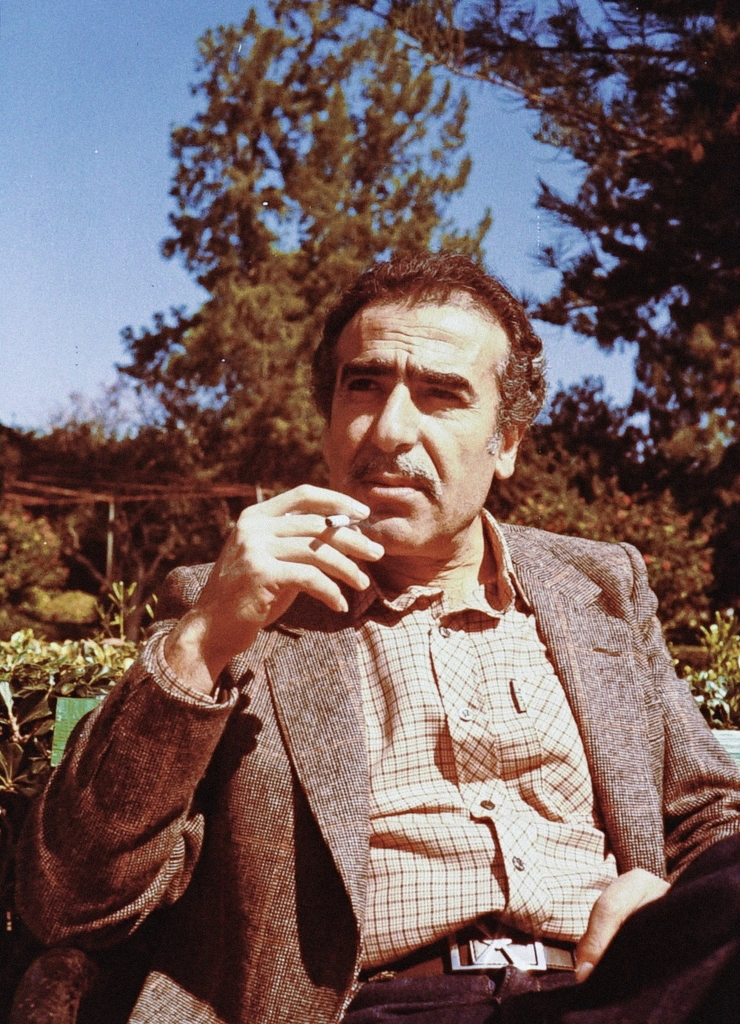
يوميات الجزائر (1973- 1974)
بغتة هذه هي الجزائر. أرض العذاب الطويل ومثوى الشهداء. وطن الغابات والبحر والعنف. منذ زمن وهي الوطن الآخر للغرباء في العالم.
هنا ولد كامو، لكنه ظل غريباً مشدوداً إلى ما وراء البحر، إلى اللغة والثقافة التي كونته وخلقت منه أسطورة في الفن. وهنا استوطن فرانز فانون مشعّاً بكل توهجه الأفريقي والعالمي نحو حرب التحرير، أسطورة أفريقيا في القرن العشرين.
لكن فانون وكامو ظلّا غريبين هنا رغم التحامهما بالطبيعة والإنسان. وفيما بعد، ستدرك أكثر لماذا يتفتت الإنسان توقاً للضوء لكنه يسقط ولا يراه إلا كحلم مشوّش.
بعد الأيام القليلة الأولى من محو العلامات القديمة، ومن هبوطك الغريب، ترن أجراس الحنين. لعلّ التذكر المتسلسل للروائح القديمة يبدو كأنه دفاع رادع ضد الاغتراب، ضد الموت. شيء ما جديد يتفتح تحت قشرة الأرض لكن النفس ترفض.
كيف تزيح بقايا الجذور المتشبثة بالتربة، وكيف تبهَت الشموس والأقمار التي بَهتت وما عادت قادرة على الإضاءة، لتتعود على بذور جديدة وشموس جديدة هي ذي تنساب فيك لتضيئك وتزدهر في أعماقك؟
زمن يولّي وزمن آخر يأتي. هذا ما يبدو على السطح.
أيار 1976
وأنا أغادر بيروت للمرة الأخيرة شعرت كأنني أخونها. أتركها وحيدة تحت الحريق والأنقاض والتهديد بالطاعون.
بيروت تحت القتل وأنا بعيد عنها.
وبيروت المدينة التي كانت مزدهرة بالفرح واللون هي ذي الآن تتلوّن بالدم والدخان والجثث، وأنا أتركها. وأنا عايشتها في أزمنة القصف والموت والظلام والرعب. كنت مع بيروت الفقراء. جسَسْتُ نبضها وآخيته في الشيَّاح ومخيم صبرا وساحة الشهداء والشوف والمتن و عاليه وقرنايل. عشت مع الثوار. سمعت أصوات بنادقهم وجاورتني قنابل اليمين الفاشي. أكلت من طعام المقاتلين ونمت معهم في الجبال. وفي الليالي المعتمة، كان صوت الرصاص والقنابل موسيقانا.
لم يكن ذلك بطولة. كان مشاركة.
لم يكن ذلك استعراضاً. كان اختباراً.
ولم يكن ذلك امتيازاً. كان انتماء للثورة التي تجري في مجرى الدم. انتماء لها أينما انفجرت في وطني وفي العالم.
الثورة بأي شكل ظهرت هي ممارسة وفعل، قبل أن تكون نظرية في أدمغة المثقفين. هذه واحدة من الحقائق التي اكتشفتها إبان الحرب الأهلية في لبنان.
حقيقة أخرى تعلمتها: الثورة، وهي تُعاش وتمارس فعلاً، تغيّر الإنسان. تنقله من طور إلى طور آخر. تكسر جدار الخوف والأنا الذاتية. تعلّمه كيف يتصلّب ويمتد نحو الآخر.
كيف ينصهر مع الجماعة ليشيدوا معاً من الألم والموت مدينة الفرح والحياة الجديدة.
آه. لو تنتقل عدوى هذه الحرب الأهلية إلى كل عواصم العرب لتنهض جمهورية الفقراء من خلال نيران الصراع الطبقي فوق أنقاض مدائن العرب الغاصّة بالقتلة واللصوص من كلاب البورجوازية.
أيار 1976
مرة أخرى أعتذر يا بيروت. أعتذر لرفاق المقاومة والحركة الوطنية البواسل الذين يفتحون قبراً للإمبريالية وعملائها في لبنان، هذه الحلقة الأضعف في السلسلة العربية.
أعتذر لأنني أغادر لبنان إلى سوريا.
■ فاصل شخصي رقم 1، أيار 1976
الآن أكتب بغضب لا عن الحالة الموضوعية إنما عن الحالة الذاتية. عن هذه العلاقة الغريبة مع آسيا.
وضع شاذ نعيشه منذ خمس سنوات. حب بلا أمل نما في ظروف غير طبيعية وفي أرض عقيم, تكره الشمس والحرية.
أكتب الآن بغضب عن هذه الإنسانة الغريبة: القاسية والحنونة، المتمردة والثابتة، الشجاعة والضعيفة، المهتمة واللامبالية. الإنسانة المعلقة بين سماء الميراث والآباء، وبين شوقها العارم للحرية والاستقلال الذاتي. وبينهما هي ضائعة عاجزة عن الاختيار. أكتب بغضب عنها لأنني أحبها وأكرهها في وقت واحد.
مذ عرفتها وأنا أدفعها نحو اختيار حياتها. نحو المجرى الحقيقي للنهر، نحو الضوء والحرية لتكون نفسها.
حين كانت تندفع خطوة إلى الأمام، ما تلبث أن تتراجع خطوتين إلى الوراء.
ومع أن شرطها الموضوعي قاسٍ، لكنها تستطيع أن تتجاوز هذا الشرط بحركة ذاتية حاسمة. مأساتها أنها عاجزة عن الحسم. ومأساتها هي مأساة المرأة العربية المسحوقة والمستلبة عبر القرون المظلمة.
لكن المرأة العربية الجديدة اخترقت ظلامها وتمردت على شرطها في أكثر من مكان.
وآسيا الآن ما تزال تترنح رغم وعيها المضيء، ورغم استرشادها بالعقل أكثر من العاطفة والإحساس في أحيان كثيرة.
ربما كانت آسيا تمثل حالة الكمون الثوري الذي لم ينضج بعد.
الكمون الجنيني المتحرك نحو التغيير لكن العاجز عن الفعل.
الآن أكتب بغضب وحزن معاً لأن علاقتنا تقف على مفترق طرق، وهي تميل نحو الافتراق والانكسار.
أشعر الآن والألم يمزقني أنّ كفاحنا معاً ضد الطغاة وضد الميراث وضد العلاقات المرضية السائدة، تغرب شمسه.
أهمس لنفسي: ما عدنا معاً ها نحن ننفصل. يبدو أن العالم القديم أقوى وأكثر وحشية. وإنه لأمر مفجع أن نصل إلى هذه النهاية.
منذ عام ونحن مفترقان. هي في الغرب وأنا في الشرق.
لقد كَتبَتْ: تعال إلى ليون. وعندما قدمتُ إلى ليون لم تكن هنا. لقد غادرتها إلى وطنها: الجزائر.
لماذا؟
لا أدري ولا أستطيع أن أفهم.
وقبل أيام كَتبتْ: هذا آخر أعوام فراقنا. منذ الآن سنظل معاً ونناضل حتى النهاية.
ولكن آسيا غادرت. وها أنذا الآن وحيد كشجرة في عراء. غريب في مدينة لا أعرف حتى لغتها.
ما يبقيني حتى الآن هو المهمة السرية الخاصة التي أحملها والتي لا أستطيع العودة ما لم أنفذها. لقد أوكلت إليها أن تساعدني في الاتصال وحددت لها وقتاً لذلك ومع هذا حتى الآن لا خبر.
أسبوع كامل وأنا كسجين في غرفتها في مدينة ليون، محاصر لا أعرف كيف أتجه، بانتظار رسالة أو برقية منها.
آي. آسيا. أصرخ غاضباً: لن نلتقي بعد الآن أبداً.
ليون، الخميس 15/7/1976
مضى أسبوعان وأنا ما زلت في مدينة ليون، أنتظر خبراً من آسيا حول قدومها والمهمة السرية التي قدمتُ من أجلها. كتبتُ لها مرتين وألححت عليها أن تنفذ الاتصال بعد إعطائها العنوان.
حتى الآن لا خبر. أعيش في حالة من الاضطراب والتشوش تصل عتبة اليأس. مليون لماذا أسأل يومياً وثلاث أو أربع مرات في اليوم أفتح علبة البريد. لا شيء.
الطعام متكرر ورديء ويعتمد على المعلبات والبطاطا والحساء والنقود أوشكت على النفاد.
النوم ممتنع تقريباً وصحتي تتدهور يوماً إثر يوم.
القراءة محدودة لأن كتب العربية لا تتجاوز كتابين: 1984 لأورويل وحي بن يقظان. وقد قرأتها مرتين. أقرأ بالفرنسية ببطء شديد وأفتش في القاموس الصغير أكثر مما أقرأ في الكتب. هناك مجلات تصفحتها مرات. لا جديد فيها.
أكتب بعض الفقرات في الرواية بين حين وآخر، وأستمع إلى الموسيقى دائماً.
الأخبار لا تُسمع إلا في المساء بصعوبة شديدة وهي موئسة وضاغطة على الأعصاب: حصار تل الزعتر، هجوم الجيش السوري مع الكتائب على جميع الجبهات، المقاومة تعاني من الحصار والتموين والوقود والأدوية.
رأسي ينفجر.
أخرج وقت الضحى لأتسوق الخبز والمعلبات وفي المساء أتسكع حوالي الساعة في الشوارع المجاورة للبيت، ونادراً ما ألج المقهى.
منذ أسبوعين لم أتحدث مع إنسان سوى نفسي.
اشتقت للناس والكلمات والصخب. للحياة التي تضج من حولي ولا تمسني. بل أكاد أقول: أرغب لو إنني سجين في بلادي مع رفاقي لأشعر بالأنس ورائحة البشر.
شوشتني آسيا. شيء منها انكسر في داخلي. أسأل خائفاً: هل خدعتني وتخلت عني في هذا الوقت الصعب؟
دائماً كنت أحلم بمهمة خطيرة لتعود ثقتي بنفسي، فهل تخذلني آسيا وأفشل في مهمتي؟
غداً وبعد غد سأبدأ الاتصال التلفوني حتى ولو كلفني ما تبقى معي من نقود، وبعدها أعيش على الخبز والماء متمثلاً روح المرحوم غاندي، طيب الله صموده الروحي العظيم.
إذا التقيت بآسيا يوماً بعد هذه المحنة، سيكون الحساب عسيراً. لا شك أنّني سأمزق في وجهها كل تاريخ حبنا الذي كان سراباً وحلماً. الحب الذي هوى كورقة خريف أمام أول هبة ريح.
هل تعتقد أنها أحبت رجلاً أخرق ومغفلاً سيؤثث لها بيتاً وادعاً، وينجبها أطفالاً أذكياء ورائعي الشكل، ثم يتأبطها في الأمسيات ويسيران الهوينا عبر الحدائق وعلى ضفاف الأنهار ويوشوش في سمعها كأي زوج بورجوازي بليد هامساً في سمعها: آه. كم أحبك يا حبيبتي تحت هذه الظلال الرخية؟
لا بد أنها نسيت من أحبّت. أفسدتها أوروبا البورجوازية المنحطة. تفكر الآن بأشيائها الصغيرة التافهة وتتخلى عني وعن العمل الثوري الموضوعي، تماماً كما تخلت وغادرتني حين كنّا معاً في لبنان، تحت لهيب الحرب الأهلية والرصاص والقنابل. تسافر الآن بعدما كتبت لي: تعال أنا أنتظرك. وفي أيلول الماضي، غادرتني وحيداً في بيروت وجاءت إلى فرنسا.
أذكر الآن هجرتها في تلك الأيام الصعبة، فيفور دمي وأشعر بأنني كنت واهماً ومخدوعاً.
ها أنذا أُخدع للمرة الثانية. ربما كانت حياتي خديعة متواصلة حتى مع الذين عرفتهم في حياتي!
كانت تعرف أنني نذرت نفسي للمستقبل الأفضل، وما كان الأدب يوماً إلا معبراً وجسراً للعمل الثوري. كانت آسيا تعرف هذا، وحاولت يائسة أن تثنيني عن ذلك، لكنّني خيرتها بين الافتراق النهائي وبين أن نكون معاً في المعركة.
حين اختارت الحزب الشيوعي الفرنسي، أدركت أنها اختارتني أخيراً. كان فرحي ملء الكون، وكانت آسيا آنذاك رمزاً للوفاء والكفاح الثوري، والإخلاص لميراثها التاريخي. ويومذاك، سجّلت في اليوميات كلمة أراغون عن إلزا: «لقد ولدت امرأة العصور الحديثة في بلاد العرب».
الآن وآسيا في الجزائر وأنا في بيتها في ليون، وعليها أن تقوم بمهمة اتصال سياسي، وهي لا تجيب ولا تكتب منذ أسبوعين، فماذا أكتب أنا عنها؟ وكيف أفكر؟ لكم أنا مشوّش!
اتصلت بها وقلت: ينبغي أن تأتي بسرعة لأن هناك عملاً.
وكتبت لها شارحاً. ومع ذلك لا تجيب.
الوضع يزداد سوءاً في سوريا. وآسيا ينبغي أن تسافر سرّاً إلى دمشق. والرفاق ينتظرون على أحرّ من الجمر. وحتى الآن، لا أمل يلوح في الأفق.
آه. يا للمفارقة بل يا للسخرية، وهم في دمشق يعتقدون أنني الآن أمضي شهر العسل مع آسيا، وأننا نلهو عن المهمة المكلفين بها بليالي شهر العسل على الطريقة الفرنسية.
أجل. أجل. إنني ألهو إنما بأعصابي المحترقة وبأشلاء آسيا التي أمزقها يومياً في أحلامي.
إنها تمطر فوق ليون
إنها تمطر فوقي. آه يا للرذاذ الرائع والرخي في هذا الأصيل «الليوني» الرمادي.
أخيراً اتصلت آسيا. آسيا الوفية لعلاقتنا وميراثها. غضبتُ وثرتُ عليها عبر الهاتف. كانت تضحك كطفلة ارتكبت خطأ طفيفاً. لقد قامت بمهمة الاتصال ولكن متأخرة بعض الشيء.
- كان هذا خطأ فادحاً ستدفعين ثمنه يوماً.
- متى تأتي إلى الجزائر؟ أنا انتظرك.
- إلى الجحيم. لقد طلقتكِ. وإذا جئتُ سأذبحك.
على هذا النحو، كان عتابنا على الهاتف. دائماً كنا هكذا. نغضب كإعصار، ثم لا نلبث أن نتعانق كطفلين مشاغبين أدركَ أحدنا خطأه فاعترف.
إنها تمطر فوقي وأنا أعبر شوارع ليون. شوارع خالية إلا من هذا البريق الفضي للمطر فوق الإسفلت وعلى الجدران والشجر.
في الواجهات البلورية، أقرأ الأسعار. أتوقف طويلاً أمام المكتبات. في واجهة مكتبة، ألمح صورة فوتوغرافية لهمنغواي مع الممثل غاري كوبر. ثم صورة له في باريس وهو فتى. إنه يتكئ على إفريز حديقة. أتذكر كتابه عن حياته في باريس. في الواجهة المقابلة صورة لـنابوكوف، عجوز ممدد على أريكة يذكّر بهمبرت همبرت في رواية «لوليتا».
أتسكع والرذاذ يهمي كفراش صغير. معطفي ملقى على كتفي احتياطاً لمطر مدرار. سكان ليون تقليديون جداً وهادئون: يبدون ناساً لا يحبون السير تحت المطر.
أعبر من منطقة نهر السون إلى منطقة نهر الرون. العمارات غير شاهقة. وليون مدينة قديمة من طراز القرنين السادس عشر والسابع عشر. مدينة تقليدية عامرة بالكنائس القوطية الكئيبة.
بالفرنسية أقرأ اللافتات. وحين تستعصي كلمة أسجلها في ذاكرتي لأبحث عنها في قاموس البيت.
منطقة ما بين النهرين جميلة. على الجانبين المقاهي والبارات ودور السينما ومئات المتاجر.
إنها تمطر فوق ليون. وأنا والمطر غريبان كهذه الطيور التي تجتاز الفضاء الرمادي وفي المدن الأوروبية القاسية كالحجارة، لا أحد يبالي بأحد.
الجزائر ـــ 27/7/1976
شيء ما ينكسر ويتحطم. وشيء آخر يأخذ لونه من الشفق. وأنا الآن مع آسيا نعيش صدمة الصاعقة بالصخرة. صخرتنا التي شيدناها عبر السنوات الخمس، هي التي تتحطم. إن دوي الانهيار يُسمع حتى مشارف الدم.
يبدو أن آسيا تخلّت عني في الزمن الصعب. ضعفت وتخاذلت أمام التجربة. وها هوذا الزمن الرديء بسكينه الحادّة يفصلنا.
تخلّت آسيا عن المستقبل المشرق، واختارت الزمن الراهن: زمن الطغاة، والقتلة، والتجار، زمن الحياة الهادئة الوادعة المستقرة، الآمنة كما عبّرت.
- أنت رجل بلا مستقبل. قالت.
ثم جرحتني: أنت رجل منفي ومطلوب خارج نطاق الأمن.
كما قالت ببرود فولاذي: أنا امرأة تحلم بحياة آمنة لا أعاصير فيها، وأنت اخترت الدروب العاصفة. هذه هي مفاجأة الصاعقة للصخرة التي شقتها. شيء ما ينزف. شيء ما ينتحب. وفي مكان ما من العالم يتداعى انهيار في جبل.
هوذا القلب يترنح من تأثير الصدمة المباغتة في أوقات الضعف. ومع ذلك، فالإنسان لا يسقط من طعنة غدر بيد امرأة. قد يكون درساً ولكنه كان قاسياً ومريراً.
هي ذي امرأة العصور الحديثة تندمج أخيراً مع ظلام العصور المنحطّة. يأخذها الميراث القديم. ميراث الأجداد المضاد للإنسان والمستقبل والثورة.
لقد انهار جدار كنت أستند إليه في أوقات الضيق والمحن.
كنت مع بيروت الفقراء. جسَسْتُ نبضها وآخيته في الشيَّاح وصبرا وساحة الشهداء والشوف والمتن وعاليه وقرنايل
كنا اثنين وها نحن الآن ننقسم. أنا الآن واحد. والذي كان غريباً يعود مرة جديدة إلى منفاه.
كَشْفُ خديعة امرأة في لحظة مفاجئة. امرأة كانت الضوء والعشب والماء. هذا الكشف الغريب الصاعق، هو النفي إلى الصحراء. الموت بطلقة في الفقرات. هي ذي المرأة، الصديقة، الرفيقة، الأم، الأخت، العشيقة، تنأى الآن كنجمة في سماء ما عادت تضيء.
وأنا أنظر إليها. إلى برودها الحجر.
إلى حياد عينيها. إلى وجهها الجامد كتمثال من صلصال. أرى الهاوية. أهذه حقاً هي المرأة التي كانت تنبض في الدم فيما مضى؟ شيء ما يموت.
إنسان كان ملء القلب والبصر والفكر، يموت. اللحظة، يُحتضر طفل كان جميلاً وذكياً ويحب الضحك والغابات والبحر والطيور.
الصمت الآن يملأ العالم لكأن قلب الإنسان يتوقف عن النبض. قلبي.
آسيا تموت. تموت. تموت.
هو ذا الحلم ينفجر وفي الأفق لا تلوح غير نثارات حمراء. هي ذي احتفالات أعراس الدم تبدأ.


