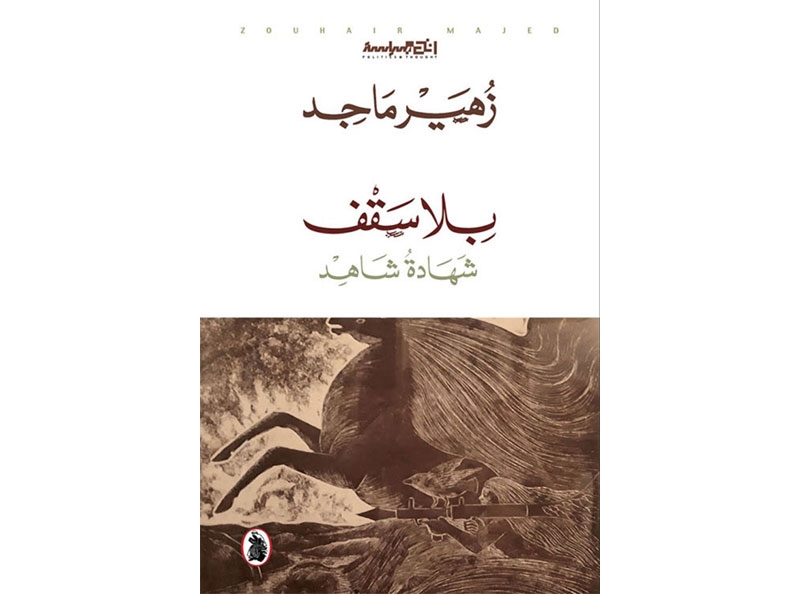
بعد المقدمتين والتوطئة، يضمّ الكتاب 28 مقالاً لا يمكن تصنيفها على أساس الفصول، بل على أساس الفكرة/ الحدث. إنها قصصٌ/ تأريخات مر بها «بطل الرواية/ الراوي». وكما في مدرسة الكتابة الإبداعية، يستخدم الكاتب تقنية Tell Tale: إنه الراوي، صاحب الفكرة، والتجربة، الذي يريد إيصال الصورة، كما شاهدها وعاينها بمشاعره، من دون تدخلٍ من راوٍ محايد. ففي مبكيات المقدّمة، يقول: «الجيش الإسرائيلي في شارع الحمرا ببيروت صيف عام 1982، نبأ يخترق التصديق بعدما اخترق جدار الصوت إعلامياً، يا لها من مفارقة، ويا له من يوم ذل ومن إحساس عميقٍ بالإهانة». هنا تدخل التجربة المعاشة في الحكاية؛ حيث يروي حكاية المواطنين المصطفّين في شارع الحمرا، تحت حراب العدو الصهيوني في صفوفٍ تفتيشية؛ وقد صودف وجود الرسام والنحات الفلسطيني مصطفى الحلاج: «عاجل أحدهم الإسرائيلي الذي يحدق في أوراق يحملها، مشيراً إلى الحلاج بأنه باكستاني. سأل الضابط الصهيوني الحلاج بإنكليزية مكسرة: هل حقاً أنت باكستاني؟ تطلع الحلاج حواليه، فرأى رؤوساً تومئ له بالإيجاب، فما كان منه إلا أن لفظ كلمة «يس» بعبوس شديد». هذه التفاصيل الصغيرة التي تفصل بين الحياة والموت، لم يكن ليعرفها إلا من عاشها وعايشها. يمتاز الكتاب عبر كل «مقالاته» بحكاياه الكثيرة، فضلاً عن تنقّله السلس بين حكايا قد لا تربط بينها إلا ذاكرة الكاتب الموسوعية والانتقائية في بعض الأحيان، كأن يحكي مثلاً حكايةً جمعت الشاعر إلياس أبو شبكة والسفير الأميركي ليحكي في المقطع نفسه عن الأفلام التي كانت تُعرض في دور السينما في تلك الحقبة من الزمن، وصولاً إلى فيلم «الفدائي الثائر» (للراحل غسان مطر) الذي كان معروضاً وقتها. ينقل شعراً قرأه لبلند الحيدري الشاعر العراقي الذي كان مسؤولاً عن قسمٍ ثقافي عمل فيه الكاتب في بيروت: «العدل أساس الملك.. صه.. الملك أساس العدل.. إن تملك سكيناً تملك حقك في قتلي». ينتقل حتى إلى بغداد ليتحدّث عن «جبرا ابراهيم جبرا في منزله في شارع المنصور ببغداد، الذي يشبه المتحف الصغير».
يستذكر وصول القوات الإسرائيلية إلى شارع الحمرا صيف 1982
لا يترك الكاتب فرصةً إلا ويُخرج أفكاره إلى العلن، هو هذه الأفكار قبل أي شيء: «معرفةٌ مبكرة لفلسطين من طفل غير فلسطيني كان عليه أن يكبر ليكون فلسطينياً باختياره وليس بهويته». يشرح وجهة نظره في كيان الاحتلال الصهيوني قائلاً: «التجربة مع إسرائيل؛ هذه الدودة الزائدة الملتهبة دائماً، والتي يقتضي قطعها من الجسم العربي كي يستقيم وينتهي التهابه». يقارب حتى سلوك الأنظمة العربية في علاقتها الملتبسة بالصهاينة: «سقط العرب في أول تجربة مع هذا الكيان، وسقطوا دائماً أمامه وهو يهمهم ويخطط صراعه معهم». هو يعطي حتى وجهات نظرٍ «خاصة» بأشخاصٍ عرفهم الجميع: «لا شك أن ياسر عرفات غير المعروف يومها (يقصد في خمسينيات القرن الماضي) كان مزهواً مما حصل للعرب من هزيمة مرة.. سوف يثبت لاحقاً أن الطريق إلى فلسطين لا يتحقق إلا بالكفاح المسلح والحرب الشعبية ويؤكد ذلك في معركة الكرامة بعد أقل من سنة على حرب يونيو». تفاصيل لا تشبه أي شيءٍ يعرفه أي متابعٌ آخر: «سحرتني الأنشودة الفلسطينية الجديدة التي كانت تبثها حركة «فتح» من إذاعتها في القاهرة منذ عام 1968. (وكان) ياسر عرفات يشرف بشكل شخصي على كل شاردة وواردة في الإذاعة وخصوصاً في مجال الأغنية، فكان يقرأ كلماتها قبل أن تلحن ويضع ملاحظاته عليها أو يصحح فيها أو يدخل عليها كلمات مقصودة لموقف ما». الأمر نفسه يأتي حين يتحدث عن الأحزاب، فيقول: «فهمتُ الأحزاب جيداً لأني لم أكن بعيداً عنها»، شارحاً كيفية نشوء الأحزاب، لغاية وصولها إلى مرحلة الفناء، مستعيناً بمشاهدات وتجارب خاضها وقاربها بشكلٍ شخصي. يشير غير مرةٍ إلى رأيه بالقادة العرب الحاليين والراحلين، فيتحدّث عن الراحل حافظ الأسد بوسمه «قائداً كبيراً»، وصدّام حسين «القائد الموهوب بالزعامة». في الوقت عينه لا ينسى أن يغوص في الشوارع العربية، فيتحدّث عن لبنان وطنه الأم، ويعرّي شيئاً منه قائلاً: «هنالك دائماً ما يزعجك في لبنانيتك، هل هي خلية تأسيسه، أم هي أخطاء غير منظورة ارتكبت أثناء قيام لبنان الكبير (1920) أم هو استقلاله الوهم». ويتحدّث بمباشرة أكبر: «مبادئ الإجرام اللبناني رأيتها بأم عيني وأنا شاب صغير في مرحلة الفتوة، ففي منطقة المعرض، وفي أوائل الستينات من القرن العشرين، رأيت فتاة تركض بسرعة وتصرخ بصوت مشوب بالهلع، ويركض وراءها شاب، إلى أن أمسك بها قرب شارع المكتبات، وعلى مرأى من الناس وتأملاتهم المذعورة، قام بإمساكها من شعرها ثم ذبحها وقطع رأسها ووضعه في كيس كان يحمله وسط خصره».
في الإطار عينه، يعطي رأيه في كل ما حوله، وخصوصاً «حرفته» ومهنته الأم: «كانت الصحافة مدخلي كما قلت إلى الحياة الاجتماعية اللبنانية». «لا أحمل شهادة في تخصص الصحافة، مما سمح لي أن أتجاوزها، حتى ولو كنت أحملها لما ابتعدت إطلاقاً عن المشوار ذاته الذي قطعته مع العمل التلفزيوني»، «الصحافة أنواع... الجالسون وراء المكاتب يتابعون وكالات الأنبياء وما يرسله المراسلون كتبة.. أما أولئك الموجودون في مراكز الأحداث وفي المتابعات الدائمة والمراسلون، فهم الأولى أن يطلق عليهم صحافيون. ومع ذلك يسجل لمن عمل في الصحافة أنه نصف مؤرخ، إضافة إلى نصف جغرافي، وإلى نصف اقتصادي». هو لا يتناول الصحافة فحسب، بل يغوص أكثر في طبقة «الانتلجنسيا» العربية، شارحاً: «لا يشكل المثقفون العرب النخبة الاجتماعية إلا ما ندر منهم». يعطي الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي كمثال، مشيراً إلى أنه: «كان أستاذاً في النميمة ولم يمكن له صديق أو رفيق درب إلا ونم عليه أثناء غيابه.. وكان في الوقت نفسه هجومياً في كل الحوارات التي أجريت معه». الأمر نفسه ينسحب على نماذج يشير إلى أحدها (بدون ذكر اسمه) «هنالك شاعر عربي معروف ويقال كبير، صرح لأحد أصدقائه، أنه طالما يطلقون عليه الشاعر الكبير فعليهم أن يقدموا الطاعة له». باختصار هو كتابٌ لافت، يظهر عالماً لا يعرفه أحدٌ بخلاف من عايشوه بشكلٍ يومي. هو جهدُ حياةٍ متنوعة خصبةٍ لكاتب رأى وشاهد وسجّل، وأصبح هو «السقف في حياته»، ببساطة، وبشكلٍ مباشر.


