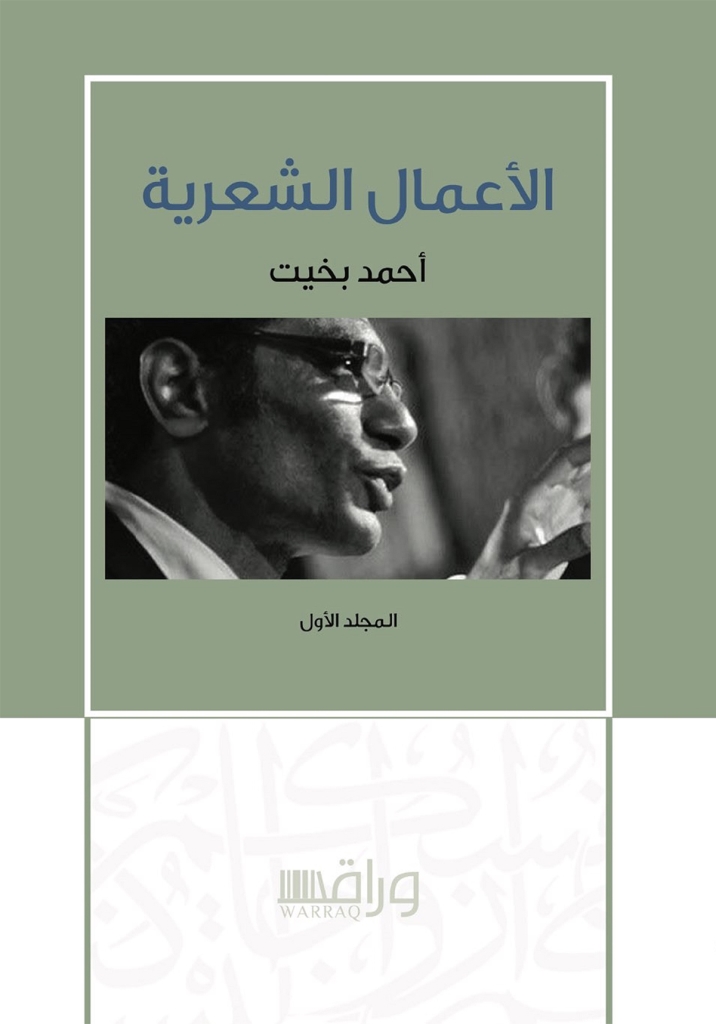
بعدما درس بخيت في «كلية دار العلوم» في «جامعة القاهرة»، وتخرّج عام 1989، وعمل معيداً في قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن لمدة خمس سنوات، قرّر ترك العمل الأكاديمي؛ ليتفرّغ للكتابة منذ 1995. اتّخذ هذه الخطوة لأنّه شعرَ بأن العمل الأكاديمي بدأ يسرق من شاعريته وإبداعه، فقرر أن يتفرّغ للكتابة لأنّه آمن أن الإبداع لا يقلُّ أهميةً عن العمل العملي، فالإبداع عمل كامل يستغرق كل الحياة، ويستحق أن يكرّس المبدع جهده له.
لذا منذ أن أصدر بخيت أوّل الأعمال الشعرية «وداعاً أيتها الصحراء» (1998 – دار زويل للنشر)، نُلاحظ أن الدفق والتغيير، والتشتُّت والتشظي، شكَّلت قاعدة التأثير المادي للحياة الحديثة في القاهرة بالنسبة إلى ابن الصعيد، وعلى نحو حاسم. وبالنظر إلى ذاتية الشاعر، حاول أن يتحدّى صيرورة الاغتراب تلك، أو بشكل أدقّ التعايش معها، والسيطرة عليها، أو السباحة في مياهها. عموماً، أدرك بخيت أنه لا يستطيع، في كل الأحوال، تجاهُلها. لذا توالت أعماله الشعرية أبرزها: «ليلى شهد العزلة» (1999 ـــ دار زويل للنشر)، و«ليلى صمت الكليم» (2002 ـــ منشورات بخيت)، ليؤكّد أنه شاعر قادر على تركيز رؤيته على الموضوعات العادية للحياة المعاصرة، وعلى فهْم خصائصها المُتغيرة، ويستطيع مع ذلك أن يستخرج من اللحظة العابرة كل عناصر الخلود الكامنة فيها.
كانت مُعالجة الطفولة والمراهقة في أعمال بخيت تمثّل استخلاص السرمدي من العابر والزائل. وهذا الزائل أو العابر لم يتمكّن بخيت من تجاوزه، حيث العنصر العابر والمُنفلت، والذي تكون تحوّلاته جدّ متواترة، لا يمكن الاستغناء عنه كونه شكّل بخيت الناضج. بل إنّ إلغاء الفترات الأولى كانت ستُسقط بخيت في تجريد جماليّ يستعصي على تحديد نصوصه الشعرية. فوفقاً لتعريف الشاعر الفرنسي العظيم بودلير في دراسته «رسام الحياة الحديثة» (1863)، المؤقت، وسريع الزوال، والجائز، هي نصف العمل الشعري؛ بينما الأبدي والثابت هما النِّصف الآخر. وحده الشاعر الناضج ـــ وفقاً لبودلير ـــ هو ذلك الذي يستطيع العثور على الكليّ الدائم، وأن «يقطر طعم خمر الحياة المُرّ» من أشكال الجمال العابر والزائل في حياته اليومية. وبمقدار ما يَنجح النصّ الشعري في ذلك، يُصبِح شعراً بالنسبة إلينا؛ أو بدقةٍ أكبر يصبح نصّاً شعريّاً مستجيباً ومُعبّراً عن سيناريو الفوضى في حياتنا.
في قصيدة بخيت «رام الله»، نجده يُطربنا بهذه الأبيات: «فلّاحُ هذي الأرضِ.. عمْري حنطتي، وبَذرتُ أكثرهُ.. حصدتُ أقلَّهْ، ستون موتاً بي وبعدُ مراهقٌ.. شَيِّبْ سِوايَ.. فها دموعيَ طفلةْ». تلخص هذه الأبيات القليلة نظرتنا العامة إلى شعر أحمد بخيت في نقطتين: الأولى هي المواجهة بين الخالد والعابر الحاضرةُ تقريباً في كلّ قصائده الحداثية الطابع. بالعودة إلى بودلير مرة أخرى، نجد أن الحداثة الشعرية تَستهدِف الاعتراف باللحظة الانتقالية كماضٍ أصيلٍ لحاضر سيأتي. لذا، ميّز بودلير أدباء الحداثة بحنينهم الدائم إلى الماضي في ظلّ الحدث الراهن. والنقطة الثانية هي تقليدية بخيت التي تعود إلى القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث النزعة الرومانسية التي رأت في العودة إلى الماضي أو تمثيل الطبيعة موضوعات شائقة للأعمال الأدبية. إنّ بخيت بحداثته وتقليديته ونزعته الرومانسية يحقق معادلة صعبة، يشير إليها بودلير بالوضع المُلتبِس موضوعيّاً لفهم الحداثة كمحاولة تحويل اليومي الزائل إلى الرمزي الخالد. كما أنّ التقليد والرومانسية هما الردّ بالنفي على النزعة الواقعية التي يَصفها بودلير ﺑأنها إهانة مُقزِّزة أُلقيَت في وجه كل المتلقّين. إنها نزعة - أي الواقعية - غامضة وزئبقية لا تعني بالنسبة إلى الإنسان وصفاً دقيقاً للأمور.
وجعل الطريق المُمهِّد لاغتراب الإنسان والطبيعة قصائد عند أحمد بخيت «لا تقول شيئاً ما، وإنما هي الشيء نفسه»، كما يشير تي إس إليوت، حيث يَتتبع إليوت تطوّر الشعر، واستقبال القراء للشِّعر، على أنه تطوّر مُستمر نحو زيادة إدراك القارئ بالرمز. وهذه المرحلة من التقدُّم هي ما يَعتبرها إليوت الحداثة التي بلغها الشعراء الرمزيون الفرنسيون من بودلير إلى فاليري مروراً بمالارميه. فالحداثة هنا تَتميَّز بالاهتمام بالرمز، في مقابل الاهتمام الأقل بالموضوع الذي يُصبح مجرَّد وسيلة لنقل الهدف أو بلوغه. والهدف بالطبع الجمال بحدّ ذاته، وهذا ما يمكني أن أدعي أنه يختلف نسبياً لدى أحمد بخيت حيث قصائده «شعر نقي» بتعبير الفيلسوف الإسباني أورتيغا إي غاسيت (1883–1955) مُهتمّ بمزج النتاج الشعري والرومانسي والطبيعي من دون أن يمحو العناصر الإنسانية.
ثمة سِمَات يَتميّز بهما شعر أحمد بخيت: الأولى هي الدرجة العالية من الوعي الذاتي للشاعر بفنِّه على أنه فنّ وليس موظَّفاً في خدمة شيء آخر. والسِّمة الثانية تعتمد على الأولى، هي أن هذا الوعي الذاتي دفع أحمد بخيت إلى المزيد من الفردية والذاتية، ومحاولة خلق أسلوبٍ خاصٍّ به يُميِّزه عن الفنانين الآخرين، سواء المعاصرين له أو السابقين عليه. بخيت ليس أول مَن يشير إلى نفسه في عدد من قصائده بالجنوبي، فهي عادة يكتسبها كل شعراء الصعيد تقريباً على اختلافاتهم في الشكل وطرق الحكي والكتابة. الجنوبي هي مظلة واسعة لهوية مفتوحة يقع تحتها أمل دنقل، سيد العديسي، حسن عامر وآخرون تجمعهم شدة النحافة وثقل الموهبة. من هنا نلاحظ أن التراث الفني أصبح عبئاً على بخيت وجزءاً من العالم الخارجي الذي يَسعى لتحرير نفسه منه، وإنتاج فنه بمعزل عنه. هكذا يُصبِح الأسلوب وسيلةً لتأكيد الذات مقابل العالم. ويُصبح الأسلوب الشعري كنتاج للذات أو للجزء الذاتي أو المثالي في الشاعر تأكيداً لهذا الجانب مقابل الجانب الموضوعي أو ذلك الذي يَنتمي للعالم. والسمة الثالثة، وهي التناص الذي يُعد من أهم محاور إثراء الدلالة، ويجعل النص الشعري لبخيت أكثر إشعاعاً ورمزية. التناص كما قدمته الناقدة الأدبية جوليا كريستيفا ما هو إلا تعددية للنُظُم، وقابليتها اللامتناهية (الدائرية) للنسخ. وقد عرّف رولان بارت التناص بشكل أكثر صرامة، حيث جعل النص تجميعاً واقتباساً وتداخلاً مع نصوص أخرى سبقته؛ حيث الشاعر هنا لا يستطيع إلّا أن يُحاكي حركة سابقة له على الدوام، من دون أن تكون هذه الحركة في الأساس أصلية. ويمكن أن نتوافق مع بارت هنا، مع الإشارة إلى أن حيوية ورمزية وإشعاع نصوص بخيت تنبع من نوع خاص مِن التناص وهو «التناص الديني».
أعاد تقديم التراث الديني الذي يُعدّ مصدراً سخيّاً بالنماذج والموضوعات الأدبية
لقد أعاد بخيت تقديم التراث الديني الذي يُعد مصدراً سخيّاً بالنماذج والموضوعات الأدبية، وعمل على تضمين نصوصه الشعرية نصوصاً دينية مختارة عن طريق الاقتباس من القرآن والحديث الشريف والكتب السماوية الأخرى مع النص الأصلي للقصيدة بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الشعري، وتؤدّي غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معاً. الثمة الثالثة عند بخيت تعيدنا إلى الشاعر والناقد ماثيو أرنولد (1822–1888) الذي أشار إلى أن الفن الحداثي يمكن أن يشغل المكانة التقليدية التي كان الدين يَشغلها في العصور الوسطى. لذا فهو منوطٌ به وظيفة توفير رؤية كلية للحياة الإنسانية، تُوضِح مَوقف الإنسان في الحياة، وتَرسم له صورة ذاتية، وتُضفي الطابع النظامي على العالم والتجربة الإنسانية.
في الأخير، فإنّ التعامل بعين ناقد مُحبّ لنصوص أحمد بخيت شديد الصعوبة، لكن يمكن اعتبار القراءة النقدية وسيلة لاستخلاص الحقيقة التاريخية واكتساب المعرفة عبر الرمزية واللمحات الفلسفية والدينية. وفي الوقت نفسه، تبقى نصيحة بودلير التي دعا فيها إلى تخلِّي الفن عن أيّ وضع مُتعالٍ؛ أي رفض كل وضع يخرج به من حيِّز إنتاج الجمال إلى أي مسؤولية فلسفية أو أخلاقية. لذا فالشعر لن يَضطلِع سوى بوظيفته الداخلية، ألا وهي إنتاج الجمال. وهذا سوف يُؤدِّي بالضرورة إلى فرض معايير جديدة للحكم على الشعر، وهذه المعايير ستكون مَعايير داخلية نفسية، لا علاقة لها بالأخلاق أو بوضعِ الشعر في المجتمع.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا


