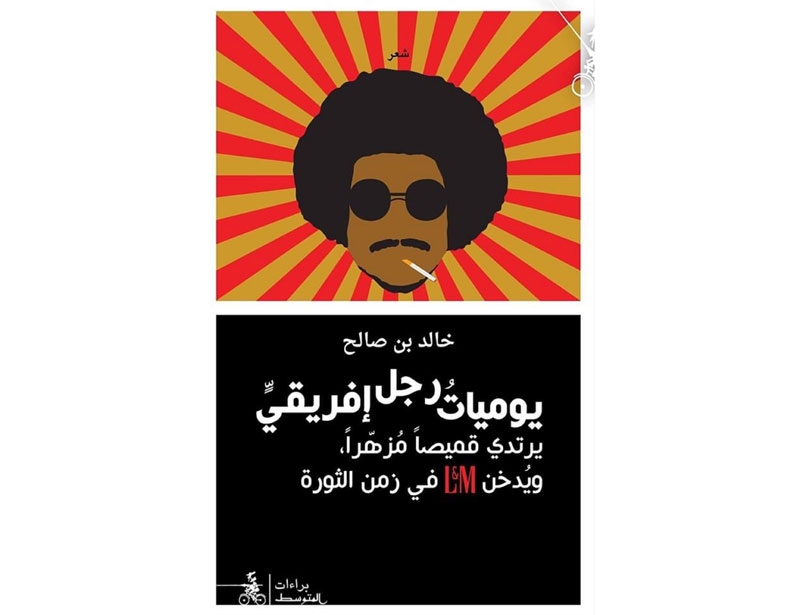
ليس الكتاب إعلاءً من شأن الهزيمة ولا دعوةً لاعتناقها، إنما مُحاكاة ساخطة ليوميات رجلٍ أربعيني يائس، يحاصره راهنٌ سحيق لا يمتّ إليه بصلةٍ «سقف المقهى ينخفض عاماً بعد عام، بجلده اليابس، تماماً كوجهي الصباحي، وأنا أجرّ سنواتي الأربعين، كما يجر حصان منهك عربة مليئة بالخسارة». في هذا المَجاز البسيط اختصارٌ لمزاج بن صالح السوّداوي، ودلالةُ واضحة على موضوعات الكتاب، إذ اختار النص النثري المتفلّت كتوّجه أدبي عوضاً عن كتابة القصيدة السائدة، وذلك يعود مبدئياً لىسببين أساسيين: الأوّل، أنه دفع بالحداثة إلى أبعد حدّ، غير اَبه ببنية أو بشكلٍ بل بالإفصاح المجاني عن وجدان مشتعل لا يعرف نسقاً ولا تهدئ من روعه سيجارة. أما الثاني، فمردّه أن هذه النصوص التي تتخللها سردية نثرية وتمتاز بصوتٍ واحدٍ، نابعة من تجربة حقيقية، فمن البديهي أن تجد التصاقاً تامّاً بين الكاتب ونصّه، ما يحتاج إلى مساحة تعبيرية يَفرضها النَفَس. إذن، يوميات رجل أفريقي هو بوتريه لذاتٍ شيّدها واقع مأساوي، تُفصح عن ذكرياتها وتعيش جولات صراع متتالية مع الزمن وثقافته: «هكذا تدور الأزمنة، وأنا ألعب بالكلمات كيائس فقدَ طريقه إليكِ، أنت الواقفة في نقطة جغرافية لا تلين، بيننا نساء وأوطان مدمرة وكراس لا تتحرك من تحتها رمال». على غرار شعراءَ كُثر، استعار بن صالح تشبيه المرأةِ بالثورة، باعتبارها خلاصاً جميلاً من سلطةٍ موحشة، إلّا أن فرادته تكمن في قدرته على استعمال الرمزية بالتوازي مع الواقعية وليس على حسابها. هذا التماهي بين الحقيقي والمتخيل خدمة لتصوير ذاتٍ متصدعة تجسدت في أسلوبٍ مشهدي كثيف الحركةِ والوصف، ما جعل نصّه دراميّاً، فائق الحساسية وحقيقياً للغاية: «أواصل المشي في المنام، تطاردني سيارات الأجرة الصفراء، اللافتات التي تسبح آناء الليل وأطراف النهار، الزجاج المتسخ، ماسحات المطر المعطلة، أغاني الراي التي لا تصلني كلماتها، الأحاديث الجانبية، والتي تخرج عن السياق، وتلك المبتذلة والمتداولة بحكم الضجر». على هذا الإيقاع، يسير بن صالح في كتابته، مولجاً في التفاصيل، منقّباً بما هو يوميٌ بسيط، معتنقاً إياه كخلاصاتٍ شخصيةٍ وجودية: «هنا الحياة كما في البدء، فقط اَدم وحواء والكثير من الأكاذيب حول تخفيض أسعار الفنادق والتذاكر وظروف التنقل والاستجمام»، ضارباً بعرض الحائط كل القضايا الكبرى والقناعات المعلّبةِ الجاهزة: «في لعبة كرة القدم، تموت اَلهة كثيرة، ويُحال أنبياء مزيفون على التقاعد، وفي لعبة كرة القدم، تنمو الأنظمة الشمولية في الظلّ، وتعرِّشُ وتُفرخُ أيضاً قبل أن يداهمها ضوء أولى ساعات الفجر». كأن كتابة الشعر عند بن صالح مجال انتقامي بحت، ساحة معركة شرسة مفتوحة، يشُن فيها الشاعر حروبه الخاصة على القواعد العامة، على الموروثات المتأصلة في زمن الهدوء أو السلم، فتراه يكشف عن أغواره بحريةٍ ومن دون تكلفٍ «ليس هذا ما أنا عليه فعلاً، أنا رجل عصابة شنيعة، أشرب بقدر الشتائم التي أطلقها كل يوم، أبحث عن امرأة للتمثيل في فيلم بورنو».
لا ملاذ أو تعويض لكل هذا الراهن ولا حتى في الذكريات
وفي السياق نَفسه، تُذهل من كثافة المفردات الحربية، كأنها ذخائر بحوزته متعطشة لتأدية واجبها، يستخدمها لخلخلة الثوابت («جنود يواجهون حائطاً لحظة إعدام» أو «قبل أن ينفجر رأس شاب في أثناء المظاهرة») وزعزعة المألوف (تلك الغيوم المتّسخة تنزل قطرات المطر، لتقرع الخرطوش الفارغ، وبقايا القنابل المسيلة للدموع). أمام لغةٍ كهذه مدججة بمصطلحاتٍ واستعارات صاعقة، أنتَ حتماً على موعد مع الحرب. الحرب كحدثٍ خارجي يجعل منك ملكاً للغضب لا يكرمه عرشه إذا ما أفرط في استعمال الشتيمة (اللعنة على الحرب تستفيق البنت من قيلولتها وقد نسيت درس الموسيقى، كما يستفيق جندي فاقداً للذاكرة). إنه المسار الذي انزاح عن هدفه. الشاعر الذي رأى قبح العالم، تحدث عن الكتب، ونَظّر للثورات (كان العالم قبيحاً في الخارج، وكنت أسافر عبر المتوسط من عاصمة إلى أخرى أتحدث عن الكتب)، لكنّ شيئاً ما حدث وأجهض كل هذا الجهد. هذا ما ستفهمهُ لاحقاً، من دون تعريجٍ على المباشر بما يحمل من نعيق أو الدخول في المبتذل، استطاع بن صالح الحفاظ على متانة نصه وفجاجته (لو خرج نصفهم إلى الشارع كما خرجوا بعد نهاية المباراة، لكان لثورتنا شأنُ اَخر؟)، محمّلاً ثقافة السائد وجماهيرها التي طعنت جهده كل الإخفاقات والهزائم وتركته يحَصد وطأة الهزيمةِ ويعتريه حسّ الغياب حد الاختناق: «لا يدري أين ومتى سيعثر على الكلمة المناسبة، تلك الجملة التي تخطف أنفاسه فجأة، كما لو أنها حشرجة ما قبل الموت».
لا ملاذ أو تعويض لكل هذا الراهن ولا حتى في الذكريات. لا تلعب الذاكرة عند بن صالح دور العزاء، أو محركاً للحنين، بل تفصح عن الشلل العميق المتجذر الذي يصيبه «الذكريات ثقيلة كحقائب، تقوّس الظهر». إنه الزمن الذي لا يتغير، ساعة توقفت عن العمل، ماضٍ تعيس يكرر نفسه في حاضرٍ قاتم: «ثمة أنت، وثمة أنا بجرحٍ طفيف في الذاكرة حوله ذباب كثير»، وما الأمل سوى محاولات واهنة لا تشفي شيئاً من كل هذا العجز: «النجاة كذبة، الموت غير تام، طبقة خفيفة من الغبار تعلو أسماءنا، على ورقة حفظ الجثث، فوق طاولةٍ باردة». في رسالةٍ أشبه بمونولوغ داخلي، يُخاطب بن صالح الشاعر كيتس، مستعيناً باقتباسٍ من فرانز رايت وصفتهُ به صديقته «أحد جرذان الأرض التي تتصرف/ كما لو أنها تملك المكان». ليس الجرذ سوى مخرّبٍ خطير لا يحترم قوانين الأماكن. إنها المهمة التي أنجزها بن صالح في الشعر. لكن ما هي تلك الثورةِ التي كان يحلم فيها أصلاً وينظّر لها قبل أن يقع كل هذا الخراب وتنهش روحه كل تلك الخسائر؟ إنها جملة واحدة خارقة تعادل لغة بن صالح العنيفة وذاته الرافضة قطعاً، من مانيفستو لم يُنجز بَعد: «خرجتُ في مظاهرة بصدرٍ عارٍ، أحمل لافتة ضدي»، وربما أنجز ولم تحبّذه الجماهير.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا


