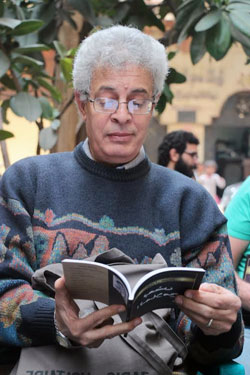كان «الحلم ظل الوقت، الحلم ظل المسافة» بروفا غائمة للديوان الذي أحلم به، حاولت مها أن تحوّل البروفا إلى عرس سريّ، جاءت بالشيكولاتة والجاتوه، وزارتني في البيت لأول مرة. في الصالة استقبلتها أمي وأختي فرحتين، وفي الغرفة خلعت بلوزتها وأخرجت من حقيبتها النسخة المهداة إليها، ووضعتها على طرف السرير. بعد فاصل من الخجل لمست بأطراف أصابعها عنقي، ولما ارتعشتُ، صعدتْ بأصابعها إلى شفتي، ثم أوقفتني واقتربت إلى حد الذوبان، لكننا فشلنا في النزول إلى البحر، مسحت مها عرقها، ففكرت بقلبي كيف أن حريتي يلزمها التخلي عن هذا الحلم، لذا أهملت الديوان البروفا، وتشاغلت بالسعي الحار وراء رغباتي المستورة، وانهمكت في مطاردة النساء العصيات. في أسانسير العمل، وفوق سطح المنزل، كنت أفتش عن حلم جديد وعن ديوان أول، ومثل مجرم محموم حاولت اغتيال الديوان البروفا، ووضعته في مقبرة هوائي الفاسد. الغريب أنني تصورت أني سأفعل ذلك بدم بارد، لكنني ذات صباح بكيت وهربت جداً حتى احترفت الهروب من نفسي إلى الآخرين.
صادفني السورياليون والشوام، فأمتعني وآلمني السهر معهم، جورج حنين ورمسيس يونان وجويس منصور، ورويت منادماتهم دون أن يصدقني أحد، ولم أتكتم على أسرار يوسف الخال وشوقي أبوشقرا وفؤاد رفقة وليلى بعلبكي ومحمد الماغوط وعصام محفوظ ويوسف حبشي الأشقر وفؤاد كنعان ورينه حبشي، لأنني لم أعد أعبأ بأن يصدقني أحد.
واشتهيت الإسكندرية، طاردتها حتى قادتني إلى الإسكندر وقايتباي وكفافيس والعرب الغزاة ولورانس داريل وفورستر وبنسيون ميرامار، ومثل ممسوس كتبت قصيدتي عنها، واعتدت بعدها أن أتسمع لهاثها، ظننت أنه يختلط أحياناً بلهاث الله، فتركت الله في مكان بعيد عن الأرض. كنت أحياناً عندما أكون بمفردي وليس معي سوى أحلامي وكتبي، كنت أختار أقرب ديوان إلى قلبي، وأجعله ديواني القادم، أضع فوق غلافه ورقة بيضاء غير شفافة، وفي نصفها الأعلى أكتب اسمي بخط بارز، وفي النصف الأدنى أكتب «الغبار أو إقامة الشاعر على الأرض»، وكنت أحار في اختيار دار النشر، فأكتفى بأن أكتب بيروت. كررت المحاولة مع ديوان «أغاني مهيار الدمشقي» لأدونيس. أعترف أنني لم أجرؤ أن أفعلها مع «لن»، ولكنني فعلتها بشغف كبير مع «الرأس المقطوع»، وبشغف أكبر مع «ماضي الأيام الآتية». أحياناً كان أدونيس يصاحبني في جولاتي الهائمة ، فيما أنسي الحاج يقف على قارعة الطريق، لكنهما سيجتمعان في غرفتي.
لم أستطع أن آذن لهما بالوقوف في الشرفة، غير أنني فتحت الغرفة للآخرين، وظللت طوال أربع عشرة سنة أضع غلافي فوق دواوين الغير، حتى صارت القائمة أطول من قامتي، لأنها اتسعت وشملت «خطوات في الغربة» لبلند الحيدري، و«الأخضر بن يوسف» لسعدي يوسف، و«أوراق العشب» لويتمان، و«داغستان بلدي» لرسول حمزاتوف. في المرة الأخيرة تجاسرت ووضعت غلافي على الكتاب المقدس، ولم أقتنع، فاكتفيت بنشيد الإنشاد وسفر الجامعة. لكنني ضبطت نفسي أعاني من شهوة الخفاء. كانت المسافة بيني وبين شعراء «أصوات» آخذة في الاتساع، و«أصوات» هي جماعتي الشعرية التى أصدرت ديواني البروفا. نشر أحمد حجازي مقالة
في بابه الأسبوعي «أدب»
بعنوان «نداء إلى شعراء المستقبل»، يبشّر بموهبتي
أيام «أصوات» كنا في قلب الأرض الأولى، البراءة والخوف، وبعدها أصبحنا في قلوب الخطايا العشر. ذكريات «أصوات» تدفعني إلى خليط من التعاسة والضحك، وإلى خليط من الآخرين، فها أنذا أتذكر لقاءاتي الأولى مع أحمد حجازي، وأذهب إلى شارع القصر العيني، وأقف أمام مبنى «روزاليوسف» كأنني أقف على الأطلال، وفي البيت أحاول العثور بين مجلاتي على المقالة التي نشرها حجازي في بابه الأسبوعي «أدب» بعنوان «نداء إلى شعراء المستقبل»، يبشّر بموهبتي، ويتنبأ باختصار اسمي.
كنت في السنة الجامعية الأولى، أذكر كيف أصابني الزهو، فرفعتُ ياقة قميصي ومططت عنقي، وسألت بصوت خفيض يخفي اشتهائي رؤية اللمعان في العيون: هل قرأتم مقالة حجازي. في البيت لم أجد المقالة، وجدت آثار جماعة «أصوات»، أوائل الثمانينيات. وبعد مقتل السادات، شاءت السلطة الجديدة وهي الطور الثالث لحكم العسكر، بعد طورين صاخبين، البكباشي ناصر والقائمقام أنور، وقبل الطور الرابع، المشير عبدالفتاح، الذي كأنه أحجية، شاءت السلطة الجديدة صيد الشباب الغاضب. كانت السبعينيات حقبة شعراء أكثر مما هي حقبة روائيين، حقبة رؤيا وحدس أكثر مما هي حقبة رضا ويأس. وشاءت السلطة الجديدة أن تحشو قلوبنا بالتراب الأحمر، فاستقدمت البشر الودعاء ليكونوا شباك صيد، وجعلت منهم مجالس تحرير لمجلات جديدة، حتى أنها أوقفت الثلاثة، عبد القادر القط وسليمان فياض وسامي خشبة، على درج المجلة المدعوة «إبداع»، وأوقفت الثلاثة عز الدين اسماعيل وجابر عصفور وصلاح فضل، على درج المجلة الأخرى المدعوة «فصول»، فصدقناهم، على الأرجح رغبنا أن نصدقهم، وسعينا وراءهم، وانصرفنا عن مطبوعاتنا الفقيرة، وتركناها تنكفئ وتنطفئ.
لم ننتبه إلا فيما بعد بأن جلودنا أصبحت أكثر نعومة. أواخر الثمانينيات، عاد الشاعر أحمد حجازي عودته الطويلة من منفاه الوهمي في باريس، ليرأس تحرير مجلة «إبداع» في إصدارها الثاني، وإثر خلاف حول المبادئ الأولية لنشر الشعر، استطعنا أنا وهو والآخرون، وبمعونة جابر عصفور أن نتفادى القطيعة. بعدها اشتعلت حماستي، ونشرت القصائد التى كنت أختلي بها، لكن هذه الحماسة لم تردم الهوة السحيقة في جوفي، فها أنذا شاعر بلا دواوين سوى الديوان البروفا، الديوان الخام. كان جابر عصفور يلح على تذكيري بواجباتي الشعرية، ويسألني: أين كتابك؟. في أثناء سؤاله كنت أنظر إلى تقاسيم وجهه، وأراه يضرب بجناحيه ويطير مخفوراً بطموحاته وكتابيه «المرايا المتجاورة» و«مفهوم الشعر». قبل التسعينيات رأيت جابر ينزل من قطار صلاح عبد الصبور ثم من عربة أمل دنقل. وفي التسعينيات رأيته يصعد قطار أدونيس هرولة، ويجلس في المقدمة إلى جوار كمال أبو ديب وخالدة سعيد وحليم بركات، وعندما راقبته رأيت أعماقه، وكأنها على المحك، وكأن أصابعه تحفر الفراغ، فيما كان أحمد حجازي يتخيل أن قامته أطول كثيراً من قامة الشعر.
ذات لقاء أشارت السيدة سهير بسبابتها نحوي وقالت لحجازي، زوجها، لا تنشر لهذا الولد، قصائده وقحة، وكانت قصيدتي «أنت الوشم الباقي»، التي عندما التقيت أنسي الحاج في بيروت، وبينما عينه في عيني، وعيون الأغيار تراقبنا، أسدل جفنيه قليلاً وأخذ يقرأ. الأصح أخذ يرتل بعضاً من الوشم، وأمام باب الوداع أبلغني كأنه يأتمنني على سرّه، بأنه يضع بالقرب من سريره بعض كتبه الحميمة ومنها «قبل الماء فوق الحافة»، صمت قليلا ثم قال: لأخونك وأخون نفسي، وضحك. قصيدتي «أنت الوشم» ذهبت بفاروق حسني وزير الثقافة إلى البرلمان لاستجوابه، كما أن التعويذة وقفت أمام القضاء بتهمة العيب في الذات الإلهية، وعندما لجأت هيئة الدفاع إلى طلب شهادات أهل الاختصاص، استجاب لها الدكاترة شكري عياد وعبد المنعم تليمة وجابر عصفور. في ذات الفترة كتب حجازي مقالات كتابه «أحفاد شوقي»، وشملني بأربع منها، فغمرني زهوّ شاحب. حماسة حجازي أغرتني بجمع القصائد المنشورة في «إبداع»، وتغطيتها بورقة بيضاء غير شفافة، مكتوب عليها اسمي واسم ديواني «الغبار أو إقامة الشاعر على الأرض»، وحماسة جابر أغرتني بقبول وساطته في حمل مخطوطتي إلى هيئة الكتاب، لكن سدنة النشر عطلوها.
أيامها كان حصادي الوفير من عطايا الشعراء الأربعة يتبدد ويصبح هزيلاً، وإن ظل عبدالصبور في المقدمة، وإن ظلت قصائد حجازي الأولى، قصائده البيضاء، عالقة في ثيابي، وإن ظلت السيدة نفيسة قنديل امرأة عفيفي مطر تخايلني وتخامرني، ولولا «أوراق الغرفة رقم 8»، ما خطر أمل دنقل ببالي، وما خطرت قصيدته «لا تصالح».
أيامها رأيت اليسار الذي كان بطانة تمردنا، يغتسل ويتخلص بسرعة من أدرانه الثورية، ليصبح بطانة السلطة الجديدة، وسوف لن يتوقف عن المراوحة بين شرفه الضائع ورغباته المحمومة، انظر رفعت السعيد ولطفي الخولي وصلاح عيسى. أيامها أيضاً تهيأت للطيران بأجنحة أدونيس، أضفت إلى مخطوطة الغبار مجموعة قصائد جديدة رغبت في تسميتها قبل الماء البارد، وأعطيت المخطوطة له، بعد مهلة قال لي: الناشر سيكون «دار الآداب».
هل لاحظ أدونيس ارتعاش قلبي وأنا أخفي سروري، بعد مهلة أخرى، قال لي: هل تقبل اقتراحاً بعنوان جديد للديوان، ولما باح به، لعقته بلساني وأذني، قبل الماء... قبل الماء...، وقبل أن أتمّه أغلقت فمي عليه، شعرت وكأنه ظلي. وعندما بعد شهور صدر الديوان عام 1994 ووصلتني النسخة الأولى، فوجئت بغلافه يستند إلى ساق عالية مسروقة من حلم أزرق، سألت عن السارق أخبروني أنها رسامة لبنانية، فألزمت نفسي بالكتمان وأنا أهمس في غبطة، الله الله، غير أن الرسامة سمعت همسي وشاهدت غبطتي، وانصرفت كأنها لم تسمع ولم تشاهد. في اليوم التالي لوصول النسخة الأولى، تذكرت أمي وأختي، تذكرت أصابع مها وعرقها، لكنني لم أنتظر النساء اللواتي أحببتهن ولم يحببني. وبعد برهة من الارتباك، قررت أن أحتفل وحدي، جمعت الدواوين التي وضعت فوق أغلفتها ورقة بيضاء غير شفّافة، لتكون ديواني القادم، وفرشتها على أرض الغرفة، ثم فردت جسمي فوقها، ووضعت تحت رأسي نشيد الأنشاد وسفر الجامعة، وتمنيت أن أنام وأرى في أحلامي طيش المرأة التي تشبه شهيق البحر وزفيره، واستغرقت في النوم، هكذا هكذا.
كتابي الأول | قبل الماء فوق الحافة