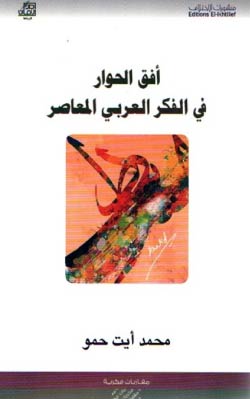لا يحدّد الباحث المغربي محمد آيت حمو معالم إشكاليته بنحو واضح في كتابه «أفق الحوار في الفكر العربي المعاصر» («الاختلاف»، 2012). منذ الفصل الأوّل، يجهد القارئ للإمساك بالأفكار الأساسية من دون أن يصل إلى مبتغاه. تفتقر معظم الطروحات التي عالجها المؤلف إلى عمود فقري جامع، لكن بعض الفصول تجيب عن الفرضيات التي انطلق منها صاحب «الدين والسياسة في فلسفة الفارابي». كثيرة المقاربات التي يجريها الكاتب، إذ يمكن وضعها تحت ثنائيات متشعّبة، مثل الإسلام والتحديث، الإسلام والعلمانية، الإسلام والآخر. منهجياً، لا يجري آيت حمو مقارنة جديّة بين النماذج الفكرية التي اختارها، كذلك يعتمد بنحو كثيف على منهجية التوثيق، فيبدو كتابه مدجّجاً بخلاصات قدّمها المفكرون العرب، الاصلاحيون منهم والحداثيون، مثل جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وابن رشد، وفرح انطون، ومحمد عابد الجابري، ومحمد أركون... من دون أن يقدّم مقاربته الخاصة، أو حتى يقارن بين النماذج التي درسها.
وقبل أن يعاين الكاتب المناظرات التي جرت بين المفكرين العرب، يشرّح لنا الأسباب التاريخية التي أدّت إلى تراجع التيار السلفي وعودته، مكتفياً بالبعد الايديولوجي، وليس بقراءة الظاهرة، وفق النظرية التي اجترحها أركون بشأن «سوسيولوجيا التقدُّم والتأخر». لا يكلّف نفسه عناء قراءة الأبعاد المجتمعية والثقافية في تفكيك العودات الدورية للفكر الديني/ السلفي، كما لو أنّ الصراع الحقيقي بين السلفيين والحداثيين يكمن في بناء النص، والرد المضاد عليه. وعلى هذا، يمكن تصنيف كتابه في خانة التوثيق لـ«صراع الأفكار»، وليس تفكيكها انطلاقاً من المناهج السوسيولوجية الحديثة.
يستحضر صاحب «ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف» آراء عدد من المفكرين العرب الذين تطرقوا إلى إشكالية الإشكاليات، أي الإسلام والعلمانية، ومن بينهم حسن حنفي، ومحمد عمارة، ومحمد عابد الجابري... وهؤلاء رأوا أن العلمانية في الإسلام لا يمكن درسها من الزاوية الأوروبية. ومن بين الخلاصات التي يستشهد بها الكاتب، ما خرج به عمارة في كتابه «التراث في ضوء العقل»، حين قال بأنّ «العداء بين العلم والدين خاصية كاثوليكية ـــ أوروبية». تناسى بذلك المعارك التي خيضت عبر التاريخ الإسلامي المديد، بين الاتجاه العقلاني والاتجاه التكفيري، ما يعني أنّ هذه الظاهرة ليست ذات جذور غربية، بل هي معركة مستديمة بين الدين والعلم، سواء على الجبهة الغربية أو العربية.
وربما يساعدنا كتاب الفيلسوف الفرنسي جان غيتون «الله والعلم»، في الردّ ولو جزئياً على آيت حمو، على اعتبار أنّ هذا التعارض المفترض بين الأديان والعلوم، ليس نتاج المسيحية الغربية، بل ظاهرة عامة. صحيح أنّ الإسلام على حدّ تعبير المستشرق الفرنسي هنري لاووست «علماني في جوهره»، لكن النص القرآني لا يجيب عن تساؤلات تاريخية معقّدة، وفي طليعتها طبيعة السلطة السياسية، وكيفية تداولها باستثناء «وأمرهم شورى بينهم»، ما أنتج على مر العصور ما يسميه المؤرخ الفرنسي دومينيك شفالييه «الديموقراطية القبلية».
يحاول الباحث المغربي تسليط الضوء على السجالات التي دارت بين بعض العلماء العرب، ومن بينها ردّ الإمام الإصلاحي محمد عبده على أطروحة فرح أنطون «ابن رشد وفلسفته». لن ندخل هنا في متاهات الدائرة المغلقة، حول الإسلام والعلمانية أو الاسلام والعلم. لكن ما يمكن نفيه هو أنّ الإسلام يفتقر إلى قاعدة جوهرانية٫ أي أنّه ليس ديناً ثابتاً، غير قابل للتغيير والتعديل بطبيعته... ذلك أن النص القرآني مفتوح على التأويلات والتأويلات المضادة أو ما يمكن أن نسميه القراءة الجاذبة والقراءة النابذة.
بعيداً عن الحوارات والمقابسات، ينتقد الكاتب تهافت «خطاب الضحية»، وتهافت خطاب «نهاية التاريخ»، فيدعو إلى التخلي عن نظرية المؤامرة، ويطالب بالتشريح السوسيولوجي لجدلية التأخر والتقدم في العالم العربي، أي الكفّ عن ربط التراجع الحضاري العربي بالعوامل الخارجية. ويقارع آيت حمو النظرية التي خرج بها فرانسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ ـــ نهاية التاريخ فكرة نادى الفيلسوف الألماني هيغل والعبارة بحذافيرها ترجع إلى الكسندر كوجيف الذي فسر هيغل قبل أن يلتقفها فوكوياما. هكذا، اعتبر أنّ التاريخ «قائم على الجديد»، وأن النظام العالمي الذي تبلور بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وسقوط جدار برلين، لا يعني أن هناك أزمة في «البدائل الممكنة». لكنّ صحوة الهويات أيضاً، تشكّل ردّاً على العولمة، باعتبارها الوجه الثاني لليبرالية الجديدة. وهذه النقطة لا يدرسها الكاتب بالشكل المطلوب، بل يكتفي بنقل النظريات التي خلص إليها مطاع الصفدي، وسعيد بنسعيد العلوي، وبرهان غليون. فلا يشرح لنا وجهة نظره حول التعددية القطبية، وإمكانية نهوضها بوجه الأحادية الأميركية. إذ يدرج تحليله لنظرية «نهاية التاريخ» في سياق الفلسفة البراغماتية الأميركية فقط.
يحتلّ مفهوم «الآخر» حيزاً كبيراً في الأفكار التي تطرّق إليها الكاتب، ويدعو إلى فتح الحوار مع «الآخر الغربي» على قاعدة التثاقف والتمايز، وليس الإثقاف المرتكز على قوّة الإعلام والتكنولوجيا، ويستشهد بخلاصة سعيد بنسعيد العلوي الذي ينتقد كل «أفكار القطيعة مع العالم». لكن ثمّة إشكاليّة أساسيّة غابت عنه: ماذا عن الحوار في التجربة الإسلامية؟ بإيجاز شديد يجيب الكاتب ولا يصل بأفكارها إلى نهايتها.
يرصد آيت حمو إرهاصات الحداثة في العالم العربي التي تتأرجح بين الأصالة والمعاصرة، والسلفية والاصلاح، والماضوية والتحديث. ويستعين مجدّداً بأركون الذي فنَّد أسباب هيمنة الخطاب الأصولي المتشدّد، «مميزاً بين الأسباب الداخلية والخارجية». وفي هذا السياق يوظّف المصطلح الأركوني «الحداثة البدائية الأولية»، للإشارة إلى أن التراث العربي/ الإسلامي «مليء بحلقات حداثية... تساعدنا على تبيئة الحداثة في تربتنا وواقعنا». يبقى سؤال بديهي في هذا السياق: هل تطورت الحداثة نفسها بمعزل عن النظام الرأسمالي؟
ثلاث نقاط أساسية يمكن تسجيلها على محمد آيت حمو: سطوة منهجية التوثيق عبر رصد الأفكار والنماذج المدروسة من دون المقارنة بينها، والاكتفاء بتعقُّب ما تقدَّم به الآخرون من دون الخروج بنتائج أولية للبناء عليها... إضافةً إلى عمومية الأفكار المطروحة، وغياب القدرة على ضبطها. كل هذه النقاط وغيرها أضعفت الكتاب، وجعلته مقالة دفاعية عن الإسلام، بصرف النظر عن الإجحاف الذي تعرّض له من منتقديه.
السلفيّة والحداثة: قراءة «توثيقيّة» للصراع