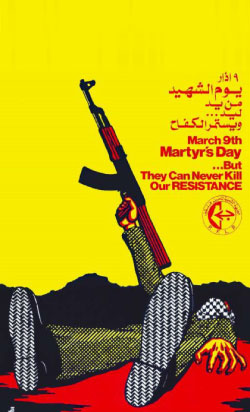قررت المقاومة لاحقاً ملء الفراغ السينمائي بتمويل ذاتي أو عبر المؤسسات الصديقة أو الداعمة مع إدراك أهمية هذه الأداة في الصراع والذاكرة الحديثة. وبعدما أضافت المواجهة الإعلامية، والتكنولوجية والإلكترونية إلى المواجهة العسكرية، حان دور السينما.
لذا منذ سنوات، انطلقت حركة سينمائية لتصوير حالة المقاومة في الجنوب وتثبيتها ثقافياً وتاريخياً من خلال الشاشة الكبيرة. ولـ«رسالات» (الجمعية اللبنانية للفنون) حصة كبيرة من تلك الإنتاجات كما للمخرج عادل سرحان صاحب فيلم «خلّة وردة» (2011) أكثر من عمل مع المؤسسة المذكورة، مثل «أفلام رصاص» العبارة عن ثلاثة أفلام قصيرة «أبيض وأسود» و«جميلة» و«الصخرة». وهناك أمثال أخرى كفيلم «أهل الوفا» (2009) للمخرج السوري نجدت أنزور وبطولة عمار شلق، و«حبل كالوريد» (2012) للمخرج الإيراني مسعود أطيابي وبطولة جورج شلهوب.
ظلّت أفلام مثل «معركة»
لروجيه عساف و«كفر قاسم»
لبرهان علوية الأكثر تأثيراً
تاريخياً، أحسن اللوبي الصهيوني استثمار الفن السابع وعرف أهميته بوصفه أداة حرب. نجح في تسويق وجهة نظره في الصراع بذكاء في أفلام كـ «ليبانون» (2009) لصموئيل ماعوز، و«فالس مع بشير» (2008) لآري فولمان و«ميونخ» (2005) لستيفن سبيلبرغ وغيرها. حصدت هذه الأفلام جوائز عدة، بالإضافة إلى إثارتها الجدال واهتماماً إعلامياً وجماهيرياً من المقاطعين والمؤيدين.
في المقابل، يطرح سؤال: لِمَ لمْ تنجح أفلام المقاومة في عصرها الإسلامي في تخطي الجمهور المحلي الضيّق من اللون السياسي الواحد؟ ولماذا لم تستطع إيصال صورة أبعد من الحدود عن حقيقة الصراع بعين مَن يواجه احتلال؟ ولماذا بقيت أعمال سينمائية قديمة، معنيّة بالقضية نفسها، وإن لم تُعرض كثيراً، حاضرة ومعبّرة أكثر، وهي ثابتة في الذاكرة السينمائية؟ نذكر مثلاً «معركة» (1985) لروجيه عساف الذي حكى بلسان الحكواتي رفيق علي أحمد مواجهات القرى الجنوبية مع الاحتلال وصمود أهلها ومعاناة مهجريها في بنية مسرحية داخل مشاهد حيّة، أو «كفر قاسم» (1974) لبرهان علوية الذي روى مجزرة ارتكبها الإسرائيليون ببرودة، معيداً تركيب الأحداث كما حصلت من دون مبالغات ولا بطولات ومن دون تضمين السيناريو أي مواقف شاعرية أو خطابية. أضاءت هذه الأفلام على المعاناة الإنسانية الناتجة من الاحتلال في ظل الكفاح المسلّح، كما هي الحال بالنسبة إلى فيلم «المخدوعون» (1972) لتوفيق صالح عن رواية غسان كنفاني «رجال في الشمس» الذي لا يزال يحلّ ضيفاً على المهرجانات العربية والدولية. ولا داعي للحديث عن الأثر الكبير الذي تتركه أعمال المخرجين الفلسطينيين المعاصرين أمثال إيليا سليمان وآن ماري الجسر وهاني أبو أسعد وشيرين دعيبس وغيرهم عن يوميات فلسطين تحت الاحتلال بكل تفاصيلها.
في هذا السياق، لم تحقق أضخم الإنتاجات التي وثّقت حقبة المقاومة الإسلامية في لبنان، أي فيلم «33 يوم» (الأخبار 20/4/2012) للمخرج الإيراني هشام شورجة أي فارق فني أو نجاح يذكر، ولا حتى على مستوى الحدث الذي يُراد توثيقه في الشريط. اللغة والأسلوب لا يخدمان هذه الأعمال، ونقل الدراما اللبنانية الضعيفة في السيناريو والأداء والبنية إلى الشاشة الكبيرة، خطأ ظهر في أكثر تجربة سينمائية محلّية، كان يمكن تفاديه من قبل القائمين على سينما المقاومة، إلا إن كان الهدف هو استدراج شعبية وجوه الدراما المعروفة. المبالغة في تصميم المشاهد وأداء الممثلين والدعاية لا تخدم الرواية الحقيقية. خطأ وقعت فيه أعمال عن المقاومة مع انطلاق الحركة الفدائية بعد النكسة، وراجت خصوصاً عام 1969 منها «كلنا فدائيون» لكاري كرابتيان و«فداكي يا فلسطين» لأنطوان ريمي و«الفلسطيني الثائر» لرضا ميسّر... أفلام خدمت الموجة الجماهيرية المتعطشة للأعمال البوليسية والأكشن الرائجة آنذاك أكثر ممّا خدمت القضية. مثلاً لا فرق بين تلك المشاهد التي يرتمي فيها عشرات الجنود الإسرائيليين يميناً ويساراً أمام رصاصات المقاوم التي لا تنضب، أكان لعب دور المقاوم غسان مطر في 1969 أم باسم مغنية عام 2012.
كذلك تحظى مشاهد المواجهات القتالية باهتمام أكثر من المشاهد التي يكون أبطالها الناس العاديون الصامدون، أصحاب قصص المعاناة والمواجهة اليومية مع الاحتلال في القرى.
وأخيراً هناك الرسائل الدينية الموجهة من خلال تلك الأفلام وتحملها في خطابها وفي عنوانها الواضح «النصر الإلهي». قد تخسر العقيدة من وهجها في حال جرى التعبير عنها بكليشيهات سينمائية أو في حال تخطّيها منطق المتلقّي، خصوصاً المُشاهد الذي تريده المقاومة داعماً ومسانداً من خارج بيئتها. يتمثل ذلك مثلاً في نزول نور من السماء (وهو ضوء اصطناعي) على وجه الشهيد لحظة استشهاده كما يحصل مع باسم مغنية في «33 يوم»، أو في سرد فيلم «طيف اللقاء» (2010) لحسن عبد الله (إنتاج قناة «المنار»)، واقعة أن يلتقي أحد المقاومين الذي ضلّ طريقه بمقاوم عن طريق الصدفة ليرشده الى طريق العودة، فيكتشف حين يلتقي بإخوانه أنّ من أرشده هو شهيد في صفوف المقاومة. أيضاً هناك مشهد من فيلم «أهل الوفا» (2011) حين يقود فلاح جنوبي آليته متستراً على 9 مقاتلين من المقاومة الإسلامية في مستوعب المياه الخلفي. تتوقف الآلية عند الحاجز، يصعد الجندي الإسرائيلي الى الآلية ويلقي نظرة داخل المستوعب، يظهر صوت من لا مكان مردداً الآية «وإنّا أغشيناهم، فهم لا يبصرون» ويتابع الفلاح والمقاومون الرحلة بأمان.