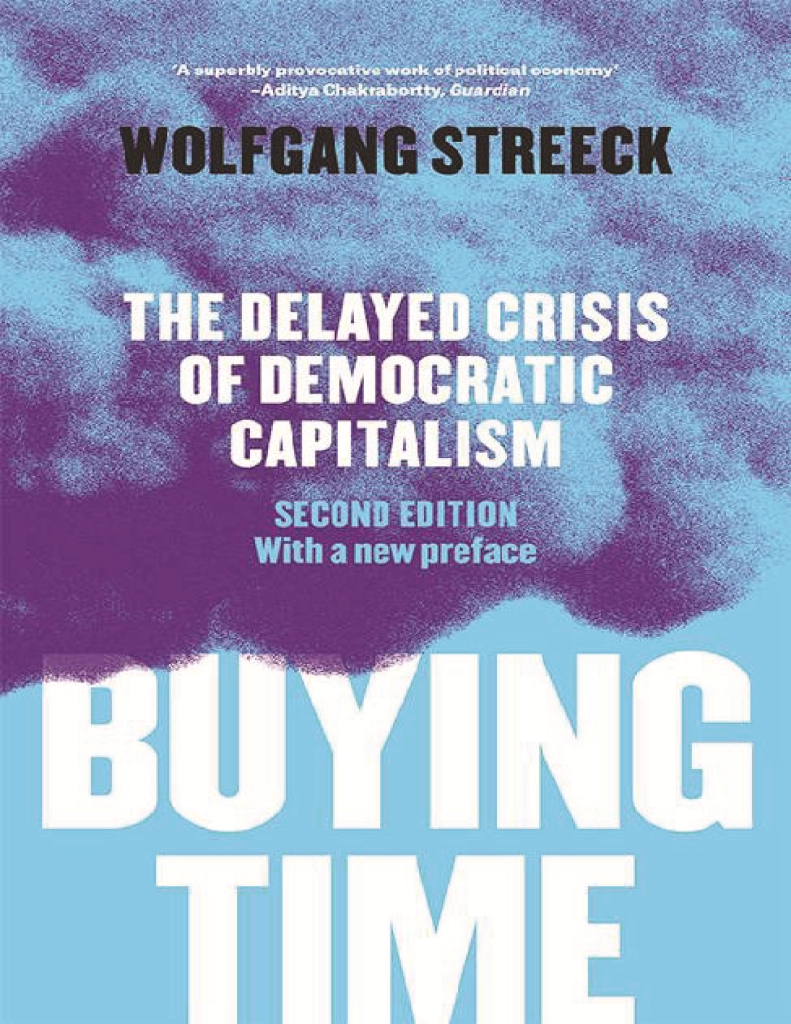
في نظرة على الماضي، يتبيّن أنه لم يعد هناك أي مجال للجدال في أن السبعينيات كانت نقطة تحول: شهدت هذه الفترة نهاية عملية إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية. والانهيار الأولي للنظام النقدي الدولي، الذي كان نظاماً سياسياً عالمياً لرأسمالية ما بعد الحرب. وعودة شبه الأزمات الاقتصادية، وانقطاعات النشاط الاقتصادي كخطوات في مسار التطور الرأسمالي. في ذلك الوقت، كان علماء الاجتماع في فرنكفورت، الذين استوحوا من الماركسية، بطرق مختلفة، في وضع أفضل من غيرهم للاطلاع، بشكل حدسي، على الدراما السياسية والاقتصادية في حينه. ومع ذلك، فإن محاولاتهم لفهم التشوّهات في ذلك الوقت - من موجات الإضراب في عام 1968 إلى أول ما يسمى بأزمة النفط - ضمن السياق التاريخي الأوسع للتطوّر الرأسمالي الحديث، سرعان ما تم نسيانها. حدثت أشياء كثيرة مفاجئة. حاولت نظرية «الرأسمالية المتأخرة» إعادة تعريف التوترات والتصدعات في الاقتصاد السياسي في ذلك الوقت. لكن التطورات التي لحقت النظرية استعصت على الإدراك النظري.
التخلّي عن جزء من إرث ماركس
يبدو أن إحدى مشاكل نظرية «الرأسمالية المتأخرة» كانت تتمثّل في أنها توجهت لتوصيف «السنوات الذهبية» لرأسمالية ما بعد الحرب على أنها فترة إدارة تكنوقراطية مشتركة بين الحكومات والشركات الكبرى. وأن هذه الشراكة تأسست للحفاظ على نموّ مستقرّ، والقضاء على الأزمة البنيوية في نهاية المطاف. لكن ما بدا أساسياً بالنسبة لأصحاب النظرية، كان يتعلق بشرعية الرأسمالية الحديثة الاجتماعية والثقافية، وليس الشرعية التقنية. ما فعله هؤلاء هو التقليل من أهمية رأس المال كفاعل سياسي وقوة اجتماعية استراتيجية، بينما بالغوا في الوقت نفسه في تقدير قوّة سياسة الحكومة على التخطيط والعمل، بالتالي استبدلوا النظرية الاقتصادية بنظريات الدولة والديموقراطية. كانت العقوبة التي دفعوها هي التخلي عن جزء أساسي من إرث ماركس.
كانت «نظرية الأزمة» في فترة عام 1968 غير مهيأة جزئياً أو كلياً لثلاثة تطورات رئيسية؛
- التطور الأول، هو أن الرأسمالية سرعان ما بدأت، بنجاح مذهل، في التحوّل إلى «الأسواق المنظمة ذاتياً»، في سياق السعي النيوليبرالي لإحياء ديناميكية التراكم الرأسمالي من خلال إلغاء القيود والخصخصة وتوسيع الأسواق.
- التطوّر الثاني أتى عكس التنبؤات بأزمة الشرعية. فقد شهدت السبعينيات قبولاً ثقافياً عالياً وسريع الانتشار لأساليب الحياة المعدّلة والموجّهة للتعايش مع فكرة السوق، وهذا الأمر عبّر عنه طلب النساء للعمل المأجور «المغترب» (بحسب تعبير ماركس الذي يقصد فيه العمل فقط بغرض سد الفجوة المادية، ويصف أنه في هذه الحالة ينخفض البشر إلى مستوى الحيوانات) وفي نموّ المجتمع الاستهلاكي الذي تخطى التوقعات.
- التطور الثالث يتعلق بالأزمات الاقتصادية المصاحبة للتحوّل من رأسمالية ما بعد الحرب إلى الرأسمالية النيوليبرالية (بخاصة أزمة التضخم في السبعينيات وأزمة الدين العام في الثمانينيات) والتي بقيت هامشية تماماً بالنسبة لـ«نظرية أزمة الشرعية» - على عكس التفسيرات المستوحاة من دوركهايم للتضخّم باعتباره التعبير عن الشذوذ الناتج من الصراع التوزيعي، أو تفسيرات جيمس أوكونور، الذي توقع في أواخر الستينيات «أزمة مالية للدولة» يليها تحالف اشتراكي ثوري للموظفين العموميين النقابيين وعملائهم من فائض السكان المهملين.
ولا جماعي للاستهلاك
أود أن أقترح سرداً تاريخياً للتطوّر الرأسمالي منذ السبعينيات. هذا السرد يربط ما أعتُبر ثورة رأس المال ضد الاقتصاد المختلط بعد الحرب العالمية الثانية، مع الشعبية الواسعة لتوسيع أسواق العمالة والسلع الاستهلاكية بعد نهاية السبعينيات، ومع سلسلة من ظواهر الأزمات الاقتصادية منذ ذلك الحين وحتى اليوم (التي بلغت ذروتها في أزمة ثلاثية للبنوك والمالية العامة والنمو الاقتصادي).
أرى «إطلاق العنان» للرأسمالية العالمية في الثلث الأخير من القرن العشرين كنوع من المقاومة الناجحة من جانب أصحاب رأس المال ضدّ القيود المتعدّدة التي اضطرت رأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية أن تتحملها حتى تصبح مقبولة سياسياً مرة أخرى في ظل منافسة الأنظمة. يمكن تفسير نجاح هذه المقاومة، وإعادة التنشيط غير المتوقعة للنظام الرأسمالي كاقتصاد سوق، من خلال الإشارة من بين أمور عدّة، إلى السياسات الحكومية التي وفّرت الوقت للنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قائماً في ذلك الوقت.
قد تكون التقنيات المختلفة لإدارة الطبقة المسحوقة، والتي تم تطويرها واختبارها في الولايات المتحدة، قابلة للتصدير أيضاً إلى أوروبا
لقد حققوا ذلك من خلال توليد ولاء جماعي للمشروع الاجتماعي النيوليبرالي الذي يرتدي زي المشروع الاستهلاكي. أولاً، من خلال تضخّم المعروض النقدي، ثم من خلال تراكم الدين العام، وأخيراً من خلال القروض السخيّة للأسر، وهو أمر لم تكن نظرية الرأسمالية المتأخّرة لتتخيله. صحيح أنه بعد فترة من الزمن، أَحرَقت كل من هذه الاستراتيجيات نفسها بطرق وردت في «نظرية الأزمة» النيوماركسية لجهة تقويض أداء الاقتصاد الرأسمالي. لذا، ظهرت مشاكل شرعية النظام الرأسمالي مراراً وتكراراً، ولكن ليس بين الجماهير بل بين رأس المال نفسه. وقد أتت هذه المشاكل على شكل أزمات تراكم الثروة، والتي بدورها شكّلت مخاطر على إضفاء الشرعية على النظام من قبل سكانه المتمكنين ديموقراطياً. هذه الأزمات لم يكن بالإمكان التغلب عليها إلا من خلال استمرار التحرير الاقتصادي، وذلك لاستعادة ثقة «الأسواق» في النظام.
توتّر بين الرأسمالية والديموقراطية
يأتي تاريخ أزمات الرأسمالية المتأخرة منذ السبعينيات كأنه يكشف عن التوتّر الأساسي القديم بين الرأسمالية والديموقراطية. هي كانت عملية تدريجية أدّت إلى تفكك الزواج القسري الذي تم ترتيبه بين الاثنين بعد الحرب العالمية الثانية. وبقدر ما تحولت مشاكل إضفاء الشرعية على الرأسمالية الديموقراطية، إلى مشاكل تراكمية، فإن معالجتها انطلقت من الدعوة إلى التحرير التدريجي للاقتصاد الرأسمالي، من التدخّل الديموقراطي. هكذا، تحولت عملية تأمين قاعدة جماهيرية للرأسمالية الحديثة من المجال السياسي إلى السوق الذي يُفهم بأنه آلية لإنتاج الجشع والخوف. جاء ذلك، في سياق زيادة عزل الاقتصاد عن الديموقراطية الجماهيرية. هذا تحول للنظام المؤسسي السياسي والاقتصادي الكينزي لرأسمالية ما بعد الحرب، إلى نظام اقتصادي هايكاني جديد.
في الخلاصة، يظهر أنه بعكس السبعينيات، قد نكون الآن قريبين من نهاية التكوين السياسي والاقتصادي لما بعد الحرب. وهي نهاية، وإن كانت بطريقة مختلفة، تم التنبؤ بها من قبل «نظريات الأزمة» الخاصة بالرأسمالية المتأخرة. ما أشعر به هو أن الديموقراطية كما عرفناها تعيش آخر أيامها، بل إنها على وشك أن تتحوّل إلى ديموقراطية شاملة تهدف إلى إعادة توزيع الثروة، كما أنها على وشك أن تتحول إلى مزيج من حكم القانون والرفاهية العامة. لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ عام 2008 في هذا الفصل بين الديموقراطية والرأسمالية من خلال فصل الاقتصاد عن الديموقراطية، أو عملية نزع الديموقراطية من الرأسمالية من خلال إلغاء ديموقراطية الاقتصاد. وقد حدث هذا الأمر في أوروبا تماماً كما في أي مكان آخر.
الرأسمالية في نهاياتها؟
يجب أن يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الرأسمالية تعيش آخر أيامها أيضاً. من الواضح أن توقعات تحوّل الديموقراطية في ظل النيوليبرالية، بهدف الاكتفاء بعدالة الأسواق، لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع الرأسمالية. لكن، على رغم كل الجهود المبذولة لإعادة التثقيف، فإن التوقعات المنتشرة للعدالة الاجتماعية التي لا تزال موجودة عند فئات عدة من السكان، قد تقاوم التوجّه نحو ديموقراطية السوق الحرّة. بل إنها توفر حافزاً لحركات الاحتجاج الأناركية. تم بالفعل النظر في مثل هذا الاحتمال مراراً وتكراراً في «نظريات الأزمة» القديمة. ومع ذلك، ليس من الواضح أن الاحتجاجات من هذا النوع تشكل تهديداً للدول الغربية الرأسمالية. وقد تكون التقنيات المختلفة لإدارة الطبقة المسحوقة، والتي تم تطويرها واختبارها في الولايات المتحدة، قابلة للتصدير أيضاً إلى أوروبا. ومن ثم، قد يكون السؤال الأكثر أهمية هو إذا كان لا بد من التخلي عن الحيل النقدية، مع آثارها الجانبية الخطيرة المحتملة، في مرحلة ما، فهل ستكون هناك «عقاقير نمو» أخرى متاحة للإبقاء على تراكم رأس المال قيد التنفيذ في البلدان الغنية في العالم؟


