في إحدى المرات، جمعتنا "سودة"، جدتي، في دار سيدي، لتخبرنا أنها قررت الرحيل عنا الى الأبد.
أذكر يومها أنني سمعت صراخ جدتي سودة وقد وقفت على حافة الدرج تردح لنا: "ولي انتي وياها وياه، هيك بتعملوا فيني؟ والله لأفرجيكو". ركضت صوب الدرج ومددت رأسي قليلاً لأسترق النظر إليها، فلمحتني وانهالت عليّ بالشتائم: "ولك يا مقصوفة الرقبة عم تتنقوزي عليّ؟ انزلي لتحت إنت وخواتك وولاد عمك إسا".
التفتّ الى الوراء فرأيت كل إخوتي وأولاد عمي يقفون بصمت ويتنصتون على ما تقوله سودة ليعرفوا ماذا سيحل بنا!
سألتنا حنان، أختي الكبرى "عن شو عم تحكي ستي؟ يلا قرّوا (اعترفوا) مين فيكو عامل شي هالمرة؟ وما تقولوا ولا شي، اسا ستي بتحكي لأبوي وعمي ومنوكل قتلة كلنا". نظرنا الى بعضنا البعض؛ لم يظهر على وجه أحد منا ما يوحي بإشارة أو تلميح أو تباشير لأي إجابة، أو حتى إدراك عما تتحدث عنه جدتي وأغضبها الى هذا الحد. وقفت سلوى، أكبر أولاد عمي وأكثرنا جرأة، وسألت مرة أخرى:" احكوا شو عاملين عند سودة وإلا لأقول لأمي تحرمكو من المصروف لأسبوع متل هديك المرة". مجدداً، لم يكن لدى أي منا شيء ليقوله.
عادت جدتي لتنادي علينا من جديد "ولي يا ماليت الجدرة منك اإلها (؟؟) انزلي يقصف عمركو، انزلوا احسن ما اطلعلكو لفوق". أذكر خفقان قلبي خوفاً مما كان يحدث وقتذاك، وللحقيقة، كنا جميعنا خائفين. خفت ان أكون قد فعلت شيئاً أغضبها فبدأت أسترجع كل ما فعلته في الأيام الماضية :"بركي على شان فتت بالحفاية على المطبخ؟ لأ، صرخت عليّ بوقتها... طيب بركي على شان أخدت فستق من جارور جدي؟ لأ، ما جدي ما بيحكي مع ستي...".
وقفنا في صف واحد كالمساجين ونزلنا إليها على الدرج، وما إن رأتنا حتى أوقفتنا وظهورنا ملاصقة للحائط: اثنا عشر حفيداً تتراوح أعمارنا بين 4 و11 عاماً. ثم خلعت "شحاطتها" وحملتها بيدها اليمنى وأخذت تتمشى أمامنا وهي تسأل: "هاتوا لأشوف يلا، مين اللي حرق الشراشف؟ يلا ليش ساكتين؟ ما بدكو تقولوا؟".
لم أكن أنا من فعل ذلك. انتظرت لأسمع من سيعترف بفعلته، ولكن عندما لم يجب أحد، بدأنا بالبكاء جميعنا علّها تشفق علينا ولا تخبر أبي وعمي، فأسكتتنا قالت:" انا قلبي مليان منكو كلكو، ساعة بتدعوسوا ع البلاط، وساعة بتكسرولي الكبايات، وساعة بتنطوا بالدار زي المجانين ما بتعودوا تهدوا. رح أقول لأبوكو انو أنا خلص قررت أسافر. رح أتركوا هون بالمخيم وأهج ع الدنمارك"!
صحيح أننا كنا نبكي خوفاً من العقاب الذي سيحل علينا، وصحيح أن سودة كانت قاسية معنا وغير لطيفة أبداً، لكننا اعتدنا على وجودها الدائم عندما نستيقظ كل صباح لنلعب أمام البيت، فتقف على شباك المطبخ وترشنا بالماء لنخفض صوتنا. كما أننا اعتدنا على السهر عندها بجانب كانون الفحم في الليالي الباردة حتى تصبح الساعة العاشرة فينظر إلينا والدي ويقول: "يلا اسحبوا لفوق"، فنقف صفاً واحداً من الأكبر للأصغر ونصعد الدرج ونحن نتمتم بأننا لم ننعس بعد، وأن غداً يوم عطلة فيسمعنا أبي ويصرخ:"اسحبوا"!! أي اطلعوا ع السكت وبدون احتجاج.
كل تلك الذكريات مرت سريعاً أمامي أنا التي حصلت على أكبر حصة من لطف سودة أيام كانت تروي لي حكاية العنزة والتيس، وتسمح لي بالنوم في غرفتها بعد عراك مع والدي. فبكيت أكثر وأخذنا نترجاها أن لا تتركنا وترحل، وإن كانت سترحل، فلتأخذنا معها! لكنها أصرت على موقفها وطردتنا من الدار. في مساء ذلك اليوم همست أختي في أذني "بقولك على سر بس احلفي بحياة سيدي ما بتقولي لحدا"؟ أومأت إيجاباً فتابعت:" أصلاً ستي مش رح تروح ع الدانمارك و ما رح تتركنا"!
قاطعتها مستغربة: "شو عرفك، مين قالك هيك؟ ما هي رح تفسد علينا انو حرقنالها الشراشف". أجابتي حنان مستهزئة: ولي يا هبلة أي شراشف؟ أصلاً أمي قالت لأبوي انو ما في شي محروق، هاي ستي عملت هيك قصداً على شان عمك يبعتلها تسافر لعنده. بس جدي ما خلاها!"
حكايات ستي | مين حرق الشراشف؟
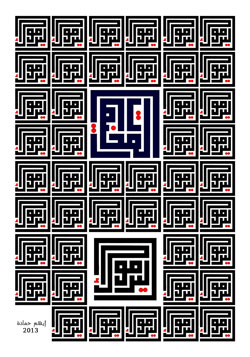
للفنان الفلسطيني ايهم حمادة


