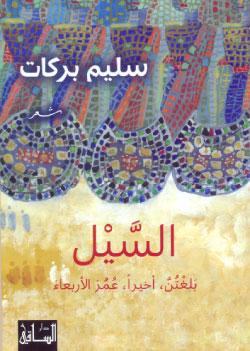على غرار «الجمهرات» (1979) و«الكراكي» (1981)، يكتب سليم بركات في «السَّيل/ بلغتُنَّ أخيراً عمر الأربعاء» (دار الساقي) مطوَّلة شعرية جديدة، لكن بضراوة لغوية أقل. لا يزال الشاعر يكتب بتلك النبرة التي لا يدين لأحدٍ بها، إلا أنه تخفف من العنف المتحصل من احتكاك الكلمات والاستعارات، لصالح جملة تتمهّل في إيصال معانيها إلى القارئ. يقترح صاحب «طيش الياقوت» وجهة نظر شعرية حول فكرة الأنوثة من دون أن يكترث بتحويل هذه الوجهة إلى ممارسة تأريخية.
الكتابة محصورة بالمعجم، والشاعر رسول الكلمات إلى جمهرة نسائه اللواتي يتهادين على وقع مفرداته في سعيهنّ إلى «عمر الأربعاء» بحسب العنوان الفرعي للقصيدة. ليس واضحاً ما إذا كان الأربعاء كنايةً عن يوم واحد أو عقدٍ من السنوات. لا نعرف إذا كان الشاعر يأخذ النساء إلى النضج أم إلى اليأس. لكن فكرة الزمن في الحالتين تذوب باستمرار داخل حشود الصور والاشتقاقات التي لطالما برع سليم بركات في ابتكارها وإدهاشنا بها.
القصيدة أشبه برحلة أو نشيدٍ بلاغيٍّ طويل. إنها لعبة بين الشاعر ومخيلته، بينما فكرة الأنوثة تتوثّق ببلاغةٍ فاخرةٍ ومتمادية (قد) لا تجد قارئاتٌ معاصرات أنفسهن فيها. إنها لغةٌ اعتبارية مرفوعة إلى فكرة اعتبارية لا إلى امرأة واحدة تستطيع إرغام اللغة على إبداء بعض التواضع البلاغي. هكذا، لا يجد القارئ حرجاً في تجاهل حركة المعنى، والاستسلام لحركة اللغة والتلذذ بمهارة هذا الشاعر الكردي في تطويع العربية كما لو أنها أكثر من لغته الأم.
«ها بلغتنّ عمر الثلاثاء/ فلا ترتديْنَ للأربعاء ثياباً تُغيظُ الخميس/ بل تَحرَّيْنَ، ككلِّ جرحٍ سويٍّ، رائقٍ ومُمتدَحٍ/ ما يتحرّى المحققون من برهان الموت/ تحرَّين ما تتحرّى السماء من مزاعم الملحِ عن السُّكر المنتحر/ لكن لن تحتفظنَ بمرآةٍ بعد الآن». بهذا النفس النشيدي، يفتتح الشاعر قصيدته، فنتأكد أن علينا أن ندع جانباً طريقتنا المعتادة في القراءة، وأن نقطع الأمل في التقاط أنفاسنا إلا مع نهاية التدفق الشعري المتصاعد الذي يدفع نساء القصيدة إلى الجرف الأخير للسَّيل. هناك، يخطب الشاعر في جموعهن: «بلغتُنَّ عمر الأربعاء يا طريحاتِ العافية. بلغتُنّ المفتوح على مغلقٍ. بلغتنّ المغلق على مفتوحٍ، بأقدامكنّ الصغيرة أقدامِ الكتب الصغيرة (...) بلغتنَّ عمر الحياةِ ماشيةً على أصابعها. أيربكُكنَّ ذلك؟ (...) لقد بلغ السَّيل عمركنّ، وبلغتنَّ أخيراً عمر الأربعاء».
بين المفتتح والختام، يقلِّب صاحب «ترجمة البازلت» نساءه على صفحات معجمه الفاتن، ويجرجرهن من استعارة إلى أخرى. النساء «كدمةٌ تحت عين الفكرة»، وجميلاتٌ «كحقّ البرتقالة في منصب الموز»، ويمضغنَ «ما طُحِن من الصيف عَلَفاً لغزالة الخريف»، وينفضْنَ «النصف المطحون من قمر الغد عن أكتاف معاطفهنّ».
إلى جوار هذه النسويات، نقرأ استعاراتٍ مماثلة عن «سماءٍ ملتزمة بفتورها»، و«شمسٍ محبطة من بقائها شمساً كلما أفاقت»، وعن «سنبلةٍ واحدةٍ لها لسان الحقول كلها». القصد أن الشاعر لا يترك فجواتٍ بلاغية، لا في سيرة نسائه ولا في الفضاء السردي الذي يحتضن رحلتهن. إنهن حاضراتٌ بضمير المخاطب والغائب، بينما تتناهى إلينا براعة بركات الهائلة في ترويض نون النسوة التي تتكرر مئات المرات، مثقلةً بالشدَّة أو مكتفيةً بعلامة الفتحة، من دون أن ترهق القارئ أو ترهِّل النص نفسه. يمرِّغ الشاعر نساءه الغفيرات في مخيلته، ويستثمر حضورهن في زحزحة المعاني القابعة خلف المفردات.
هكذا، يصبح موضوع القصيدة جزءاً من نبرة صاحبها، فنقرأ صوراً تخدم السياق العام، ولكنها تتباهى بكونها ترجمةً أو تأويلاً لفنٍّ شخصي أيضاً. كأن الشاعر يرفع السرية الشعرية عن جانب من ورشته المعجمية، ويدعونا إلى معاينة المكونات والعناصر الأولية التي تُدفن في طيات القصيدة. هكذا، نقرأ عن «ابتزاز الكلمات للمعاني، وابتزاز المعاني للكلمات»، وعن «متاعب الورقة من شغب السطر الثاني»، وعن «خيالٍ يتدحرجُ كزرٍّ مقطوع». بهذا المعنى، تحدث الرحلة كلها في معجم الشاعر الذي لطالما «فُتن بمثاله، وفُتن بكماله»، كما وصفه عباس بيضون.
الواقع أن هذا الوصف يسري على تجربة بركات كلها تقريباً. إلى جانب ممارسات أساسية لها علاقة بالسيرة الشخصية والهوية الكردية، تبدو تجربة الشاعر الذي يقف على حدة في المشهد الشعري أشبه بمجاراةٍ مستمرة للذات. حدث ذلك في الشعر أولاً، ثم في الرواية. صحيح أن هذه الفرادة خسَّرته شرائح واسعة من القراء، إلا أنه لم يساوم يوماً على خياراته اللغوية، مفضلاً أن يربح مزاجه ومزاج الأقلية التي تقاسمه الاستمتاع بخصوصية تلك العوالم التي دفعت أدونيس إلى القول بأن «اللغة العربية في جيب هذا الشاعر الكردي».
«السيل» هي ذريعة جديدة كي يستأنف صاحب «فقهاء الظلام» مكْره اللغوي وحِيَله البلاغية الفاتنة. الشاعر الذي اهتدى منذ بدايته إلى نبرة جامحة ومتفلتة من شروط اللغة الآمنة، يواصل مباغتتنا برحابة مخيلته وصورها الأخاذة التي تتقافز أمامنا كلما «نطقَ اللسانُ، خطأً، بما لوَّعَ اللسان».
نطقَ سليم بركات بما لوَّعَ اللسان