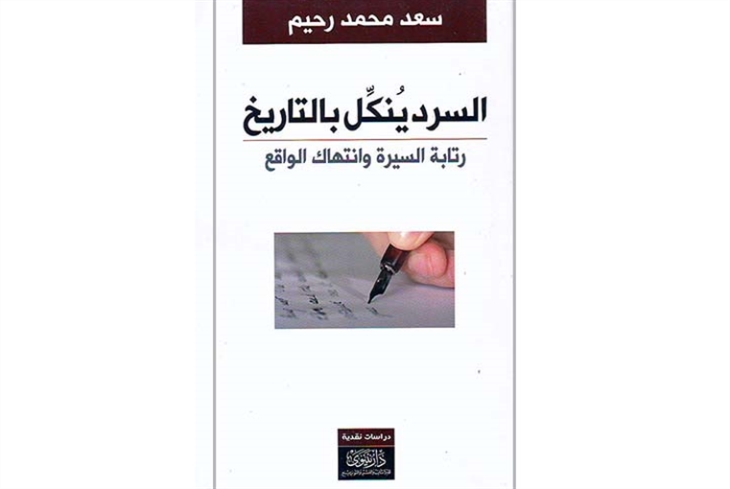حضور المكان في الرواية العراقية بعد حقبة الاستبداد
وهو ما يشير إليه سعد محمد رحيم في «السرد مشكِّكاً بالتاريخ» بفضح «أضاليل التاريخ ومناورات الروائي». فوثيقة ما قد تغيّر منظومة الأرشيف القديم، كما في بعض روايات أمبرتو إيكو وصنع الله إبراهيم وعبد الرحمن منيف. حتى إن إسماعيل كادريه في روايته «الوحش» يشكّك بوجود حصان طروادة بكل ثقله الواقعي والرمزي، واضعاً افتراضات منطقية في سعيه لكشف «خديعة المؤرخ القديم وأضاليل التاريخ». إذ أن اختراعاً مثل هذا الحصان الخشبي الهائل، كان القصد منه إخفاء الفظائع والجرائم والمذابح «لا عن عيون عصرهم بل عن عيون العصور القادمة». وهو ما يفعله ساراماغو في روايته «تاريخ حصار لشبونة» باستنطاق التفاصيل وإعادة التاريخ المكتوب إلى غرفة التحقيق «يفككه ويفضح خفاياه، ويهتم بما هو إنساني وأرضي أكثر مما يهتم بما هو من حصة الميتا فيزيقيا». وفي المقابل، يتجنّب الانحياز الأيديولوجي متخذاً من التاريخ «طريدة» في محاولة للصيد وليس ما يصيد. ويتساءل الروائي والناقد العراقي: إلى أي مدى علينا أن نثق بما يقوله المؤرخون؟ وهل هناك قيمة للاعتذار أو الإصلاح بفوات الوقت؟ في فصلٍ آخر، يتناول «السرد والمكان»، مقتفياً أثر نجيب محفوظ في حفرياته السردية للقاهرة القديمة، وخشية روائيين آخرين من تعيين المكان الروائي للتعمية والتقيّة لعدم مواجهة واقعهم بجرأة، و«صناعة أمكنة مؤنسنة» على غرار طنجة محمد شكري، واسطنبول أورهان باموق، ودبلن جيمس جويس. ويلفت إلى حضور المكان في الرواية العراقية بعد احتضار حقبة الاستبداد، وانتعاش سرد الهوامش البيئية والهويات المغيّبة. على الضفة الأخرى للمكان، سنتعرّف إلى «سرديات المنفى» أو «أحابيل التاريخ في جسد الجغرافيا» كحصيلة لهجرة المثقف وعذابه بين «مكانين وثقافتين» وفقاً لمقولة إدوارد سعيد عن كتابة المنفى ومكابداته بين آليتي الذاكرة والنسيان. ذلك أن «عابر التخوم» ستشغله أسئلة الهوية في المقام الأول وستنبثق عنها سرديات «السيرة والمنفى والأوطان المتخيّلة» عبر التدوين السيري لتمثّل الهوية والوطن المتخيّل بجرعة نوستاليجية عالية تحيل إلى انتماء مهجّن ومختلق. وهو ما نجده أيضاً في مشاغل الكتّاب الفرنكوفونيين إزاء خلخلة الهوية. ألم يقل مالك حداد يوماً «اللغة الفرنسية منفاي»؟ فيما تقول إيتل عدنان «لا يمكن أن نكون الشخص ذاته في الأماكن المختلفة». ويؤكد الروائي التركي نديم غورسيل الذي يقيم في باريس ويكتب بالتركية «وطني الحقيقي هو لغتي». لكن أين تقع «كتابة اليوميات» من طبقات السرد؟ يجيب سعد محمد رحيم موضحاً «توفّر كتابة اليوميات مادة أرشيفية غنية للدارسين في حقول معرفية متعددة مثل التاريخ وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا، لأنها تلقي نظرة فاحصة على صورة الحدث الشخصي الجاري على خلفية الحدث التاريخي العام». ويستعرض يوميات بعض الكتّاب مثل تولستوي، وفرجينيا وولف، وجان جينيه، وكافكا، وأنانيس نن، وجورج أورويل، فيما تندر كتابة اليوميات لدى الكتّاب العرب لأسباب تتعلّق بصعوبة النظر إلى مرآة الذات. وفي حال تورّط بعضهم، إلا أن يومياتهم ستبقى في الأدراج، وربما ستتعرّض للتلف بعد رحيلهم. يقول صاحب «مقتل بائع الكتب» مختتماً «أظن أن اختراع اللغة كان في الأساس بسبب الحاجة إلى السرد، لذلك نتملّص من التاريخين لائذين بفنون السرد وأشكاله. غير أن التاريخ يعود متسللاً عبر مسامات تلك الفنون ليسكنها، وبإصرارنا على الإيغال في الممارسة السردية نثبت أننا كائنات تاريخية، لكنها دائمة التشكيك بتاريخها المدوّن».