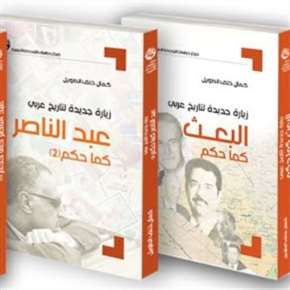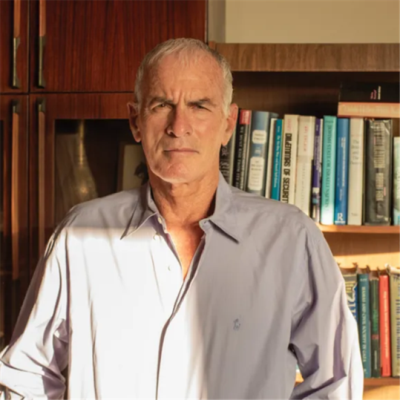أذكر نقاشاً جرى قبل زمنٍ حول الصواريخ الإيرانية وفعاليتها في حضور إبراهيم الأمين. كان ذلك عام 2007 أو 2008، حين كانت طبول الحرب تقرع في أميركا ضدّ إيران، والناس يتراهنون حول موعد الحرب (عودوا الى الأرشيف لتروا كمّ المنشورات التي كانت تتساءل إن كانت الحرب ستحصل في الخريف أو في الصيف). كان نجم الترسانة الصاروخية الإيرانية يومها هو «شهاب - 3»، الصاروخ الإيراني الأوّل القادر على أن يطاول إسرائيل. حصل هذا اللقاء قبل سنواتٍ على أن يبتسم لي الدّهر وأجد نفسي في «الأخبار»، وكان رأيي يومها، على عكس الحاضرين، أنّ الترسانة الصاروخية لا تشكّل عامل ردعٍ جدّي لمصلحة ايران، على عكس إغلاق هرمز مثلاً (وهو احتمالٌ أكثر واقعية)، أو تخريب منشآت النفط في الخليج.
كانت ذكرى الصواريخ العراقية لا تزال في الخلفية يومها (على رغم فشل «الباتريوت» وعدم اعتراض أكثر الصواريخ)، ومعها الدعاية الأميركية التي ظلّت تؤكّد، حتى سنوات قليلة ماضية، أن إيران لا تمتلك إلا عدداً محدوداً من المنصّات وصواريخ عديمة الدقّة. نحن نتكلّم وقتها على أسلحة هي عبارة عن تطوير، أساسه كوريّ، لصاروخ «سكود» القديم إيّاه، وأعدادها ليست كبيرة (بالمئات القليلة ربّما)، والأهمّ هو أنّ دقّتها قد لا تتميّز عن دقّة «الحسين» العراقي. سترمي صواريخك وتستنفد أكثر ترسانتك، وتحقّق تأثيراً قليلاً، ولكنك تكون قد لعبت ورقتك ولم يعد لديك غيرها تصعّد به. والعدوّ، بالمقابل، قادرٌ على وصل الغارات ضدّك بعضها ببعض. استخدمنا وقتها مثالاً للتدليل على مستوى الفعالية التي يمكن توخّيها، لو أنّك استهدفت ضرب مبنى الصحيفة في بيروت (لا أدري لماذا اختاروا هذا المثال) فأين قد يسقط الصاروخ؟ في الوسط التجاري. أنا أصرّ اليوم على أنّي لم أكن مخطئاً وقتها، فالأمور - من ناحيةٍ - قد تغيّرت بشكلٍ جذري منذ تلك الأيام، كما أنّني لو أخطأت فلن أعترف بذلك لرئيس التحرير تحديداً.
على فكرة، حين حصل الهجوم الصاروخي الإيراني ضدّ إسرائيل، كنت في طهران زائراً، وكنت حاضراً في أصفهان يوم «الردّ» الإسرائيلي (هي كانت مصادفة بالكامل، لم أستهدف أحداً ولا أحد استهدفني؛ ولكنه حظّي الذي أعرفه منذ صغري، والّذي يصرّ على أن يجعلني أعيش «أوقاتاً مثيرة»، وأنا لا أريد). المهمّ، نصيحتي لكلّ من يقدر هي بزيارة إيران، سوف تختبرون أموراً في شيراز وأصفهان وغيرهما تختلف بالكامل في التوصيفات والصور عن التجربة المباشرة. وأنصح بفعل ذلك قبل أن تنفتح إيران مجدّداً على السياحة (أو يكتشف أحدٌ في الخطوط الجوية الإيرانية السعر العالمي للوقود). هل تعرفون، مثلاً، أن الساحة التاريخية الفريدة في قلب أصفهان، نقش جيهان، والجوامع والقصور والبازارات التي ترصفها هي من تصميم مهندسٍ لبنانيّ الأصل، هو بهاء الدين العاملي. وقد كان من بين العلماء والبيروقراطيين والطلّاب الذين قدموا من لبنان في القرن السادس عشر وساهموا في تأسيس وإدارة الدولة الصفويّة (مع أنّ اسمه «العاملي» الّا أنّه حقيقةً من بعلبك في البقاع، ولكنّي أخبرتهم هناك أنّه من قريتي).
هناك، بالمناسبة، كتابُ يجب أن يكتب عن اختلاقات الجيل الأول من العرب في المهجر البعيد، جيل جبران ومن سبقه مثلاً، والروايات التي صاغوها عن أنفسهم هناك. هذه ظاهرة أميركية عامّة، وبخاصّة في الأيام التي سبقت وسائل التواصل الحديثة والسّفر السهل. حين كنت تجد نفسك في مكانٍ جديد وسط أناسٍ لا يعرفون عنك شيئاً ولا يمكنهم التحقق من ماضيك. كانت هذه الوضعيّة تمثّل فرصةً لا تقاوم لاختلاق نفسك من جديد، وأن تبني أيّ روايةٍ تريدها عن عالمك الذي جئت منه، ولماذا التواضع بين أناسٍ لا يعرفون؟ لهذا السبب، أنت لا تقدر على أن تثق برواية أيّ أميركي عن أجداده وقصة عائلته في «البلد القديم»، سواء ملاحم العزّ أو تلك عن القهر والكفاح (فأغلبها قد تمّ اختلاقه لاحقاً على البرّ الأميركي). جبران خليل جبران، على ما يبدو، كان يقول للنساء في نيويورك إنّه ابن أمير سوريا، وإنّه قرأ الفلسفة الألمانية في صغره (أي وهو ولدٌ في بشرّي)؛ ونحن لا نعرف هذه الأخبار عنه إلّا لأنّه كان هناك حوله لبناني آخر حسود، اسمه ميخائيل نعيمة، هو الذي نقلها إلينا.
في جوف الجبل
قبل سنوات، عُقدت «لعبة حرب» شبه - أكاديمية، كان الهدف منها تخيّل هجومٍ غربيٍّ جوّيٍّ كبيرٍ ضدّ إيران، وماذا يمكن للإيرانيين فعله في مواجهته. سؤال السيناريو كان بسيطاً: لو تخيّلنا أنّ الأميركيين قد شنّوا ضد إيران الحرب الجوية ذاتها التي استخدموها ضدّ العراق عام 1991، بالطريقة نفسها والتدرّج ذاته في المراحل، وافترضنا أن لا شيء جذرياً قد تغيّر في التكتيكات ولا تكنولوجيا سريّة لا نعرف بها. حتى وإن كنت تعرف مسبقاً كلّ هذه الأمور، فكيف يمكن لإيران أن تدافع عن نفسها؟ الجواب هنا كان: «بصعوبة». الموضوع له العديد من العناصر لن نناقشها، ولكن سنستخدم حصراً مثال الصواريخ والترسانة اللازمة: شرطٌ أساسي في أحد السيناريوات كان إخراج كلّ المطارات العسكرية الأميركية التي تحيط بالبلد من الخدمة ومنع استخدامها بالكامل، وهذا يعني اختراق دفاعات خمسة الى سبع قواعد جوية على الأقلّ وتحقيق مستوى أذىً لا يمكن إصلاحه - وكانت أميركا يومها لا تزال في أفغانستان. هذا الهدف وحده قد يستلزم آلاف الصّواريخ. فوق ذلك، فإنّه يجب أن يتحقّق خلال أيّامٍ معدودة، أسبوع أو أقلّ، فيستوجب إذاً كثافةً في إطلاق الصواريخ البالستية التي لم يكن لها مثالٌ في التاريخ. وهذا كلّه، بالمناسبة، لا يعني أنّك قد انتصرت في الحرب أو أوقفتها، بل إنّه قد أصبحت لديك فرصة. في مواجهةٍ من هذا النمط ضدّ قوة أو تحالفٍ غربيّ، فإنّ الوسيلة الأفعل والأسلم للتقليل من كثافة الغارات ضدّك لا تتمثّل في إسقاط الكثير من طائرات الخصم فوق أراضيك (فوتيرة الاستنزاف في دفاعاتك الجوية ستكون غالباً أعلى من معدّل استنزاف أسرابه)، بل في أن تشاغله و»تدفعه» بعيداً عنك قدر الإمكان، ألف كيلومترٍ أو أكثر. والهدف هو أن تزيد من عبء العمل والصيانة والمرافقة لكلّ غارة، وهنا السقف الحقيقي لوتيرة عمل سلاح الجوّ، وتجبر الطائرة العدوّة على التزوّد بالوقود مرةً واثنتين على الطريق، وأن تصل الى حدودك وهي لا تمتلك هامشاً للتحليق والمناورة.
حول شيراز أو نطنز ترتفع الجبال الصخرية الغنية بالحديد فجأةً - مثل ثنايا القماش - لمئات الأمتار عمودياً، وبينها وديانٌ عميقة ضيّقةٌ وعرة، عندها، تفهم لماذا عجّت تاريخياً بالحصون ومراكز التمرّد، ولماذا هي اليوم كهوفٌ مثالية لـ«مدن الصواريخ»
بعد كلّ هذا، فإنّ على إيران أن تحتفظ بمخزون آخرٍ من الصواريخ المختلفة، تضرب بها المعسكرات والمصالح الأميركية في الإقليم بشكلٍ يضغط عليها ويوجعها الى درجة وقف الحرب. حتّى نفهم الترسانة الصاروخية في إيران، علينا أن نفهم الحاجات والوظائف والضرورات التي بنيت من أجلها. قال الإيرانيون أخيراً إنّهم لم يستخدموا الأجيال الجديدة من أسلحتهم في هجوم نيسان. والأدلّة تظهر بالفعل أنّ ما تمّ إطلاقه على إسرائيل بالستياً كان أساساً من أنماط «عماد» و»قدر»، وهي دقيقة لكنها «قديمة» نسبياً ورخيصة، تمثّل فعلياً تطويرات لـ»شهاب - 3» الشهير، فيما لم نرَ أنظمة أخرى، جديدة، تأخذ مساراتٍ معقّدة لاختراق الدفاعات الحديثة، أو صواريخ أكبر حجماً وشديدة التأثير مثل «خورمشهر».
خلف هذه العائلات المتعدّدة من الصواريخ والوسائط، وسبب الخلط والمزج بينها، أسبابٌ عمليّة. صاروخ الوقود الصّلب، مثلاً، له في الظاهر مزايا عديدة (حجمه أصغر، لا يحتاج الى تحضير، يمكنك أن تخزّنه في أنبوبٍ معدني لسنواتٍ ثم تطلقه خلال دقائق، الخ)، ولكن إيران تحتفظ مع ذلك بترسانة كبيرة من صواريخ الوقود السائل، ويتمّ تطويرها باستمرار، ولم تستبدل بل تتوسّع. الفكرة هي أنّ إيران، نظراً إلى ظروفها وحاجاتها وطبيعة خصومها، تحتاج الى «كلّ شيءٍ» في الوقت ذاته. الوقود الصّلب، على سبيل المثال، لديه مشكلة «تاريخ صلاحية»، بمعنى أنك تحتاج - كلّ 10 أو 15 أو عشرين عاماً - الى رمي الصواريخ وإتلافها أو إجراء صيانة جذرية عليها. وهذا يحدّ من حجم الترسانة التي يمكنك أن تخزّنها ويرتّب عليها كلفةً استبدالٍ كبيرة تتضخّم مع ارتفاع العدد. أمّا صاروخ الوقود السائل فهو، إضافة الى كونه سهل التصنيع ورخيص، ففي الوسع إنتاج الآلاف من أبدانه وتخزينها، ثم إخراجها من غطاء البلاستيك الواقي حين تحتاج إليه، ولو بعد خمسين سنة، فتركّب عليه رأساً حربياً وتملأه بالوقود وتطلقه.
«مدن الصواريخ» في إيران، وقواعدها التي حُفرت في قلب الجبال، هي أساساً مراتع لصواريخ الوقود السائل، والهدف منها هو لتخزين أعدادٍ كبيرة من الصواريخ، والسماح بتحضيرها بشكلٍ آمنٍ داخل الملاجئ وإطلاقها بكثافةٍ كبيرة وقت الحرب. بعض هذه المراكز يحوي ما يشبه «خطّ الإنتاج» حرفياً: صواريخ تنصب على عربات، فوق سكّةٍ ممدودة في قلب الأرض، يصل الواحد منها الى موقع الإطلاق تحت فوّهة، ثمّ يحلّ مكانه آخر بعد ثوانٍ. أنت لا تحتاج الى مثل هذه البنى التحتية المعقّدة - والمكلفة - لإطلاق الصواريخ الجوّالة، مثلاً، أو المسيّرات والصواريخ الخفيفة. وهذه الأمور ليست ذات نفعٍ لترسانة هدفها الرّدع النووي، مثلاً، بل هي ضرورية فقط لمن يريد أن يجعل من الصواريخ بديلاً أصيلاً من سلاح جوٍّ يفتقر إليه. هنا تساعد الطوبوغرافيا والطبيعة أيضاً: كثيراً ما يتمّ تشبيه الجغرافيا الإيرانية بـ»وعاء السلطة»، بمعنى أن البلاد مزنّرة بجبالٍ عالية على كلّ أطرافها تحضن القلب الصحراوي. وحين تشاهد (حول شيراز أو نطنز) كيف ترتفع الجبال الصخرية الغنية بالحديد فجأةً - مثل ثنايا القماش - لمئات الأمتار عمودياً، وبينها وديانٌ عميقة ضيّقةٌ وعرة، تفهم لماذا عجّت هذه المرتفعات تاريخياً بالحصون والعقائد ومراكز التمرّد، ولماذا هي اليوم كهوفٌ مثالية لـ»مدن الصواريخ».
قد لا نعرف لسنواتٍ تمام ما حصل ليلة 13 - 14 نيسان الحالي، والأمر نفسه ينطبق على «الردّ» الإسرائيلي بعدها بأسبوع. ولكن ما نعرفه بالتأكيد يتلخّص في عاملَين اثنين: أوّلاً، أنّ الحرب بين إيران وإسرائيل، وهي قائمة منذ سنوات، أخذت شكل الضربات المباشرة بينهما للمرّة الأولى. والحقيقة الثانية هي أنّ ثمانية صواريخ على الأقلّ اخترقت كلّ المنظومات الدفاعية حول إسرائيل ونزلت على أهدافها داخل الكيان، وهي لم تسقط في البحر أو في مناطق عشوائية، ولم يؤثّر على توجيهها - حتى اللحظة الأخيرة - التضليل والتشويش (وهو قد يكون عقبةً أكبر من الاعتراض). هذه هي الوقائع التي نعرفها والتي تهمّ، وليس البهلوانيات الكلامية التي أحاطت بالحدث على الضفّة العربية، وتحليلات تنتقل بسلاسة، خلال أيّام، من «لن يردّوا على إسرائيل» الى «سيردّون ولكنه سيكون ردّاً رمزياً» إلى «لم يكن ردّاً رمزياً ولكنه لا يتعلّق بغزّة» (والأخيرة هي الأكثر طرافة، بالطبع، كأن تقول إنه لا علاقة لإنزال النورماندي ضدّ ألمانيا بالحرب على الجبهة الشرقية - ولماذا تقوم إسرائيل أصلاً باغتيال قادةٍ لإيران وشنّ الحرب عليها؟).
حربٌ من جانب واحد
كان واضحاً، بعد 7 أكتوبر بقليل، أننا لسنا في «جولة حربٍ» أخرى، بل أصبحنا في حالة مختلفة بالمعنى «الوجودي»، وهي تحتاج الى تفكيرٍ لكي نستوعبها، وليس لأن نحيطها بالشعارات. بعد حرب الإبادة في غزّة، خرجت القضية الفلسطينية من حظيرة «الرعاية الدولية» ومنظومة أوسلو، ولن تكون العودة إليها إلا ترجمة للإخضاع العسكري للثورة الفلسطينية. أنا لا أؤمن كثيراً بنظريّة «الفضح»، وأنّ حرب غزة قد «كشفت» أخيراً «عورة» النظام العربي و»نفاق» النظام الدولي، الخ. هذه الاصطفافات والمصالح كانت موجودةً وواضحة قبل الحرب وهي مستمرّةٌ، كل ما في الأمر أن الخيارات أصبحت أكثر حدّة وأثمانها جسيمة. من هنا، هذه المرحلة لا يناسبها الكلام القديم، وهي ليست للمزايدة والشعارات والخطاب الاستنهاضي، نحن لسنا في ثورة ملوّنة. هذا هو الوقت الذي يحتاج الى كلامٍ - حقيقيٍّ - في السياسة، والتمييز الواضح بين الصديق والعدوّ، وفهم الواقع الذي يحيط بنا من غير رغباتٍ وذاتيّة. وهذا ليس لكيّ تغيّر بالضرورة موقعك في شبكة الانتماءات والمصالح، ولكن لكي تفهمه على الأقلّ. وإن كانت مثل هذه الأوقات لم تدفعك الى النزول، ولو فكرياً، الى حقل السياسة والتزامات الواقع كما هو، فمتى ستفعل؟
العديد من العرب، نخباً وقيادات، يتحدّثون عن أهمية التحرير، ولكن يبدو كأنهم لا يفهمون المعنى الحقيقي لمثل هذه المواجهة، وحجم القوى الدولية والمحلية التي سوف تصطفّ ضدّك، أو هم حين يفهمون الكلفة يكتشفون أنهم لا يريدون التحرير حقّاً
خذوا دور قطر على سبيل المثال، مغزى الدور القطري و»خطورته» في فلسطين والمنطقة ينبع من عناصر «بنيويّة» وتاريخيّة شكّلته، وليس من مصالح وقراراتٍ لحظية أو من شخصية الحاكم. المسألة هي ليست أنّ قطر جزءٌ تاريخي من المنظومة الأميركية للأمن والطاقة، فهذا حال الإمارات والسعودية وغيرهما. المسألة هي أنّ قطر قد مرّت، منذ ثلاثين عاماً، بفترةٍ عصيبة - أزمة شرعية وانقلاب وتهديد خارجيّ حقيقي - هي التي صنعت السياسة الخارجية القطرية، وأفهمت النظام أنّه، حتى يصبح مفيداً وضرورياً لواشنطن، فهو يحتاج الى فعل «ما هو أكثر»، أن يتميّز عن باقي الحلفاء في الإقليم، وأن يكون له دورٌ خاصّ لا يؤدّيه غيره (وهكذا سيكون لأميركا سببٌ، حين يُطرح السؤال، لكي تمانع تغيير النظام في قطر أو أن تضمّها السعودية). كلّ السياسات القطرية مذّاك، من قاعدة «العديد» الى العلاقات مع إسرائيل الى استضافة «حماس» والتقارب مع سوريا، ثمّ شنّ الحرب عليها، هذه كلّها تأتي ضمن هذا الإطار. وإن كنت لا تفسّر السياسات القطرية ضمن سياقها التاريخي والوظيفي الفعلي، فأنت لست سوى ضحية أخرى من ضحايا قناة «الجزيرة».
المثير هنا هو أنّ المسؤولين القطريين أنفسهم لا يخفون البتّة هذه الأمور، وهم يشهرونها عند كلّ مفصل وانتقادٍ خارجيّ يطاولهم، وآخرها بيان رسمي للسفارة القطرية في واشنطن: «نحن لا نتصرّف من رؤوسنا، نحن لم نستضف قيادة «حماس» إلا تلبيةً لطلبٍ أميركي، وليس مجرّد موافقة منهم، ومثلها العلاقات مع «طالبان»، وحرب سوريا، كما أنّ تحويل الأموال الى غزّة كان يجري بموافقة إسرائيلية وتحت أعينهم - نحن نؤدي المهام لكم». هذا الكلام يقولونه للجمهور الأميركي والغربي حصراً وأنت كعربي، حين تسائل السياسة القطريّة ودورها، قد لا تجد في النقاش أمامك مواطناً قطرياً واحداً. ولماذا في رأيكم، وضمن أيّ نظريّةٍ عن العالم، قد تطلب أميركا من قطر استضافة «حماس» أو إقامة علاقاتٍ مع «حزب الله»؟ لتعزيز الكفاح المسلّح ضدّ الصهيونية؟ أم هي نظرية «الوساطة» المضحكة التي تنتشر في الإعلام العربي، كأنّ هناك في العلاقات الدولية من يمارس دور «الخطّابة»، همّه أن يقرّب بين النّاس بالحلال؟
يكرّر أحد الأصدقاء باستمرار أنّ العديد من العرب (والفلسطينيين ضمناً)، نخباً وقيادات، يتحدّثون دوماً عن التحرير ولكن يبدو كأنهم لا يفهمون المعنى الحقيقي لمثل هذه المواجهة، وحجم القوى الدولية والمحلية التي سوف تصطفّ ضدّك، أو هم حين يفهمون الكلفة يكتشفون أنهم لا يريدون التحرير حقّاً. نريد أن نحرّر فلسطين، وفي الوقت نفسه أن يعمل ولدنا في الإمارات ويزدهر. كأن التحرير، أو فرض أيّ شيءٍ على الصهيونية وخلفها أميركا، سيحصل «سرقة» وبالمناورة أو في وقت الفراغ، وأنّ الإسرائيليين ينتظرون الإشارة لكي يغادروا جماعياً من «بن غوريون». أسرّ لي مرّة مثقّف «كبير» برؤيته ونظريته عن مستقبل الأرض المحتلّة. تبيّن، باختصار، أنه ليس علينا فعل أيّ شيء، فهناك «ثورة شعبية» يراها قادمة في فلسطين لا محالة وهي سوف تكنس، بشكلٍ ما، الاحتلال والسّلطة في آن. أقسم لكم، هذه كانت الخطّة. ثمّ أضاف أن الجيش الإسرائيلي أصبح أصلاً جيشاً عاجزاً وفاسداً لا يقوى على خوض الحرب، وجنوده امّعات لم تعد لهم علاقة بالعسكرية والقتال (والدليل أنهم يدخّنون الحشيش).
السؤال الحقيقي هنا، هو ليس عن موقفك الكلامي من إسرائيل والصهيونية، بل من الأنظمة التي تحيط بها وتحميها وتشارك في حروبها، هنا المقياس الحقيقي لـ»الجذرية» وبداية طريق المواجهة. على العكس من ذلك، يتمّ تدريجياً، في الإعلام العربي السائد، تصوير الحرب الإبادية (الأميركية – الإسرائيلية - العربية) ضدّ الفلسطينيين كأنها من فعل إسرائيل وحدها، ثمّ تصبح «خيار اليمين الصهيوني المتطرّف»، قبل أن تتحوّل الى «حرب نتنياهو». الى أين، أصلاً، كانت المقاومة في غزّة ذاهبةٌ قبل أكتوبر ضمن هذه الشروط؟ لا يسعهم المراهنة على «كسب الوقت» أو انتظار تحريرٍ يأتي قريباً من الخارج، والحصار يطبق عليهم، والناس يدفعون الثمن يومياً، فيما نرى إسرائيل وقد أصبحت عنصراً قائداً في «النظام العربي». لم يعد لدى المؤسسة الصهيونية أيّ سببٍ ودافع لإعطاء شيءٍ للفلسطينيين: هي تقدر على هزيمتهم منفردين، والعرب يتسابقون على العلاقات معها على أيّ حال. وأيّ سبيلٍ ممكنٌ الى الأمام، وأيّ فرصةٍ تملك المقاومة، طالما أن هذا النظام العربيّ من حولها مستقرُّ كما هو؟
لم يعد للتعابير المألوفة، من نمط «التخاذل العربي» و»الانبطاح» وغيرها، معنى سياسي حقيقي، هي كليشيهات يستخدمها الوزراء العرب أنفسهم في اجتماعاتهم وقممهم. الكلام السياسي، مثلاً، هو أن يفهم من شارك في الحرب على غزّة أنّ للأمر مفاعيل عمليّة وطويلة الأمد، وأنهم يتحمّلون، أنظمة وسلالات، المسؤولية السياسيّة والشخصية عن الدماء التي سقطت، وليسوا مجرّد «متخاذلين». هذا الخطاب لا تسمعه اليوم في أيّ مكان، ومن دونه تكون حرباً من جانبٍ واحد لا يمكن أن تنتصر فيها. يقاتلك ولا تقاتله. منذ اللحظات الأولى للحرب كان هناك من يحضّر بوضوحٍ لـ»ما بعد الهزيمة»، ويمدّ للفلسطينيين مسبقاً جسور التنازل والتسليم، وكان هناك، على الجانب الآخر، من يشاركهم الحرب ويخطّط معهم للانتقام. أمّا النّظرة الرومانسية الى فلسطين كأنّها «أقنوم» قائم بذاته، وقضية منفصلة عمّا حولها، فهي ليست إلا إعادة تدويرٍ للعرفاتية التي نعرف جيّداً مآلاتها. إن كانت فلسطين بذاتها ولذاتها هي المركز والمنتهى، فالأمر محسوم سلفاً، إذ إنّ الصهيونية ستنتصر عليهم بسهولة. لا تقوم قضية فلسطين في السياسة إلّا حين تصبح شيئاً أكبر، وتلتحم بقضيّة أوسع وهويّة كبرى تحميها. لا أحد يقاتل ويضحّي ويصمد في مواجهاتٍ طويلةٍ وبهذا الحجم تلبيةً لـ»واجبٍ» تجاه «آخرين»، أو انجراراً حماسيّاً وراء خطبة، بل يجب أن يرى، بوضوحٍ، أنّ نفسه وعالمه ومستقبله ورهاناته هي أيضاً كلّها في فلسطين وفي الصّراع عليها.
حصل خطأٌ الأسبوع الماضي عندما وضع اسم الزميل عامر محسن على مقالة كتبها أحمد رجب، فوجب التوضيح.